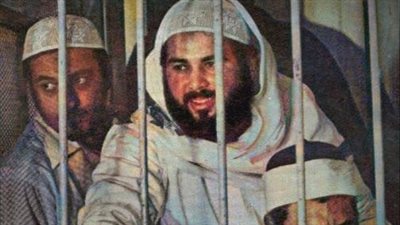المشاغب الأبدى.. أمينة النقاش تكشف أوراقًا خاصة من قصة رفيق رحلتها صلاح عيسى

- انفصال الثنائيات الفنية الناجحة من الظواهر الشائعة فى تاريخ الفن العربى
- إحسان عبدالقدوس واحد من الكتاب الذين ساهموا فى صياغة الوجدان العربى
- فاتن ظهرت لأول مرة على الشاشة عام 1940 مع محمد عبدالوهاب فى فيلم «يوم سعيد»
- سيناريو فيلم المهاجر عرض على الأزهر الشريف
سيظل الكاتب والمؤرخ الكبير الراحل صلاح عيسى نبعًا لا ينضب، بما تركه من إرث فكرى وصحفى وثقافى، وبما حمله من مواقف وطنية وإنسانية جعلت منه أحد أبرز الأصوات التى وثّقت تاريخ مصر الحديث وناقشت قضاياها بجرأة ووعى.
وتكشف الكاتبة الكبيرة أمينة النقاش، رفيقة حياة الراحل، عن وثائق نادرة تخص رحلة صلاح عيسى وحياته، لتضىء جوانب جديدة من مسيرته، وتعيد تقديمه للأجيال القادمة، ليس فقط ككاتب ومؤرخ، بل كإنسان عاش من أجل الكلمة والموقف.
وفى السطور التالية، تنشر «حرف» هذه الوثائق التى تفتح نافذة على حياة صلاح عيسى، وتكشف عن تفاصيل لم تُروَ من قبل، لتبقى شاهدة على مسيرة قلم لا يزال حاضرًا رغم الغياب.
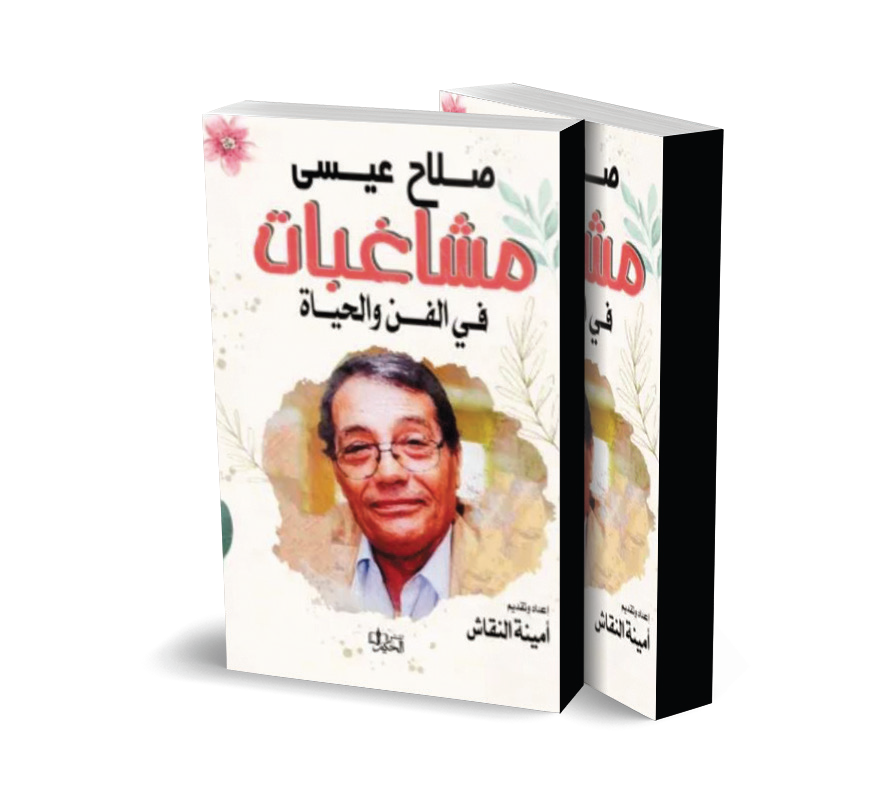
عادل إمام من مسابقة أحسن تسريحة إلى مهرجان أفضل طاجن كوسة
أخيرًا وبعد سنوات طويلة حصل عادل إمام على جائزة الممثل الأول عن عام ١٩٩٤ من المهرجان القومى الأول للسنيما المصرية عن الدور الذى قام به فى فيلم الإرهابى، لتكون أول جائزة يحصل عليها فى حياته الفنية، على الرغم من عشرات الأفلام التى قام بالتمثيل فيها أو قام ببطولتها على امتداد أكثر من ثلاثين عامًا.. وعشرات المهرجانات القطرية والقومية الأهلية والرسمية التى اشتركت فيها أفلامه، وعلى كثرة الذين حصلوا على جوائز فى تلك المهرجانات من الممثلين الذين ظهروا معه، أو جاءوا بعده، بل والذين قاموا بأدوار فى أفلام قام ببطولتها، وعلى الرغم من اعتراف الجميع بأنه ظاهرة فنية مذهلة فى جماهيريته الفذة، وحضوره الطاغى، وتأثيره الذى لا حدود له.. والغريب أن هذه الجماهيرية الفذة كانت السبب الذى حال بين عادل إمام وبين الحصول على جائزة الممثل الأول، حتى فى المهرجانات التى اشترك فيها بأفلام لا خلاف بين النقاد والمتفرجين على قيمتها الفنية العالية، فضلًا عن نجاحها الجماهيرى، مثل «اللعب مع الكبار و الإرهاب والكباب، والمنسى»، مع أن آخرين ممن اشتركوا معه بالتمثيل فيها قد حصلوا على جوائز، وكان المنطق الذى تأخذ به لجان التحكيم فى تلك المهرجانات هو أن عادل إمام أكبر من الجائزة، وأن جائزته الحقيقية هى حب الجماهير له، وإقبالهم على أفلامه.. وأن منحه الجائزة معناه أن يحصل عليها فى كل مهرجان يشترك فيه فيلم من أفلامه، وهو ما يسد باب الحصول عليها أمام ممثلين مجيدين أو صاعدين آخرين، لم يسعدهم زمانهم بتلك الجماهيرية النادرة التى حصل عليها عادل إمام!

وقد يبدو هذا الكلام فى ظاهره منطقيًا.. لكنه فى الواقع يعكس مشكلة مصداقية هذه الجوائز العربية الكثيرة التى تُمنح للشعراء والأدباء والعلماء والفنانين والكتاب، حتى لمربى الدواجن وصناع البسطرمة والكوافيرات وقارئى البخت والفنجان، وهى تختلف من حيث قيمتها المادية، من مجرد ورقة مكتوبة إلى ميدالية صفيحية أو برونزية، ومن تماثيل الفضة إلى تماثيل الذهب وآلاف الدولارات، وتختلف من حيث الجهة التى تمنحها الحكومات إلى الجمعيات الأهلية ومن شركات الإعلانات إلى الأثرياء من الأفراد الذين يخصصون جانبًا من ثرواتهم لتشجيع الفنون التى يحبونها أو يمارسونها أو لتخليد ذكراهم، فقد كثرت هذه الجوائز على نحو يأخذ أحيانًا طابعًا هزليًا سواء فى موضوع المسابقة، مثل جائزة أحسن طاجن كوسة، أو فى الجهة التى تنظمها، حتى إن جمعية سينمائية كحيانة تنظم مهرجانًا يمنح جائزة تسميها الأوسكار العربية، وزعتها هذا العام على كل الأفلام وكل الممثلين وكل الفنيين، وحصل عليها عادل إمام.
الشىء الوحيد الذى تتفق فيه هذه الجوائز هو شك الجميع فى موضوعيتها، وتعرض لجان التحكيم التى تختار الفائزين فيها، وتوزع عليهم الجوائز، للهجوم، بعد إعلان النتائج، وأحيانًا قبل إعلانها، والتشكك فى ذمتهم واتهامهم بأنهم باعوا الجائزة مقابل عشوة، أو رشوة، أو خضوعًا للإلحاح أو الزن والضغط، فى أحسن الأحوال لمجرد مجاملة أصدقائهم.. أو...
وصحيح أن لجان التحكيم تتكون من بشر يختلفون فى أخلاقهم وفى آرائهم وفى قدرتهم على أن يتخلصوا تمامًا من تأثير الضغوط الداخلية أو الخارجية التى تحيط بهم عند اتخاذهم قرارهم، ولكن من الصحيح- كذلك- أن هذه القرارات هى فى النهاية مسألة تقديرية محضة، تعتمد على محك أساسى هو ذوق أعضاء اللجنة، وهو أمر لا بد وأن يعترض عليه- جزئيًا أو كليًا- كل من يملكون ذوقًا مخالفًا، فضلًا عن المتسابقين الذين لم يحصلوا على الجوائز، والذين يعتقدون أنهم أحق بها من غيرهم.. لكن الأصح من ذلك هو أنه بالاستطاعة دائمًا التوصل إلى أكبر قدر ممكن من الموضوعية فى الحكم يستند إلى رؤية ثابتة تنظر إلى العمل الفنى من داخله، وتسعى لإقرار قيم فنية وجمالية صحيحة وتستبعد كل عامل خارجى لا صلة له بالعمل الفنى محل التقييم، فالأهداف العامة النبيلة ليست مبررًا لمنح فيلم ركيك فنيًا جائزة من مهرجان سينمائى محترم، والجماهيرية الساحقة لنجم من النجوم ليست مبررًا لعدم منحه الجائزة، بدعوى أن جائزته فى حب الجمهور كما قيل دائمًا تبريرًا لعدم منح عادل إمام جائزة الممثل الأول فى السنوات الماضية، بل قد يكون ذلك من بين الأسباب التى توجب منحها له وليس العكس.. فالجوائز ليست صدقة أو جبر خاطر، ولكنها إعلاء من شأن قيم فنية لن تستقر وتترسخ إلا من خلال قواعد موضوعية تمنح الجوائز على أساسها، فلا تستعيد فحسب مصداقيتها واحترامها، بل وتسهم فى مجموعها فى تأكيد تلك القواعد الموضوعية.
وقد كان عادل إمام على حق عندما أعلن عن أنه سيرفض أى جائزة يمنحها له مهرجان من ذلك النوع، ولن يقوم باستلامها إذا منحت له، بعد أن فات الأوان الذى كان يجب أن يأخذها فيه، إلى أن نجح الناقد رجاء النقاش- رئيس لجنة تحكيم المهرجان هذا العام- فى إقناعه بقبول الجائزة، وبالحضور لاستلامها، فصحح بذلك وضعًا خاطئًا استمر سنوات طويلة، كما صححت معظم قرارات اللجنة الصورة التى شاعت عن المهرجان، باعتباره مهرجانًا للمجاملات على الطريقة العربية التى تحتاج إلى جهد مماثل لكى تستعيد مصداقيتها واحترامها، ابتداء من مهرجان أحسن تسريحة شعر، وليس انتهاء بمهرجان أفضل طاجن كوسة!

عكاشة وعبدالحافظ.. حين يتحول السمن على عسل إلى زيت على بصل!
لأنه يستحيل أن يكون هناك دخان دون نار فلا بد أن هناك أساسًا للشائعات التى تتحدث عن وجود خلافات بين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ ربما تؤدى إلى عدم تعاونهما فى تقديم الجزء الخامس من مسلسل «ليالى الحلمية»، خاصة أن أحدًا من الطرفين لم يحرص حتى الآن على نفى تلك الشائعات المغرضة أو إصدار بيان من النوع الذى يصدره الزوجان عادة، قبل توقيع الطلاق بساعات. يؤكدان فيه أن العلاقات بينهما سمن على عسل وأنها لم تكن فى يوم من الأيام، أقوى مما هى عليه اليوم.

وبسبب هذا التكتم فإن أحدًا لا يعرف على وجه الدقة، الأسباب التى حولت العلاقة بين «دويتو» عبدالحافظ وعكاشة من سمن على عسل إلى زيت على بصل، وإن كانت وكالات أنباء النميمة تقول إن هذا الخلاف قد بدأ عندما تطوع عبدالحافظ لإنقاذ مسلسل العائلة من «شجاعة» عدد من مخرجى التليفزيون، وحين شرع فى التنفيذ كان عكاشة، قد انتهى من كتابة مسلسل «أرابيسك»، ولما كان مستحيلًا على عبدالحافظ أن يضيف اسمه إلى أسماء الخائفين من إخراج «العائلة». وكان مستحيلًا على عكاشة أن يؤجل تقديم «أرابيسك» فقد انتهى الأمر باختياره جمال عبدالحميد لإخراجه، وكانت تلك بداية تراكم الثلوج بين الطرفين، ثم ما لبثت بعض الصحف، أن عكرت هذا الصفو، حين نسبت إلى «عكاشة» آراء سلبية فى مسلسل العائلة تأليفًا وإخراجًا.
وانفصال الثنائيات الفنية الناجحة كانفصال الوحدات السياسية الفاشلة من الظواهر الشائعة فى تاريخ الفن العربى، وأسرع هذه الثنائيات انفصالًا هى التى تكون بين رجل وامرأة، إذ غالبًا ما تبدأ مع قصة حب، قد تتحول إلى زواج، وهو ما حدث فى ثنائيات مثل ليلى مراد وأنور وجدى، وفريد الأطرش وسامية جمال، ونعيمة عاكف وحسين فوزى، وفؤاد المهندس وشويكار، وفريد شوقى وهدى سلطان التى قدمت لنا عددًا من أفضل الأفلام والمسرحيات الاستعراضية والكوميدية والغنائية والأفلام الاجتماعية، إلى أن انطفأت نار الحب، واشتعلت نيران الخلافات الزوجية أو العاطفية أو المالية، فخمدت جذوة الفن، ووقع الطلاق فى البيت الفنى، ومضى كل إلى غايته على رأى أم كلثوم، التى كانت الخلافات المالية سببًا فى قطع حبل المودة بينها وبين ثلاثة ممن تعاون معها فى أفضل أغانيها وهم بيرم التونسى ورياض السنباطى وزكريا أحمد. وإذا كان فض الوحدة بين الثنائيات الفنية ليس قدرًا بدلیل استمرار التعاون بين نجيب الريحانى وبديع خيرى، وبين على الكسار وأمين صدقى، وبين إسماعيل ياسين وأبوالسعود الإبيارى- وهى جميعًا ثنائيات رجالية ما يدل على أن الصداقة بين الرجل والرجل أطول عمرًا من الحب بين الرجل والمرأة، وأكثر استمرارًا من الصداقة بين المرأة والمرأة - إلى أن فرق الموت بين كل منهما والآخر، فإن استمرار هذه الثنائيات قد لا يكون دائمًا مفيدًا، فكما أن الانسجام الفنى بين طرفيها قد ينتج أعمالًا باهرة، فقد يوقعهما كذلك فى التكرار، وقد يكون تعاون كل طرف من طرفيها مع أطراف أخرى داعيًا لتوهج موهبته، وفضلًا عن ذلك كله، فليس باستطاعة مخلوق، أن يتغلب على الأسافين الشريرة، أو المشاعر الدفينة، التى قد توسوس فى صدر أحد طرفى الدويتو، بأنه صاحب الفضل على الآخر، وأنه لا يساوى بدونه شيئًا، فتدفعه إلى فض الوحدة بينهما للبرهنة على صحة تلك الفكرة التافهة، ومع أننا نتمنى أن يكون كل ما يشاع عن جود خلافات بين «دويتو» عبدالحافظ وعكاشة هو مجرد دخان بلا نار إلا أننا لن نُدهش إذا كان دخان يتصاعد من نار، والمهم أن هذه النار لم تمس الجزء الخامس من «ليالى الحلمية»، إذ من حق المتفرجين، وهم طرف ثالث فى الموضوع، أن يشاهدوا هذا الجزء بنفس الرؤية الإخراجية التى شاهدوا بها أجزاءه السابقة.. فهل يتكرم الـ«دويتو» بإصدار بيان- من نوع الذى تصدره الجامعة العربية - يؤكدان فيه، أن الوحدة بينهما، لم تكن فى يوم من الأيام، أقوى مما هى عليه اليوم، أو على الأقل، يعلنان به أن انقلاب علاقتهما من سمن على عسل إلى زيت على بصل لن يؤثر على الجزء الأخير من ليالى الحلمية ؟!
مجرد سؤال.
جائزة الفخرانى

شىء جميل فعلًا أن يحصل الفنان يحيى الفخرانى على جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون لهذا العام، عن أدائه لدور سليم باشا البدرى فى المسلسل التليفزيونى الشهير ليالى الحلمية!
وشىء جميل جدًا أن اللجنة التى تمنح الجائزة، هى التى اختارت الفخرانى لها، واستثنته من الشرط الذى يقضى بأن يتقدم المرشح للحصول على الجائزة التشجيعية لطلبها بنفسه، وهو ما لم يفعله الفخرانى الذى فوجئ بحصوله على الجائزة.. كما فوجئ بذلك الجميع.
أما السبب فلأن حصول يحيى الفخرانى على إحدى جوائز الدولة، هو إعادة اعتبار للفن الجميل، وللقيم الأخلاقية الرفيعة، بعد أن ساد الاعتقاد بأن الشطارة والفهلوة والادعاء والإلحاح والسبل التحتية هى أقصر الطرق للحصول على مثل تلك الجوائز.
فضلًا عن ذلك فإن يحيى الفخرانى ممثل من النوع الذى لا يتكرر كثيرًا، فهو يختار أدواره بدقة وعناية وفهم، ويحرص- فى معظمها- على أن تكون الشخصية التى يؤديها مرسومة على الورق بشكل يتيح له أن يتفاعل معها، وأن يضيف إليها، وأن يبدع فى أدائها، على نحو جعل تاريخه الفنى يكاد يخلو من أى أدوار تافهة أو سطحية، فلم يضطر يومًا للاعتذار عن دور أداه، بأنه كان مضطرًا لقبوله من أجل أكل العيش، لأنه كان فى مرحلة الانتشار، أو غير ذلك مما يعتذر الآخرون عن سقطاتهم الفنية.
وحتى لو كانت عناصر الفيلم الأخرى كالسيناريو أو الإخراج أو عدم التوفيق فى اختيار الممثلين- يشوبها عيب، فإن الفخرانى قادر دائمًا على أن يضفى على أدائه لدوره الخبرة التى تجعله متميزًا فى ذاته، بصرف النظر عن قيمة الفيلم، حتى لو كانت الشخصية التى يؤديها نمطية من النوع الذى أداه قبله عشرات الممثلين كشخصية الشرير مثلًا- فإن الطريقة التى يتقمصها بها تظل لها خصوصيتها وتفردها عن أداء السابقين واللاحقين، وليس دور سليم البدرى فى ليالى الحلمية هو الدور الوحيد الذى أبدع الفخرانى فى أدائه، ففى تاريخه أدوار أخرى يستحيل أن يتخيل إنسان أن يقوم ممثل آخر بأدائها، أو أن يتصور أحد أنها كان يمكن أن تكون بتلك الدرجة من المصداقية والتأثير إذا لم يقدمها هو، ومن بينها أدواره فى أفلام «للحب قصة أخيرة» و«خرج ولم يعد» و«الغيرة القاتلة»، و«حكاية نصف مليون جنيه» و«عودة مواطن» و«الحب فى الثلاجة».
باختصار فإن حصول يحيى الفخرانى على جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون، هو جائزة للجائزة.. وذلك هو الجميل فعلًا جدًا.
أما الذى ليس جميلًا لا فعلًا ولا جدًا فهو أن جائزة الدولة التشجيعية- طبقًا للقانون- تُمنَح للمبتدئين الذين لا يزالون فى بداية الطريق، تشجيعًا لهم على تنمية مواهبهم ومواصلة التقدم فى مجالات إبداعهم، لذلك تمنح عن عمل واحد، بعكس جوائز الدولة التقديرية التى تمنح للراسخين ذوى التاريخ العريق تقديرًا لمجمل ما قاموا به على امتداد حياتهم الفنية.. فإذا كان الفخرانى لا يستحق- بعد أكثر من ٢٥ سنة من الإبداع الجميل- إلا هذه التشجيعية.. فمن الذى يستحق التقديرية ؟.. وإذا كان يستحق التشجيعية فما هى يا ترى الجائزة التى يستحقها ممثلون مثل محمد رياض ورياض الخولى اللذين لمعا فى مسلسل «العائلة» و«ميرنا» التى لمعت فى ذئاب الجبل؟!
سؤال نوجهه للعباقرة الذين منحوا الفخرانى جائزة لا تمنح إلا للمبتدئين، بعد أسابيع من حصوله على جائزة الممثل الأول من المهرجان القومى الرابع للأفلام الروائية، فبدوا أشبه بالذى يمنح شهادة الابتدائية لطالب حصل فى الأسبوع نفسه على شهادة الدكتوراه.

بطلة إحسان عبدالقدوس تقول: أنا مش حرة!

شعرت بانزعاج بالغ وأنا أتابع أنباء فضيحة اكتشاف وجود طبعة خاصة من رواية «أنا حرة»، للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، قد عبثت بها يد خفية فأضافت إليها بعض الكلمات، وحذفت منها بعض العبارات، ثم ختمتها بسطرين جاءا بمثابة اعتذار من الكاتب الراحل عما ورد بالرواية، وربما عن كل ما كتب طوال حياته، حدث ذلك لهدف تجارى محض هو محاولة الحصول على إذن بطرح خمسة آلاف نسخة منها فى إحدى الدول العربية، التى اعترضت الرقابة فيها على تداول الرواية فى أسواقها بصورتها الحالية.
إحسان عبدالقدوس واحد من الكتاب الذين ساهموا- بكتاباتهم السياسية والقصصية وبالمنهج الذى كان يدير به الصحف التى تولى رئاسة تحريرها- فى صياغة الوجدان العربى، خلال ما يقرب من نصف قرن، شغلته خلالها قضية الحرية على كل الأصعدة. من التحرر الوطنى إلى التحرر الاجتماعى، ومن الدفاع عن الحريات العامة إلى الدفاع عن الحريات الشخصية، ومن الدعوة إلى بناء وطن جديد إلى الدعوة إلى نسق أخلاقى جديد، ثم رحل فى ١٢ يناير ١٩٩٠م، وواجبنا تجاهه هو أن نحافظ على تراثه كما هو، ونتركه للأجيال القادمة كما تسلمناه منه، وإذا كان من حقنا- ومن حقهم- أن نفسره ونحلله ونختلف معه أو حتى نهاجمه، فليس من حقنا أن نفسره على أن يتبنى آراءنا، أو أن نمس سطرًا مما كتب أو نترك تراثه لمن يخلفنا على غير الصورة التى كتبها به، حتى لو كان الهدف من ذلك أخلاقيا ساميًا. فما بالك إذا كان الهدف من التشويه الذى لحق «أنا حرة»- وكتاب آخر للمؤلف نفسه هو «زوجات ضائعات»- تجاريًا محضًا، وإذا كان المقابل مجرد ثلاثين قطعة من الفضة.
والغريب أن الناشر الذى فعل ذلك يتعلل بأنه عرض الفكرة على الصديق «محمد عبدالقدوس»-الابن الأكبر للكاتب الراحل- فوافق على مبدأ التعديل، وهى رواية نفاها لى «عبدالقدوس» الابن، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يوافق على شىء من ذلك، حتى لو كان يختلف مع ما ورد فى الرواية، لأنه يعتقد أن البر بالوالدين على رأس الفضائل التى يحرص على التمسك بها، وأنا أصدقه. وحتى لو كان قد وافق فليس من حق الناشر أن يستجيب لطلبه، فما بالك وقد اعترف بأنه صاحب الفكرة، فهناك شىء اسمه أصول الصنعة، أو تقاليد المهنة، وهى تقضى بأن يصل الكتاب إلى القارئ كما كتبه صاحبه، دون زيادة أو نقصان، أو تحوير أو تبديل، خاليًا من أى خطأ مطبعى أو نحوى، ليس فقط لأن هذا هو حق المؤلف، ولكن لأنه أيضًا حق القارئ، ولو أن شيئًا من ذلك قد حدث على سبيل السهو والخطأ غير المقصود، وتكرر فى إصدارات ناشر بذاته، لفقد ثقة القراء، ولانصرفوا عن شراء ما ينشر من كتب مضروبة، أما حين يحدث مع سبق الإصرار والترصد فتلك جريمة تزوير وتزييف لتراث الأمة، ولذاكرتها الفكرية، لو تركناها تمر دون وقفة غضب فلن تمضى سنوات إلا ويكون التبديل والتشويه قد لحق ما كتبه كل أعلام الفكر العربى، من رفاعة الطهطاوى وفارس الشدياق إلى طه حسين ونجيب محفوظ.
ما يثير الانزعاج هو الإهدار المتواصل لتقاليد الصنعة وآداب المهنة فى كل مجال، ومن أجل هذه الثلاثين قطعة من الفضة ذاتها، حتى أصبح الإنسان الذى يتقن عمله، سواء كان ميكانيكيًا للسيارات أو سباكًا للحنفيات أو ناشرًا للكتب والمطبوعات، من العجائب التى يندر وجودها على خريطة أمتنا العربية الواحدة ذات الخيبة الخالدة، مع أن الحديث النبوى الشريف يقول: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»، ومع أن هذا الإتقان هو الذى أدى إلى ازدهار الحضارة العربية، و«الكلفتة» و «اللكلكة» هى التى أدت لانهيارها وتدهورها، وما يثير الأسى هو أن رئيس اتحاد الناشرين اعتبر نفسه غير مسئول عما حدث، وقال إن مهمة الاتحاد هى أن يحل الخلافات بين أعضائه وديًا، وهو كلام سخيف تعودنا أن نسمعه من كل النقابات المهنية فى الحالات المشابهة، مع أن هذه النقابات نشأت أساسًا للدفاع عن كرامة المهنة وتقاليدها، فإذا كانت عاجزة عن ذلك فلماذا لا تحمل عصاها على كاهلها وترحل؟!
أما الذى يثير العجب فهو أن اتِّباع أصل الصنعة ليس عسيرًا لهذا الحد، فإصدار طبعات ناقصة أو ملخصة من الكتب الأصلية تقليد متبع فى إصدارات دور النشر العالمية، بشرط التنبيه إلى ذلك احترامًا لحق المؤلف وحق القارئ، ولم يكن هناك ما يدعو للهجوم على الناشر، لو أنه كتب على غلاف الطبعة التى أصدرها من الرواية رواية «أنا مش حرة»- طبعة مهذبة ومضروبة بالفلقة بمعرفة العبد الفقير إلى الله تعالى وإلى صرة دولارات.
ظاهرة فاتن حمامة!
ما كادت صورة الطفلة فاتن حمامة تظهر على الشاشة الخلفية فى حفل افتتاح المهرجان القومى الأول للسينما المصرية «١٩٩٥»، حتى دَوَّت القاعة بتصفيق حاد ومتواصل امتدَّ لدقائق، وظل يصحب سيدة الشاشة العربية منذ خطت بقدميا إلى خشبة المسرح، إلى أن غادرته بعد أن تسلمت شهادة التقدير، باعتبارها على رأس الرواد الذى قرر المهرجان تكريمهم هذا العام.

وكنتُ طوال هذا الوقت أحاول أن أبحث عن مبرر لهذا الحب الدافق الذى أحاط بهذه الطفلة البريئة، منذ ظهرت لأول مرة على الشاشة عام ١٩٤٠ مع محمد عبدالوهاب فى فيلم «يوم سعيد»، الذى ظل ثابتًا لمدة تزيد على نصف قرن، تغيَّرت فيها الدنيا، واختفى نموذج البنت الغلبانة مكسورة الجناح الذى مثَّلته فى عشرات الأفلام، ليحل محله نموذج المرأة التى تأكل ذراع زوجها بعد أن تمزق جسده بالساطور، وتغيَّرت السينما، وتغيَّر مزاج الذين يشاهدونها، أما الذى لم يتبدل، فهو ذلك المكان العزيز الذى تشغله فى قلوب أجيال تختلف فى كل شىء، إلا فى حبها.
وإذا كان من حق مؤرخى السينما ونقادها أن يختلفوا على القيمة الفنية لكثير من الأفلام التى مثلتها فاتن حمامة والتى تجاوزت المائة فيلم، فمن واجب المهتمين بالتاريخ الاجتماعى أن يتوقفوا عند ظاهرة جماهيريتها الأسطورية، حاضرة وغائبة، على امتداد كل تلك السنوات، وأن يربطوا بين ذلك وبين الدور الغالب على أدوارها، باعتبارها أشهر الطيبين فى تاريخ السينما العربية، وعندئذ يستطيعون- بضمير علمى مستريح- أن يحكموا بأنها قد عاشت فى وجدان أجيال من العرب رمزًا على ذلك الجانب الطيب من نفوسهم الذى يأبى أن ينهزم الخير مهما كان ضعيفًا أو هشًّا أو أعزل من كل سلاح، ويرفض أن يسود الشر مهما كان قويًّا ومدججًا بكل ظلام الدنيا.
وربما لذلك، ظلوا- على امتداد العقود الخمسة التالية- يتابعون فى شوق متجدد معركة فاتن حمامة المتواصلة ضده، وينحازون إليها من أول لقطة، وكأنهم يشاهدون فى كل فيلم- أو معركة- تنويعة على معركتهم الضارية ضد شرور الطبيعة وشرور المجتمع وشرور النفس. وحين يتكاثف الظلام فى صالة العرض، وعلى شاشته، ويتصاعد الشر إلى ذروة يبدو معها أن انتصاره النهائى بات وشيكًا، يحدث ذلك الذى يثق الناس- بإيمان يقترب من تجليات الصوفيين- أنه لا بد أن يحدث، والذى يراهنون عليه- صابرين وصامدين- وكأنه لحظة الكشف التى ينتظرها الدرويش السارح فى ملكوت الله. فَتُهزَمُ الخبائث والشرور فى الثانية الستين من الساعة الرابعة والعشرين، وتنتصر «فاتن حمامة»، وتضىء قلوبهم بالفرحة قبل أن تضىء الأنوار فى صالة العرض.
ومن جديد، يعودون، فيلمًا بعد فيلم، وجيلًا بعد آخر، يتابعون معركة هذه الفتاة النحيلة، الضئيلة القدر، الشاحبة الوجه، شحوب الحياة عند بزوغ الفجر، لا شحوب اختناقها قبل غياب الشمس، البريئة الملامح على نحو لا تستطيع أن تتخيلها إلا باعتبارها صورة أخرى من أمك أو أختك أو ابنتك، والتى تخلو فى تكوينها وسلوكها حتى ملابسها وزينتها من أى مظهر من مظاهر الابتذال أو الخشونة أو القسوة، والتى تنتصر دائمًا على شرور بعضها ساذج والآخر معقد، تحاصرها بين جدران بيتها، وتطاردها فى الشارع أو فى الكون، وتقيم حولها متاريس تسد أمامها كل سبيل للحياة فى هذه الدنيا، وتخييرها- دائمًا- بين الجوع أو الركوع. ورغم تجردها من أى سلاح، فهى ترفض أن تتراجع عن فطرتها الخيرة، رافعة أعلام البراءة فى وجه كل ما فى العالم من قاذورات، إيمانًا منها بأن الضعف الحقيقى ليس فى عجز القوة المادية، ولكنه فى الإرادة البشرية وعجز الضمير الإنسانى.
ذلك هو الدور الذى تقمصته فاتن حمامة باقتدار، دورٌ دعا دائمًا للانبهار، لم تعتمد فى تقمصه على موهبتها الفطرية المتألقة فحسب، بل سعت دائمًا لكى تجود فى أدائها له على نحو احتفظ للدور بمصداقيته وبتأثيره الطاغى على الناس، فاتخذوها رمزًا لذلك الجانب الطيب من نفوسهم. فكان طبيعيًّا أن يفرحوا بها حين رأوها أمامهم على خشبة المسرح، وأن يصفقوا بحرارة صادقة، تأييدًا لفكرة تكريم الخير الذى لا يزال يملأ قلوبهم حتى لو كانوا يمارسون عكسه.

يوسف شاهين.. الورد الذى لم يجدوا فيه عيبًا!
بدأت محكمة عابدين الجزئية يوم الثلاثاء الماضى، نظر الدعوى التى رفعها محام مصرى هو الأستاذ محمود أبوالفيض، ضد يوسف شاهين صاحب فیلم «المهاجر» وضد فضيلة شيخ الأزهر، ووزير الثقافة المصرية باعتبارهما هما اللذان صرحا بعرضه، مطالبًا بوقف عرض الفيلم والتحفظ على جميع نسخه، ووقف تصديره إلى خارج البلاد.
وليست هذه أول دعوى قضائية من نوعها يقيمها أحد السادة المحامين أو مجموعة منهم للمطالبة بوقف عرض فيلم سينمائى، أو مسلسل تليفزيونى، أو مسرحية، فقد سبق لآخرين غير الأستاذ أبوالفيض- أن أقاموا دعاوى مماثلة لوقف عرض فيلم «الأفوكاتو» ومسلسلى «فالكون كريست»، و«الجرىء والجميلات»، بل وأقام بعضهم دعوى لرفع أفيش أحد الأفلام من مدخل إحدى دور عرض الدرجة الثالثة.
ويستند المحامون الذين يقيمون هذه الدعاوى عادة إلى أسباب دينية وأخلاقية، وفى أحيان قليلة أخرى على أسباب فئوية- كما فى حالة فيلم الأفوكاتو الذى اتهم بالإساءة للمحامين- أو وطنية.. ومن حسن الحظ أن المحاكم قد درجت على رفض كل هذه الدعاوى ثقة منها فى أن السلطة القائمة على تطبيق قوانين الرقابة على المصنفات الفنية تحسن فهم وتطبيق تلك القوانين، بحكم تخصصها فى ذلك، وبأن صدور حكم بالمصادرة اعتمادًا على فهم أى مواطن أو تفسيره الشخصى للعمل الفنى ودرجة إدراكه لمراميه، يشل أيدى تلك السلطة عن القيام بواجبها.
ومع أن سيناريو فيلم المهاجر قد عرض على الأزهر الشريف، ووافق عليه، إلا أن الأستاذ أبوالفيض، يطعن على هذه الموافقة، ويرى أن الفيلم يُعَرِّضُ بالنبى يوسف عليه السلام وينسب إليه أنه كان يشتهى- فى خياله- امرأة العزيز، بل ويسىء كذلك إلى التاريخ الفرعونى، ويظهر ملوك وحكام مصر- فى تلك الفترة بل وشعبها فى صورة الشخصيات الضعيفة البلهاء التى تفتقر إلى العلم والقدرة.
ويبدو أن الأستاذ أبوالفيض قد وقع ضحية لبعض الكتابات الصحفية غير الدقيقة التى أدمن أصحابها التحامل على يوسف شاهين، ولما كانوا لا يستطيعون التشكيك فى مواهبه الفنية، فإنهم يهربون إلى التشكيك فى مضامين أفلامه، فلم يجدوا ما يهاجمون به المهاجر سوى الإصرار على أنه يروى قصة النبى يوسف رغم الإشارة الصريحة فى مقدمته بأن المشابهة بينه وبين أى أحداث تاريخية ليست مقصودة، والخلاف بين النص العربى لتلك الإشارة وترجمته الفرنسية ليس اعترافًا بتلك التهمة، بل هو تأكيد بأن الفيلم يروى قصة إنسان اسمه «رام»، بل واندفع بعضهم وراء ذلك الافتراض فقالوا بأن الفرعون الذى كان معاصرًا للنبى يوسف ليس إخناتون، كما ورد فى الفيلم، وبدلًا من أن يعتبروا ذلك دليلًا على بطلان افتراضهم، أضافوا تهمة الجهل بالتاريخ إلى الاتهامات الموجهة إلى يوسف شاهين.
صحيح ما لقوش فى الورد عيب.. قالوا ده أحمر الخدين.

نجمة الجماهير تكتب التاريخ على واحدة ونصف!
لأن الصفات معفاة من الرسوم الجمركية، ومن ضريبة المبيعات، فمن حق نادية الجندى أن تصف نفسها بأنها نجمة الجماهير، خاصة أن هذه الجماهير لا تعترض عادة على أحد ممن ينسبون أنفسهم إليها، سواء كان زعيمًا سياسيًا أو مطربًا هبابيًا، أو تاجر أغذية فاسدة يعلق على باب دكانه لافتة تقول «جزار الجماهير»، ولأن نجمة الجماهير قد استهلكت فى أفلامها السابقة كل الموضوعات التى تصنعها فى الإطار الذى تشغف به، والصورة التى تتوهمها عن نفسها باعتبارها الأنثى الخالدة التى يكفى أن ترمش بعينها اليسرى لتسقط المنظومة الاشتراكية، وأن تغمز بعينها اليمنى لينهار النظام العالمى الجديد، وأن تهز وسطها فيسود الكساد السوق الأوروبية المشتركة، فمن حقها أن تبحث عن أدوار جديدة غير أدوار تاجرة المخدرات وراقصة البارات وخادمة البيوت والفيلات حتى لا تموت الجماهير كمدًا، إذا ضنت عليهم نجمتهم المفضلة بأقوالها المأثورة من نوع «سلم لى ع الباذنجان».
أما الذى ليس من حق نادية الجندى، فهو أن تعيد تفصيل التاريخ ليصبح محبوكًا على مقاس وسطها، وأن تقص وقائعه لكى تتناسب مع فتحة ديكوليتيه الفساتين التى تحب أن ترتديها، وهذا هو ما فعلته فى فيلمها الأخير «الجاسوسة حكمت فهمى»، الذى تظهر فيه شخصيات تاريخية بأسمائها الحقيقية كالفريق عزيز المصرى، والرئيس الراحل أنور السادات، والجاسوس الألمانى إبلر، وقائد الجناح حسن عزت وعديد من ضباط جيوش الحلفاء لكى تشترك فى رواية وقائع لم تحدث فى التاريخ، أو حدثت على غير الصورة التى يرويها بها الفيلم.
ولأن نجمة الجماهير هى التى تقوم بدور حكمت فهمى فقد كان ضروريًا أن يقوم الفيلم بتزوير التاريخ لكى تظهر فى كل ديكوراته من الكباريه إلى غرفة النوم إلى الحمام، ولكى تتكلم فى كل موضوع من خليط الزيوت الذى يحول الرجل إلى حصان إلى البغبغة فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والتغنى بحب الوطن، وكان منطقيًا أن يحول الفيلم عزيز المصرى والسادات والآخرين من أبطال إلى كومبارس، مع أن الحقائق التاريخية تقول العكس تمامًا، فعملية التجسس «كوندوز» التى يروى الفليم قصتها- لم تستمر سوى أربعة أشهر بين يونيو «حزيران» وسبتمبر «أيلول» ١٩٤٢، والدور الذى لعبته فيها حكمت فهمى، والمعلومات التى نقلتها إلى الألمان لم تكن لها أهمية ولم تصل إلى حد سرقة خطة الحرب من تشرشل الابن كما زعم الفيلم.
وهذه الحقائق تؤكد أن الفيلم يكذب مع سبق الإصرار حين يحول حكمت فهمى، من جاسوسة مزدوجة للمخابرات الألمانية والمخابرات الإنجليزية إلى مناضلة وطنية، وحين يزعم أنها كانت حلقة الوصل بين الفريق عزيز المصرى ومجموعته من ضباط الجيش الوطنيين، وبين الجاسوس الألمانى، وحين يدَّعِى أن السادات، كان ينقل إليها رسائل عزيز المصرى لتنقلها.. إلى «إبلر» إذ من الثابت أنها لم تقابل عزيز المصرى، إلا بعد أن ضمهما سجن واحد، ولم تتعرف إلى السادات على الإطلاق، ولم تتعرض لأى تعذيب بعد القبض عليها- بل عوملت معاملة طيبة، وأوصى بها الميجور سامسون، إدارة السجن تقديرًا لما سماه خدماتها للإمبرطورية ولم يحدث أنها حوكمت أمام مجلس عسكرى بريطانى، أو حكم عليها بالإعدام، ولم يقم أنور السادات بإنقاذها قبل ثوان من تنفيذ الحكم كما جاء فى نهاية الفيلم، لسبب بسيط، هو أن السادات ذات نفسه كان سجينًا فى ذلك الحين، إذ اعترف عليه الجاسوس الألمانى بعد يومين من القبض عليه.
وإذا كان من حق السينما حين تكتب التاريخ، أن تغير فى بعض التفصيلات استجابة لضرورات الدراما، فإن ما فعلته نادية الجندى هو قلب للحقائق، وتبديل للوقائع وكتابة للتاريخ على واحدة ونص.
أما وقد أغرى نجاح هذا الفيلم نجمة الجماهير بالانضمام إلى طائفة المؤرخين، فأعلنت أن فيلمها التالى سيكون فیلم «ناهد رشاد» المرأة التى حكمت مصر، فلماذا لا يبادر اتحاد المؤرخين العرب فيمنحها عضويته الشرفية، ولماذا لا يغير شعاره إلى «سلم لى ع الباذنجان».