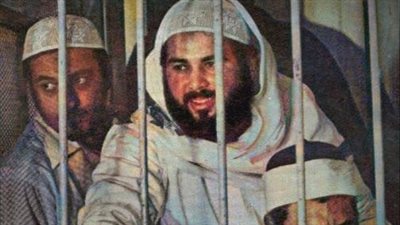معًا من أجل الحياة.. وصية خالد محمد خالد الباقية

- قال المسيح: «أحسنوا إلى مبغضيكم وصَلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم»
- إن حب الله، يعنى حب آثار رحمته جميعًا من بشر وشجر وحجر
- لقد احترم الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة فى كل حىّ.. فى الإنسان.. والحيوان.. والطير
- إن الزرع الجيد هم الناس الطيبون.. والزرع الردىء هم الناس الخطاءون
- إن من يحترم الإنسان والحياة مثلما احترمهما المسيح والرسول لن يكون حرصه على السلام إلا عظيمًا
- لم يقاتل الرسول حين قاتل من أجل توسع أو امتلاك أو سيادة بل حصر جهاده «فى سبيل الله»
«أنا خبز الحياة»..
كان المسيح يُهدى إلى الحياة من خير ما فى نفسه، حين قال هذه الكلمات..
وإنها لتحمل من الطرافة.. بقدر ما تحمل من الحكمة الغنية الحافلة.
وإنها لتثير تساؤلًا، وعجبًا..؟!
فماذا كان يعنى المسيح بالخبز..؟؟
أكان يعنى المذاق المادى لطيبات الحياة، وهو الذى قال: «لا تطلبوا أنتم ما تأكلون.. وما تشربون»..؟؟
ولماذا اختار هذا التركيب بالذات «خبز الحياة».
لماذا، وهو العابد الأوَّاب، لم يقل أنا خبز الإيمان.. أو: أنا خبز التقوى.. أو خبز الآخرة..؟؟
لماذا آثر «الحياة». وقال «أنا خبز الحياة»..؟؟ «يو ٦: ٤٦٫٣٥».
ألا إن الجواب ليسير.

فالحياة. هى «الموضوع» الذى جاء المسيح ليجلوه للناس، ويشرحه، ويلقى فيه درسه البليغ..
هى «الأم» التى جاء المسيح، كما جاء محمد، وكما جاء إخوة لهم من المرسلين، لينادوا إليها أبناءها الشاردين عنها.. وليحيوا فى أنفس الناس.. شعائر البرّ بها، والولاء لها..
وإذا كانت الحياة لا يظفر بها، ولا يحياها، إلا أولئك الذين يكون لهم وجود حقيقى، فقد جعل الرسولان العظيمان نصب أعينهما، اكتشاف هذا الوجود الحقيقى للإنسان..
ووجودنا الحقيقى، يبدأ من أين..؟؟
يبدأ من حيث توجد وتمارس العلاقات الصحيحة مع كل ما حولنا.. ولقد كان اكتشاف هذه العلاقات، أكثر ما عاش له، وعمل فى سبيله، محمد، والمسيح..
لقد كشفا للإنسان أزكى علاقاته، بالله.. وبنفسه.. وبالعائلة البشرية كلها.. وبالكون وأسراره الحافلات..
• أما علاقتنا بالله، فقد ارتفعا بها فوق كل رغبة، ورهبة.. وجعلاها حبًا خالصًا.
قال المسيح:
«الله محبة».. «يو ٤: ١٨٫٨».
وقال سيدنا محمد: «أفضل الأعمال، الحب فى الله»..
• وأما علاقتنا بأنفسنا، فقد ركَّزاها فى العمل الدائب على صقلها، وتعليتها.
قال المسيح: «ماذا ينفع الإنسان، لو ربح العالم كله، وخسر نفسه»..
وقال القرآن المنزل على محمد: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ «سورة الشمس ٩- ١٠».

• وأما علاقاتنا بالآخرين، فالتسامح المطلق، والتعاضد الوثيق.
قال المسيح: «أحسنوا إلى مبغضيكم، وصَلُّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم» «متى ٥: ٤٤».
وقال محمد: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»..
• وأما علاقتنا بالكون، وبأسرار الطبيعة، فهى التطلع الشغوف. والبحث وراء المجهول.
قال المسيح: «اقرعوا، يُفتح لكم» «متى ٧: ٧»
وقال القرآن الكريم: ﴿قُلْ سِيرُوا فِى الْأَرْضِ، فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ «سورة العنكبوت ٢٠».
عندما تتوافر لنا هذه العلاقات الرشيدة، تتولد من تفاعلها «حركة» دائبة، بانية، غايتها استثمار وجودنا.
واستثمار الوجود بما يقتضيه من حركة، وبما ينشئ من تّبِعة، وبما يُعطى من نتيجة: هو الحياة..
لقد أحبّ المسيح الحياة، بقلب حميم، وعشقها بروح وَدود.
كان كما وصف نفسه خبز الحياة.. لأنه غذاها بتعاليمه، وسقى مُثُلَها العليا، وَقيَمها الباقية من رُوحه.
ومن أراد أن يبصر حبّ المسيح للحياة، فليبصره فى الإنسان..
فقد كان الإنسان خير موضوعات الحياة عنده.. وأحبّ وأقرب أشكال الإنسان إلى قلبه.. الطفل.. إن «الإنسان الطفل» حبيبُ روحه، وصفىّ نفسه لأنه خير مثال للحياة الطالعة.. الصاعدة.. البريئة.. الصادقة..!!
إنه يحبّ الحياة، غضّة. مُترعرعة، ناضرة، لا تأثيم فيها، ولا مُخَاتَلَة.. ومن ثَمَّ مجد انعكاسها هذا على خير موضوعاتها- الإنسان الطفل- الذى يمثل الحياة الكاملة حقًا.. حين يُحاول.. وحين يتعثر.. وحين يشبّ وينمو..!
لنقرأ فى الإنجيل هذا النبأ: «.. فى تلك الساعة، تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم فى ملكوت السماوات..؟
«فدعا يسوع إليه ولدًا وأقامه فى وسطهم، وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات.. «متى ١٨: ٣»
«فمن وضع نفسه مثل هذا الولد، فهو الأعظم فى ملكوت السماوات.. «متى ٤: ١٨».
«ومن قَبِلَ ولدًا واحدًا مثل هذا، فقد قَبِلَنِى، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بى، فخير له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى، ويغرق فى لجة البحر»..!! «متى ١٨: ٥».
إن هذا الحَدَب العظيم على الطفولة الإنسانية، يمثل حَدَبًا أعظم على كل ما فى الحياة من خير، وجمال، وصدق، وسلام، وصعود..
وكل من يُعثر واحدة من هذه القيم التى تزين الحياة وتنمّيها، فقد أعثر طفلًا من أطفال الله الذين يحبهم، ويحرسهم، ويرعاهم..
ولأن الحياة عنده، تعنى الازدهار والاستمرار، كان كثيرًا ما يشبِّهها بالحقل، ويشبِّه نفسه بالزارع المثابر..
والحياة لدى المسيح، هى الحياة.. خيرها، وشرها.. حلوها ومرها.. خطؤها، وتجربتها..
وهو يحبها جميعًا.. ويحنو عليها جميعًا.. حتى فى شقائها، وفى أخطائها..
ضرب لنفسه ذات يوم مَثَلًا: «إنسانًا زرع زرعًا فى حقله.. وفيما الناس نيام، جاءه عدوه وزرع - زوانًا- فى وسط الحنطة، ومضى..

«فلما طلع النبات وألقى ثماره، ظهر الزوان بجانب الحنطة، فجاءه خدمه، وقالوا له: ياسيد، أليس زرعًا جيدًا زرعت فى حقلك، فمن أين له هذا الزوان..؟؟
«قال لهم: إنسان عدو فعل هذا..
«قالوا له: أنذهب، فنجمعه؟
«قال لهم: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع- الزوان- وأنتم تجمعونه»...!! «متى ١٣»
انظروا حنانه على الحياة، وأحيائها..
طالعوا بره بفضائلها، وبأخطائها..
إن الزرع الجيد، هم الناس الطيبون، والزرع الردىء، هم الناس الخطاءون..
وإنه ليرفض أن يقتلع الزرع الردىء رفقًا بالطيب، حتى لا يجتث معه، ويذهب بددًا.
ولكن؟ أكان يعنى إسلام مصير الطيب للخبيث..؟؟
كلا، فالمسيح لا يدع الرحمة تبطل العدل، ولا يتأتى لبره العظيم أن يعتاق سنن الكون، ونظام الحياة..
ومن أجل هذا، أتم المثل الذى ضربه، فقال: «.. دعوهما ينموا.. كلاهما معًا إلى الحصاد..
«وفى وقت الحصاد، أقول للحاصدين: «متى ١٣: ٣».
أجمعوا أولًا- الزوان- واحزموه حزمًا ليحرق.. وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزنى»...!! «متى ١٣: ٤٫٣».
ترى، لو أمكن تحويل هذا الزوان إلى زرع طيب. وحنطة جيدة. أيكون مصيره الحرق أيضًا..؟؟
بالبداهة. لا.. وهنا يُتم حرص المسيح على الإنسان وعلى الحياة دورته، فيبذل جهده ليحوّل الزوان إلى زرع نضير. وقمح وفير..
يُحوّل الشرّ إلى خير.. والإنسان الضالّ إلى إنسان آمين مستقيم.
«أنا ما جئت لأدْعُوَ أبرارًا للتوبة، بل خطائين».. «متى ٤: ١٣».
«ما جئت لأهلك أنفس الناس، بل لأخَلِّص». «متى ١٨: ١١».
ولقد أحبّ «محمد» الحياة حبًا عزيزًا نقيًا، وكان لها صديقًا، أىّ صديق..!!
أحبها فى كل مظاهرها. ونَبضِها.
فإذا هطل المطر، سارع إليه كاشفًا عن صدره، ليتلقَّى رذاذه الندى الرطيب وليس بينهما حجاب..
وإذا بزغ الهلال، استقبله فى إخبات وحفاوة. وناجاه قائلًا:
«ربى وربك الله»..
ويسير بين الحقول- وما كان أندرها فى بلده- فإذا وقعت عيناه على براعم تتفتح. دنا منها، ومسها بيد حانية. ثم انحنى عليها، ولثمها بفم شكور. وغمرها بفيض من مودته وصداقته، ثم همس إليها قائلًا:
«عام خير وبركة، إن شاء الله»..!!
وإذا طلعت الشمس استقبلها دَاعيًا مبتهلًا وحين تغرب، فلها منه تحية الوداع..
ولكأنما سارع الله إلى هواه. وشاء أن يزكى صداقته الحميمة للكون. والحياة، فأقسم فى قرآنه الكريم بـ«الليل» إذا يغشى.. والنهار، إذا تجلى..» وأقسم بـ«الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جَلَّاها»..
لقد احترم الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة فى كل حىّ.. فى الإنسان.. والحيوان.. والطير.
فى الأبيض.. والأسود.. والأصفر..
فى عظمتها. وفى بؤسها.
مرت به ذات يوم جنازة، فوقف لها فى خشوع.. حتى إذا جاوزته قال له أصحابه: يا رسول الله، إنها جنازة يهودى.. فأجابهم
«سبحان الله..!! أليست نفسًا»..؟؟!!
ولم يُطِق أن يرى الحياة تتعذب فى «هِرَّة» فقال محذرًا:
«دخلت امرأةٌ النار فى هِرَّة حبستها، فلا هى أطعمتها، ولا هى تركتها»..
بل أراد أن يملأ الأفئدة بتقديس الحياة، حتى لايبقى فيها مكان أى مكان لا متهانها.. وساق هذه القصة القصيرة، والمثيرة:
«بينما بغى تسير ذات يوم، إذ رأت كلبًا يلهث من العطش، فخلعت موقها- أى نعلها- وأدلته بحبل فى بئر، وملأته ماء، وسقت الكلب؛ فشكر الله لها، وأدخلها الجنة»..!!

وحبه للحياة، جعله يرفض أن يحياها مترفًا، لأن الترف يذهب ببهجة معاناتها..
«نحنُ قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا، لا نشبع»..
ورفض أن يحياها متجبّرًا، لأن التجبر افتيات على قداستها..
﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾.. «سورة الكهف ١١٠».
ورفض أن يعزله الجهل عن حقائقها..
﴿رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا﴾.. «سورة طه»
«اطلبوا العلم ولو فى الصين».
ولم يحدث قط أن تحدث القرآن عن الحياة حديث استخفاف وتحذير، إلا وهى مقرونة بكلمة «دنيا».
﴿الحياة الدنيا، لعب ولهو﴾.. «سورة الحديد ٢٠».
﴿وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾.. «سورة آل عمران».
﴿وأثرناهم فى الحياة الدنيا﴾.. «سورة المؤمنون ٣٣».
وقال عن الذين يعيشون كالأنعام، لا دور لهم فى الحياة:
﴿إن هى إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا﴾.. «سورة الجاثية ٢٤».
فالحياة المقرونة بهذا الوصف..
الحياة «الدنيا»..
الحياة الصغيرة الضئيلة، التى لا تحليق لها، ولا تبرير فيها، هى التى يذكرها القرآن دومًا فى مجال الاستخفاف..
أما الحياة العظيمة..
الحياة الصالحة، فالمسيح خُبزها.. ومحمد صديقها...
قلت: إن علاقاتنا السديدة بالله.. وبأنفسنا.. وبالعالم.. وبالكون جميعه.. تمكّننا من استثمار وجودنا..
وقلت: إن استثمار الوجود يعنى أننا نمارس الحياة..
وأقول: إننا على أبواب هذه الممارسة نلتقى بعلاقات أخرى تربطنا بالحياة، وتشدنا إليها..
وكلما كانت هذه العلاقات صافية، صادقة، جادة.. كانت الحياة بالنسبة لنا فرصة عظيمة مباركة..
أما إذا اعْتَوَر هذه العلاقات الزيف، والانحراف، والكذب، فإن الحياة حياتنا تفقد جمالها، وقيمتها..
وقد نستطيع أن نتصور هذه العلاقات فى:
• الحب..
• الصدق..
• العمل..
كل أشياء الحياة، بينها مودَّة وإلاف.. حتى الخير والشر اللذان يبدوان لنا نقيضين لا يتفقان، وضِدَّين لا يجتمعان.. يسرى بينهما «شِرْيَان» خفىّ من التجاذب والتعاون.. وكثيرًا ما تعمَى السُّبل على الخير، فيتقدم الشر ويفتح أمامه الطريق..!
والأرض. وما حولها من كواكب، تألف الشمس، وتحبها، وتنجذب نحوها..
ونحن ننجذب إلى الأرض فى حنان، واضطرار..
وهكذا، فالحب الذى نسميه «جاذبية» ليس مجرد فضيلة، ولا مجرد عاطفة.. إنما هو «قانون» يحفظ لأصحابه الوجود، والبقاء..
وسكان هذا الكوكب- نحن البشر- فى حاجة أكيدة، لإدراك هذه الحقيقة إدراكًا سديدًا..
وبالأمس.. الأمس البعيد، الذى أرسل فيه محمد، والمسيح، كنا فى أشد حاجة لهذا الإدراك..
فغرائزنا التى خرجنا بها من الغابة.. ونُظُمنا الملأى بالتناقضات.. كثيرًا ما تجعل منا خصومًا وأعداء، والحب منتصر حتمًا آخر الأمر، لأنه كما أسلفنا، ليس عاطفة، بل «قانونًا».. بَيْدَ أن ذلك لا يعنى السكوت عن دعوة الناس إلى ممارسة هذا القانون، وإحياء شعائره، والتزام جادَّته..
ولقد جاء الرسولان الكريمان ليناديا الخليقة إليه.. إلى الحب، والإخاء..
وأروع ما فى دعوتهما للحب من شواهد، هو إسقاطهما ذنوب المتحابين فى الله، وجعلهما «الحب» رحمة واسعة، تذوب فى دفئها، الخطايا والآثام.
فالمسيح وهو يفسر سبب المغفرة الشاملة التى بَشَّرَ بها الخاطئة، يقول: «لقد أحبَّت كثيرًا، فَغُفِرَ لها كثيرًا»..!! «لو ٧: ٤٧».
ومحمد...
يُساق إليه ذات يوم رجل من المسلمين، كان قد اعتاد احتساء الخمر.
ولم يكد أصحاب الرسول الجالسون معه يبصرون الرجل قادمًا. يُمْسِك بعضُ الصحابة بتلابيبه. حتى قالوا فى ازدراء وضجر: «لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتى به شاربًا»..!!
ولكن الرسول لا يستريح لما يسمع منهم. فيقول لهم فى اهتمام:
«لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله»..!!
وهكذا، يقيم المسيح والرسول، المعيار الحق لفضيلة الإنسان أى إنسان وهذا المعيار.. هو.. الحب..
وحب الله ورسوله هنا، يمثل مجالًا أرحب مما قد يتبادر إلى أفهامنا.
إن حب الله، يعنى حب آثار رحمته جميعًا من بشر، وشجر وحجر.
يعنى حب الحياة كلها، والإنسانية التى هى زينتها، ولُبابها.
لقد غفر المسيح للخاطئة، لأنها كانت تتصل بالحياة العظيمة عن طريق علاقة من أوثق علاقاتها، وهى المحبَّة.
ورفض محمد، أن يُلعن رجلًا سكيرًا، لأنه كان يرعى فى فؤاده نفس العلاقة..
وفى الوقت الذى تكون علاقتنا بالحياة قائمة، وصادقة، فإن أخطاء السلوك، نفقد ضراوتها وقيمتها، ما دامت لا تأخذ طابع التحدى والإصرار..
والحب- كما قلنا- أوثق علاقاتنا بالحياة.
ولقد يأخذ فى مصطلحاتنا أسماء شَتَّى، فتارة نسميه الرحمة، وأخرى نسميه الإخاء، أو التعاون، أو البر..
ولكن اسمه الحق سيظل كما هو الحب..
وسيظل «أبًا» لكل العلاقات، والقيم، التى تربطنا بالحياة وتجذبنا نحوها.
وتكفير الخطايا بالحب، على النحو الذى رأيناه الآن من الرسولين الكريمين يشير إلى تفسير جديد للخطيئة وللذَنْبِ..
فأفعالنا التى توصف بأنها خطايا، إنما حملت هذا الوصف، لأنها تثبط ولاءنا للحياة، وتؤذى علاقتنا بها..
وتكون أفعالنا شرِّيرة، لا بقدر ما تحمل من شَرّ، فليس للشر وجود ذاتى.. بل بقدر ما تعزلنا عن العلاقات الرشيدة الصحيحة الفاضلة التى تربطنا بالحياة، وتربط الحياة بنا..
لذلك صوّرا فرحهما العظيم، بل وفَرَح الله من قبل، بالإنسان التائب.. أى الإنسان الذى يعود إلى تصحيح موقفه من تلك العلاقات التى تصدأ. وتصدأ. ويعيدها بسببها حيًا، وكريمًا..!!
ضرب المسيح لهذا مثلًا:
«.. ابنًا أخذ المال الذى أعطاه له أبوه، وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بَذَّر ماله.. فلما أنفق كل شىء، حدث جوع شديد وبدأ يحتاج، واشتغل أجيرًا لواحد من الناس، يرعى له خنازيره..
«وكان يشتهى أن يملأ بطنه من الخرنوب الذى كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد..
«فرجع إلى نفسه، وقال: كم أجيرًا عند أبى يفضل عنه الخبز، وأنا أهلك جوعًا.. أقوم وأذهب إلى أبى، وأقول له: يا أبى، أخطأت ولستُ مستحقًا أن أدعى لك ابنًا، اجعلنى كأحد أُجرائك..
«وقام، وجاء إلى أبيه..
«وإذ كان لم يزل بعيدًا رآه أبوه، فتحنَّن وركض، وأسرع إليه وقبَّله، وقال لعبيده:
«أخرجوا الحُلَّة، وألبسوه، واجعلوا خاتمًا فى يده، وحذاء فى رجليه، واذبحوا العجل المسَمّن وأطعموا الناس، ونادى قائلًا:
«لنفرح، ونُسرّ، لأن ابنى هذا كان مَيِّتًا، فعاش، وكان ضالًا، فَوُجد»..!!
وبعد أن ينتهى المسيح من ضرب هذا المثل يدير بصره الودود على الوجوه المصغية إليه، ويقول.
«هكذا الله.. أبوكم السماوى.. يشتاق أن يرى أبناءه البشر يعودون إليه تائبين»..!!

وضرب الرسول مثلًا:
«للَّه أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فَلَاة.. فانفلتت منه دابَّته وعليها طعامه وشرابه.. فأيِسَ منها.. فأتى شجرة، فاضجع فى ظلها، قد أيس من راحلته..
«فبينما هو كذلك، إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت (عبدى) وأنا (ربك).. أخطأ من شدة الفَرح»..
ويأخذ الرسولان الكريمان قلوبنا إلى الحب أخذًا وثيقًا، بما يتركان لنا من قدوة تتمثل فى سلوك صادق وعظيم.
فالمسيح فى إحدى أمسياته الأخيرة على الأرض، يقوم عن طعام العشاء، ويأخذ «منشفة» ويتزر بها، ثم يصب الماء فى آنية، ويدعو تلامذته، فيغسل لهم أقدامهم واحدًا، واحدًا، ثم يجففها بالمنشفة التى معه..!!
ويغشى تلامذته الحياء والفزع، ويحاولون منع المسيح، لكنه يواصل عمله العظيم، وهو يقول لهم:
«الآن تعلمون تفسيره».
وبعد أن ينجز غسل أقدامهم وتجفيفها، يقول: «أنتم تدعوننى معلمًا، وسيدًا.. وحسنًا تقولون، لأنى كذلك..
فإن كنتُ، وأنا السيد المعلّم، قد غسلتُ أرجلكم.. فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض»..!! «متى ١٣: ١٤».
ويخصب محمد واحة المحبة بكل عاطفة ريَّانة طيبة، فيوصى الناس قائلًا: «إذا أحب أحدكم أخاه، فليخبره أنه يحبه»..
«وإذا آخى الرجلُ الرجلَ، فليسأله عن اسمه، واسم أبيه، وممَّن هو.. فإنه أوصل للمودة»..
ويقول: «يقول الله عز وجل: المتحابون لجلالى، لهم منابر من نور، يغبِطُهم النبيّون، والشهداء»..
«إن من عباد الله أناسًا، ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، لمكانهم من الله تعالى..!
قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم..؟
قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها.. فو الله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس.. وقرأ هذه الآية.
﴿ألا إن أولياء الله لا خَوْفٌ عليهم ولا هم يَحْزَنون﴾..!! (سورة يونس ٦٢)».
إن الرسول يرفع الحب فوق مستوى المنفعة والغرض.. فيقول: «تحابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها».
وهو أيضًا يقرر أن الحب يغطى ضعفنا، ويرفعنا إلى كل مكانة عالية، عجزت أعمالنا عن أن تصعد بنا إليها..
وذلك حين سأله «أبو ذر»: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم؟
فيجيبه الرسول: «المرء مع من أحَبَّ»..
إن الحب هو الزاد الذى يردُّ عن البشرية سَغبها المضنى، وهو الرِّىُّ الذى يدفع عنها ظمأها القاتل.
وهى لا تستطيع أن تحيا ما لم تحب، لأن الحب هو الآصرة العظيمة التى تجمعها بالحياة، وتمنحها الجناحين اللذين تحلِّق بهما وتطير.
والصدق..
إنه العلاقة الثانية التى نرتبط بها مع الحياة.. ومكان الصدق من الحب، جد قريب.
فنحن نكذب حين نخاف..
نكذب على الناس حين نخافهم.. ونكذب على القانون، حين نخافه.. بل نكذب على أنفسنا ونخدعها، حين نخافها..
ومع الحب، لا يوجد خوف.. وإذن، لا يوجد كذب..!
والصدق هنا، أبعد مدى، وأرحب مفهومًا من مجرد الإخبار بالواقع..
أعنى، ليس هو قول الحق وحسب.. بل هو أن نعيش الحقَّ نفسه.
هذا، هو الصدق، كعلاقة تربطنا بالحياة، وهو يعنى تحرير أنفسنا من كل ما يجعلها تحيا حياة زائفة مزورة.
يعنى أن يشتملَنا تطابق واضح، بين ظاهرنا وباطننا، بين حياتنا الباطنة، وحياتنا الظاهرة.
ويعنى أن نكون قوَّامين بالقسط، ولو على أنفسنا.
ويعنى أيضًا، بذل أقصى الجهد فى كل عمل نعمله. وفى كل موقف نتخذه..
ولقد علَّمنا هذا محمد، والمسيح.
لقد شنَّا على الرياء هجومًا عنيفًا.. وأخبر الرسول أن «ذا الوجهين، يُدعى عند الله كذابًا».
فالرياء كذب.. والكذب تزييف لعلاقة ثمينة من علاقات الحياة، وقيمها، وهى الصدق.
من أجل هذا، كان الرسولان يحتفيان بكل مخطئ يتقدم، وفى يده وثيقة إدانته.
هذا الذى يسميه عصرنا الحديث. بـ «النقد الذاتى».
ولطالما ضرب الله برسوله المثل، واصطنع منه القدوة..
فإذا أخطأ مثلًا مع إنسان ضرير.. ولو بحسن نية، وقف فى محراب الصلاة، والناس من ورائه صفوفا ينصتون له، وهو يتلو عليهم وثيقة اعترافه، وأوْبَته:
﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ (١) أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ (٥) فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ (٧) وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ (٨) وَهُوَ يَخْشَىٰ (٩) فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١)﴾..!! «سورة عبس».
وإنه ليخدش أعرابيًا ذات مرة، دون عمد. فيصرُّ على أن يخدشه الأعرابى مثلها..!!
ويقف فوق المنبر فى جلال عظيم، ليقول لأصحابه الذين يستمعون له: «من كنت جلَدت له ظهرًا، فهذا ظهرى فَلْيَقْتَدْ منه.. ومن كنتُ أخذت من ماله شيئًا فهذا مالى فليأخذ منه»..!!
إنه لم يجلد فى حياته ظهرًا، ولم يؤلم لأحد ظُفْرًا.. ولكنه الصدق المطلق مع الحياة، يُمارسه الرسول فى أنقى صُوره، وأوفاها بالذمَّة والطُهر..
وإذا كانت حياته لم تتلقَّع قط برياء أو ضعف، فهى كذلك لم تتلقَّع قط بغرور، ولا بصَلَف..
لقد كان يسابق زوجته، ويخصف نعله بيده، ويُرقع ثوبه بنفسه.
ولقد حلب شاته.. وخدم أهله.. وحمل الطوب مع أصحابه فى بناء مسجده.. وربط على بطنه الحجر من الجوع..!!
وكان إذا سار فى الطريق، ومعه أصحابه، دعاهم ليتقدَّموا عليه..
وإذا قدم عليهم، وهم جلوس، جلس حيث انتهى به المجلس..
وكان يقول لهم دائمًا، حين يدعونه لتكريم خاص:
«إنى أكره أن أتميزَ عليكم»..!!
هذا هو الصدق مع الحياة..
أن نعيشها، عادلين، طيبين، واضحين، ودعاء، بُسَطاء..
وأن نمارس مسئولياتها، ونعانق واجباتها، لا أن نتبذَّخ بما فيها من فراغ وتَرَف وجاه..
اقرأوا..
«.. وفيما كان يسوع صاعدًا إلى أورشليم، أخذ الاثنى عشر تلميذًا على انفراد فى الطريق.
وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يُسَلَّم إلى رؤساء الكهنة، والكتبة، فيحكمون عليه بالموت.
.. حينئذ، تقدمت إليه أم ابنى زبدى مع ابنيها، وسجدت، وطلبت منه شيئًا، فقال لها: ماذا تريدين..؟
قالت له: أن يجلس ابناى هذان يعقوب ويوحنَّا واحد عن يمينك، والآخر عن اليسار فى ملكوتك..
«فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان.
«أتستطيعان أن تشربا الكأس التى سوف أشربها أنا»..؟! «متى ٢٠: ٢٢٫٢١٫٢٠٫١٨٫١٧».
ما أجزلها من عبارة..!!
فالحياة، ليست منصبًا فَخْريًا، ولا وُجُودًا شَرَفيًا..
إنما هى عمل جسيم دائب صادق..
وهنا نلتقى بعلاقة أخرى من علاقاتنا بالحياة..
إنها العمل..
والحياة بغير عمل، تفقد ذاتها.. فهى عمل مستمر، وصاعد.
هى حركة أزلية، وأبدية خالدة.. كل شىء فيها يموج بالحركة والمثابرة..
هذه المياه الجارية. هذه الرياح السارية.. هذه الأشجار، والأزهار.
بل هذه الصخرة التى تبدو جامدة.. والخشبة التى نحسبها خامدة. كلها، وكل أشياء الحياة تُزاول حركة دائبة، ونشاطًا موصولًا.
لكن العمل قد ينحرف فيفقد على الفور مزيته، وقيمته.
من أجل هذا، عُنى «خُبز الحياة» كما عُنى «صديقُها» بأن يُزكيا جميع الخصائص التى تحتفظ للعمل بقيمته وبنقائه.
لقد أرادا للعمل أن يكون دائمًا: جليلًا.. نافعًا.. مستمرًا.. صاعدًا..
فالعمل الجليل، النافع. المستمر المُوَلّى وجهه شطر الأمام.. لا الزاحف إلى الخلف.. هذا العمل يمثل أسمى واجباتنا، كما يمثل علاقة كبيرة من خير علاقاتنا بالحياة..
وجلال العمل، يعنى الارتفاع بقدراتنا إلى مستوى الكمال الميسور.. حتى نحقق بها عظائم الأمور، ولا نقنع بصغارها..
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا: «إن الله يحب معالى الأمور. ويكره سفسافها».
ويقول المسيح، مطالبًا الناس بمزيد من العمل، وبعيد من الهمة.
«كل من أعْطى كثيرًا.. يطلب منه الكثير».. «متى ١٢».
ويقول محمد: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»..
ويُحذِّر من الأعمال الناقصة المبتورة، ويؤثر العمل المستمر، ولو كان قليلًا، على العمل الأبتر، ولو كان كثيرًا. ويضرب لهذا مثلًا جميلًا حين يقول: «فَإِنَّ المنبت، لا أرضًا قطع.. ولا ظهرًا أبقى»..!!
وهو يريد من العمل أن يكون واعيًا، وأن يكون فى خدمة التقدم الإنسانى.. ولا يكون انتكاسًا أو ردة إلى الوراء..
وإنه لعظيم باهر، وهو يقول فى هذا ما معناه.
«يُذاد أُناس من أُمَّتى عن الحوض يوم القيامة! فأنهض لأشفع لهم، فيقول الله لى:
«يا محمد، لا تفعل.. إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك..
فأقول: يا رب، وما أحدثوا..؟
فيقول سبحانه: إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم»..!!
والرسول كما ذكرنا قبلًا وكذلك المسيح، كانت دعوتهما حركة جديدة سائرة نحو المستقبل، متجهة إلى الأمام دَوْمًا.
وإنهما ليُلجلان العمل، ويهيبان بنا أن نرتفع به فوق كل عرض ردىء، ونجنبه كل انحراف وزيف.
والإنسان الذى يقضى حياته فى عمل صادق نافع، يصير موضع رعاية الله وتقديره..
﴿لا أُضِيع عمل عامل منكم، من ذكرٍ أو أُنثى﴾ «سورة آل عمران».
ولقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا أحد أصحابه، وحين صافحه، أحسَّ فى كفه خشونة.. فسأله: «يا سعد، ما بال كفَّيك قد أمْجَلتا»..؟!
فأجابه سعد: — من أثر «العمل» يارسول الله.
فرفع الرسول كَفَّىْ سعد إلى فمه وَقَبَّلهما، ثم قال.
«كفَّان، يحبهما الله، ورسوله»..!!
هكذا، كان بِرُّ محمد والمسيح بالحياة..
لم تجمعها بهما عاطفة عابرة. بل وعى رشيد، وإدراك سديد لقيمتها. ودَعْم هائل لكل القيم والقوى التى تبعث فيها الازدهار والتألقُ..
وعلى رأسها جميعًا ما ذكرناه- الحبّ- والعمل.
ولقد عاشا حياة مُترعة بالحب، وبالصدق، وبالعمل.
وكان لهما مع الزمان رحلة من أمجد، وأنفع، وأبقى الرحلات.
واليوم، ونحن نشيد من آمالنا، ومن إصرارنا بناء عزم جديد قادر، نريد أن نحمى به حياتنا من الدمار، ولنَنْحَنى إكبارًا لهذين الرائدين الجليلين ولإخوة لهما سبقوهما بالإيمان وبالسعى، من أجل أن تبقى الحياة مزدانة بأحياء مباركين.
وإذا كانت الحروب هى شر ما يحيق بالحياة من خطر..
وإذا كان «محمد. والمسيح» قد أعلنا فى ولاء وإصرار، حق الحياة فى الحياة.
فإنه لمن الضرورى إذن أن نُبصر موقفهما من السلام، وكيف أراداه، وعلى أية صورة تمثَّلاه..
وإنه لمن الخير لأنفسنا أن نفقه جيدًا الدور الذى قام به محمد وصاحبه لإقرار السلام فى الأرض.. وجعله شعيرة من شعائر الله..!!
السلام..
عندما ترنُّ فى سمع الظامئ العطشان كلمة «ماء»..
وفى سمع الجائع السَّغْبان كلمة «خبز»..
وفى سمع المشرف على الغَرَق، المُتخاذل تحت ضربات الموج كلمة «شاطئ»..
لا يكون لهذا الرنين مهما يكن صادقًا، إلا قليلًا جدًا، مما هو للرنين الصاهل القوى المفرح، الذى تتركه فى عصر الذَرَّة كلمة «سلام»..!
ولو أن الحرب، وحدها هى التى تتهدد وجودنا كله، لهان الأمر، أو كاد.. غير أن الذى يُحاصرنا بأخطاره الماحقة، والذى تعتبر الحرب نفسها نتيجة له.. هو التفكير المُلتاث المغرض..
وإنى لأذكر الفزع الشديد الذى غشينى ذات يوم قريب، حين طالعت خطابًا، أو تصريحًا لرجل مسئول فى أوروبا، يشغل منصبًا خطيرًا يقول: «لا بد من الحرب، دفاعًا عن الحضارة المسيحية»..!!
وقلت لنفسى يومها: مسيحية، وحرب..؟
أى اتفاق «سعيد» هذا..!!؟
إن هذه العبارة، التى تقال فى عصرنا هذا، المتحضِّر كثيرًا، والمتقدم جدًا.. لتشير إلى «الفضيلة» التى طالما تنكرت فيها «رذيلة» العدوان والبَغى..
فمعظم الحروب التى أثخنت جروح الحياة، كان لها منطق تسويغى، وحجة تبرر قيامها، وتمنحها المشروعية، وجواز المرور..!!
فباسم الدفاع عن الأديان تارة.. وباسم الحرية، وحماية حقوق الإنسان تارة أخرى.. وباسم تمدين الشعوب المختلفة.. وباسم المجال الحيوى للدول التى ضاقت الأرض فيها بأهلها..
وباسم أشياء كثيرة، كانت تبدو، وكأنها منطقية وعادلة.. قامت حروب صبغت الأرض بالدم.. وغطَّت ترابها بالأشلاء والجماجم..
وكان وراء تلك الحروب.. ووراء شعاراتها الكاذبة ذلك الذى أسميناه آنفًا.. بالتفكير المُلتاث المغرض..
هو «مُلتاث».. لأنه يجهل إرادة التاريخ..
«ومغرض».. لأنه يُقاومها ويتحداها..
أى أنه بتعبير آخر.. كان وراء تلك الحروب، جهل بإرادة التاريخ، وعصيان لها.
وهنا، نضع أيدينا على «نقطة البدء» فى موقف محمد والمسيح من الحرب، ومن السلام..
وهنا- أيضًا- تَفْنى تلك الشُّبهات التى تُلقى فى رُوع الكثيرين منا، أن لمحمد من الحرب موقفًا يُغاير موقف المسيح..
إن من يحترم الإنسان، والحياة، مثلما احترمهما المسيح والرسول، لن يكون حرصه على السلام إلا عظيمًا.
فالسلام، هو المجال الآمن الذى تترعرع فيه مواهب البشر، وقدراتهم، وهو السلوك الأوحد اللائق بناس يجمعهم على الأرض عناء مشترك.. ورجاء مشترك.. وسعى مشترك.
ناس، أبوهم واحد.. وأمهم واحدة..
ناس، ليسوا- مهما يتباغضوا ويتباعدوا - سوى إخوة وأشقاء..
من أجل هذا، كانت أولى الحقائق الجديرة بأن يرتد إليها صوابهم هى ذى..
ومن هنا، بدأ المسيح وأخوه دعوتهما للسلام..
قال المسيح لتلامذته: «معلمكم واحد، المسيح.. وأنتم جميعًا إخوة». «متى ٢٣: ١٠».
وقال محمد: «كونوا عباد الله إخوانًا.. كما أمركم الله تعالى».
ولم يكن «الإخاء» مجرد كلمة يرددانها- بل كان كما رأينا من قبل وخلال عرضنا لموقفهما من الإنسان.. عقيدة، وسلوكًا.
لقد ذكرنا فى مبتكر هذا الكتاب أن حياة كل من الرسولين العظيمين، كانت طاهرة، لا شية فيها.. ولم يحدث أن أخذ عليهما شىء- أى شىء- من التزيد والادعاء.
ولقد دعوا إلى الرحمة.. فكان لا بد أن يكونا رحيمين.. ودعوا إلى العدل، فكان لا بد أن يكونا عادلين.
ودعوا إلى السلام، فكان لا بد أن يكونا مسالمين.
ولقد كانا كذلك فعلًا.. وعند أكثر مستويات الكمال البشرى ارتفاعًا عاشا حياتهما، ومارسا دورهما الفذ العظيم.
إن أقوالهما فى السلام، لمشرقة إشراق الصباح المبلل بقطر الندى وإن سلوكهما مع السلام، لمجيد..!!
إن الناس يحاربون، ليفرضون مشيئتهم.
ولقد ألغى المسيح فرض المشيئة هذه حتى لو كانت مشيئة عادلة فاضلة.
قال لتلامذته وهو يوصيهم:
«وأية مدينة دخلتموها، ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا.. حتى الغبار الذى لصق بنا من مدينتكم ننفضه عنا»! «لو١٠: ١٠»
والناس يحاربون من أجل الأرض يستعمرونها، ويستغلونها.
ولكن استعمارهم هذا وغلبهم ذاك، لن يدوما.. وسيكون للمسالمين الودعاء جميع المستقبل، وجميع المصير:
«طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض». «متى ٥: ٥».
وهو- أعنى المسيح- يضع مبدأ هائلًا، ورشيدًا فى العلاقات الإنسانية، فيقول.
«من ليس علينا.. فهو معنا». «مر ٩: ٤٠».
وينفر من الحرب نفورًا شديدًا، ويحذر من عُقباها، فيقول: «كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب.. وبيت منقسم على بيت يسقط». «متى ١٢: ٢٥».
ويحب الحياة وديعة، مزدهرة، حافلة بالمباهج والحب، ويبث فى الأفئدة طمأنينة، وأملًا، ويخفف عنها روعها، ويتمنى للحياة عمرًا طويلًا فى هذه الكلمات: «إذا سمعتم بحروب وقلاقل، فلا تجزعوا.. لأنه لا بد أن يكون هذا أولًا.. ولكن لا يكون المنتهَى سريعًا»..!! «لو ٢١: ٩».
كم هى عذبة، وطيبة، ومتفائلة، كلماته الحانيات هذه.. «لا يكون المنتهى سريعًا»..؟؟!!
وما ترك- ابن الإنسان- ثغرة، تستطيع البغضاء، ويستطيع الشر أن ينفذا من خلالها إلى الحب وإلى السلام، إلا أوصدها، وتحاماه.
ومن الحب، والسلام، والإيمان، والطهر، شاد حول الحياة سياجًا لا يرام.
فدعوته المضروب على خده الأيمن، أن يعطى لضاربه خده الأيسر.
ودعوته من اغتُصب رداؤه، أن يترك الإزار أيضًا.
وتحذيره المجلجل، للذين تجىء منهم العثرات المفنية لهذا العالم.
وإعلانه، أن «كل من غضب على أخيه باطلًا، يكون مُستوجب الحكم». «متى ٥: ٢٢».
وقوله:
«إن أعثرتك يدُك فاقطعها». «مر ٩: ٤٣».
«ما جئت لأهلِك، بل لأخلِّص». «لو ١٩: ٥».
«أريد رحمة.. لا ذبيحة». «متى ١٢: ٧».
كل هذا الهدى، سياج منيع أقامه المسيح حول الحياة.
إنه لم ينتظر حتى يسىء الناس إلى الحياة بالقتل.. فتلقَّاهم دون ذلك بأبعاد بعيدة.. تلقاهم عند الغضب مجرد الغضب وصاح: هذا قتل..!!
فهل يعلم هذا جيدًا الذين يؤمنون بالمسيح فى زماننا، إنه لخليق بهم أن يعلموا..!
وخير لهم ألا يضلوا فى زحمة البغضاء والطمع، عن كلماته المضيئة.. ومشيئته السديدة.
ولمثل هذا الذى يعمل من أجله العاملون.. عَمِلَ إنسان من أكثر أبناء الحياة بَرًَّا بها، وغيرة عليها.
إنه «محمد»...
لقد وقف يُبَلِّغ عن ربه فى ولاء الصادقين. ويقين المرسلين أنه: «من قتل نفسًا بغير نفس، أو فساد فى الأرض، فكأنما قتل الناس جميعًا».
انظروا...
إن الحياة لا تتجزأ.
ليس هناك حياة لى.. وحياة لك..
إن الحياة كائن واحد.. وأى مساس بأى جزء منها، مساس بها كلها، وعدوان عليها جميعها..!!
وكما اعتبر المسيح البغضاء كالقتل.. اعتبر محمد القطيعة قتلًا، فقال محذرًا منها.
«من هَجَرَ أخاه سنة.. فهو كَسَفْكِ دمه»..!
وإنه كذلك ليعلم أن الناس يتحاربون ويتقاتلون من أجل الأرض يستعمرونها، فيحمى السلام من هذا السبب.. ويعلن أن من غير تخوم الأرض لينال شبرًا، ليس فيه حق، برئت منه ذمة الله، ورسوله..!!
ويختصم إليه اثنان: غرس أحدهما نخلًا فى أرض الآخر.. فيقضى لصاحب الأرض بأرضه، ويزمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها.. فتضرب أصولها بالفئوس فورًا..!
ويقول فى حديث زاجر عظيم: «من اغتصب شبرًا من أرض طُوِّقه إلى سبع أرضين».
ويعطى هذا المعنى مزيدًا من التوكيد، لعلمه بما يجره الغصب والطمع من شقاق، ونزاع. وقتال. فيقول.
«من اغتصب مال أخيه بيمينه- أى بالقوة- حرم الله عليه الجنة- وأدخله النار..».
سأله سائل: يا رسول الله، وان كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان عودًا من أَرَاك»!!
ويُسأل سيدنا محمد كما أسلفنا عن أفضل الأعمال،
فيجيب: «بذل السلام للعالم».
ويربط الإيمان بالحب ليُنشئا معًا سلامًا للحياة وأمنًا.. فيقول: «والذى نفسى بيده، لا تؤمنوا حتى تَحابُّوا.. ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟.. أفشوا السلام بينكم»..
ويرفع السعى من أجل السلام إلى مكانة تفضل جميع العبادات فيقول فى حديث رائع.
«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام؟؟
إصلاح ذات الْبَيْن»!!
ويستبعد كل أسباب الشجار، حتى التافه الضئيل منها، فيقول: «إذا مر أحدكم فى مجلس، أو سوق، وفى يده نبل فليأخذ بنصالها لا يخدش بها أحدًا»..!
ويبلغ عن الله سبحانه قوله: «وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ» «سورة فصلت ٣٤».
ويسأل سائل: يا رسول الله، دلنى على عمل، إذا عملته أكون قد فعلت الخير جميعًا.
فيجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام.
«لا تغضب»..!
لقد تتبع الرسول كل أسباب البغضاء، والحرب، فى سلوك الفرد، وفى سلوك الجماعة، فكافحها ونهى عنها.
ولعل سائلًا يسأل: إذا كان محمد قد أنزل «السلام» من قلبه، ومن شريعته هذا المنزل الرفيع.. فكيف إذن من حمل سيفه وحارب.. وكيف إذن، جعل الجنة تحت ظلال السيوف؟!!
سؤال عادل، ومنطق أمين..
والإجابة عنه ترجع بنا إلى نقطة مهمة بدأنا بها حديثنا عن السلام.. إذ قلنا إن الحروب تنشأ دائمًا، أو غالبًا من سبب واحد. هو جهل إرادة التاريخ، ومقاومتها.
حيث يوجد هذا السبب، يوجد لا محالة تحفز وحرب.
ذلك أن التاريخ، الذى هو تطور إنسانى زاحف، لا رادَّ لسيره.
التاريخ هذا.. ماض بالحياة إلى غايات جديدة دائمًا.
وكل مرحلة جديدة منه، تفرض نفسها بقوة الميلاد، وبقوة الضرورة التاريخية التى أهابت بها لتجىء.
كما أن مرحلة قديمة مائلة للغروب، تحاول التشبث والبقاء.
وتصطنع كل مرحلة لنفسها مؤمنين من الناس وأنصارًا..
وهنا يقف الجديد، والقديم وجهًا لوجه..
وحين تكون هذه المواجهة تكون الثورات، وتكون الأحداث الكبيرة. وكلما أمعن أنصار المرحلة الآفلة فى جهل إرادة التاريخ، وفى مقاومتهم لوليده الجديد، يكون الصدام أمرًا محتومًا..
وهذا ما حدث أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.
قامت حروب.. كان سببها الجهل بإرادة التاريخ، ومقاومة هذه الإرادة.
ولم تأت المقاومة من جانب الرسول. بل من الجانب الآخر المعادى له. أما هو، ودعوته. فقد كانا يمثلان الجديد القادم.. يمثلان إرادة التاريخ نفسه..
وهذا واضح تمامًا، من ظروف الدنيا أيام بعثته، ومن طبيعة دعوته التى جاء بها.. ولقد أشرنا لهذا فى الفصل الثانى من فصول الكتاب.
أنا لا أحاول هنا الدفاع عن الرسول، ولا أحاول تبرير نضاله.. فليس فى حياته العظيمة كلها ما يدعو لمثل هذه المحاولة.
وإنما أحاول اقتراض أن «السلام» نفسه تجسّد وصار إنسانًا.
فماذا كان هذا الإنسان صانعًا تجاه الظروف المعادية التى ناوأت محمدًا..
إن الإجابة عن هذا السؤال يسيرة، إذا نحن أدركنا المفهوم الصحيح للسلام.
فالسلام ليس هروبًا من المسئولية.. وليس إذعانًا لقوى الشر، وليس مسايرة للخطأ.. وليس عجزًا عن الاختيار، والممارسة.
وبعبارة واحدة: السلام قيمة تعبر عن نفسها بالإيجاب، لا بالسلب.
وأكثر الناس تقديرًا للسلام، وحاجة إليه، رسول جاء يدعو إلى عبادة الله، وتزكية النفس.
إن السلام يمثل «الوطن» لدعوة من هذا الطراز.
وقد لاذ محمد بهذا الوطن.. لا يريد من الناس سوى أن يتركوه يبلغ كلمات ربه. ويمارس واجبًا يملأ نفسه، ويدعو دعوة لا تقاوم، إلى التبشير به، والعمل فى سبيله.
وسارع، فأعلن «تعايشًا سليمًا» عادلًا.
﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ (٦)﴾ «سورة الكافرون».
ولكن أعداء التاريخ، لم يتركوه، ولم يمهلوه.. لم يذروا دنيئة إلا ارتكبوها معه.. حصبوه بالطوب.
سلطوا عليه سفاءهم، فغمروه بروث البهائم، وهو ساجد يناجى ربه..!!
حاصروا أهل، وعشيرته حصارًا اقتصاديًا خانقًا..!!
مارسوا شر الجرائم، وأرذلها، مع الفقراء والمستضعفين الذين اتبعوه..!!
ثلاث عشرة سنة، قضاها وسط مؤامرات لا تهدأ، واعتداءات لا ترعوى.. وهو فى صبره، وفى حلمه، وفى السلام الحق الذى يريده ويحبه، ويتمنى دوامه..
يمعنون فى إيذائه، وفى الكيد له.. فيمعن فى الصفح عنهم، وفى الدعاء لهم.
ولا تشغله جراحه الثاغبة، وآلامه اللاهبة عن الابتهال من أجلهم:
«اللهم اغفـر لقومى، فإنهم لا يعلمون»..!!
لنتأمل جيدًا كلمة لا يعلمون فإنها تمثل إدراك الرسول لحقيقة المشكلة جهل أعدائه بإرادة التاريخ، التى هى إرادة الله من قبل.
وما داموا- لا يعلمون- فإن واجب الرسول أن يعلمهم..
وهنا يتضح السر العظيم الجليل فى صبر الرسول عليهم ثلاثة عشر عامًا..
ويستبين فهمه الرشيد لحقيقة السلام، الذى هو إيجاب، لا سلب.. ومواجهة.. لا هروب..!!
لقد كان محمد، وهو يصبر على أذاهم، ويعلمهم، يمارس سلامًا حقيقيًا، فهو لم يحلم عليهم، ويصبر على هولهم.. خوفًا أو استسلامًا.
بل، لأنهم لا يعلمون.. وعليه أن يعلمهم..
لا يبصرون.. وعليه أن يفتح عيونهم.
وهذا، هو السلام..
السلام الإيجابى، الذى يواجه مسئولياته، دون أن يحمله العدوان على الهروب، ولا على المقاومة غير المشروعة..!
لكن هؤلاء- الذين لا يعلمون- يستنفدون- آخر الأمر- كل حقهم فى المعرفة، وكل فرصتهم فى السلام..
ذلك أنهم يصرون إصرارًا وبيلا، لا على التشبث بباطلهم فحسب.. بل وعلى خنق الدعوة وإبادتها.. وقرروا قتل محمد عليه صلاة الله وسلامه..
وحتى بعد هذه الجريمة السافرة، لم يشأ الرسول أن يقاوم.. على الرغم من أن المقاومة آنئذ، صارت حقًا مشروعًا له، بل وصارت تعبيرًا آخر عن العدل، وعن السلام..
لم يشأ أن يقاوم، وهاجر إلى المدينة.
ومن المدينة سارت الأحداث فى الطريق الذى يجعل المقاومة محتومة ولازمة..
لم يقاتل الرسول، حين قاتل، من أجل توسع، أو امتلاك، أو سيادة بل حصر جهاده «فى سبيل الله».
وعبارة «فى سبيل الله» هذه.. تمثل الإطار الذى خاض الرسول المعركة داخله.
فعلى كثرة الغزوات التى خاضها، لم يكن عدد الضحايا فيها جميعا، سوى بضع عشرات من كلا الفريقين..!
حين علم يومًا أن- خالد بن الوليد- أسرف فى القتل فى بعض غزواته، جلجل غاضبًا، ورفع يديه إلى السماء معتذرًا إلى الله، ضارعًا وهو يقول: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد»..!!
ولقد كان أمره لأصحابه بين يدى كل معركة: «لا تقتلوا امرأةً، و لا شيخًا، ولا وليدًا، ولا تحرِقوا زرعًا ولا نخيلًا، ولا تنهبوا، ولا تمثلوا بأحد، واجتنبوا الوجوه، لا تضربوها».!
كما جاء عيسى ليكمل الشريعة.. جاء محمد ليستأنف المسيرة.
ولقد كان «الصليب الكبير» الذى أعده المجرمون للمسيح.. يتراءى للرسول دومًا.
وما كان من الخير أن يمكن المجرمون من انتصار جديد.. يتملظون فيه بدوم رسول شهيد..!
وما كان من الخير أن تخنق دعوات الهدى فى المهد، كل مرة.
وإذا كان المسيح قد حمل «صليبه» من أجل السلام.. أقول «حمل» لا أقول «صُلب» فإنه قد شبه لهم، فخاب فألهم..!!
فإن محمدًا، قد حمل «سيفه» من أجل السلام.
كلاهما: سيف.
الصليب الذى حمله المسيح، سيف، أراد اليهود أن يقضوا به على «ابن الإنسان» ورائد الحق..
وسيف محمد، سيف، أراد محمد أن يقضى به على أعداء الإنسان وأعداء الحق.
وغاية الرسولين واحدة: السلام:
فى دور المسيح، كان السيف مسلطًا على الحق.
وفى دور محمد، كان السيف مسلطًا على الباطل.
وفى سلوك المسيح، عبر السلام عن نفسه بالرحمة.
وفى سلوك محمد، عبر السلام عن نفسه بالعدل.
وهكذا استكمل جناحيه اللذين يحلق بهما عاليًا.
والرسول لم يحترف القتال، ولم يكن له هواية..
وإنه ليعلم أصحابه، ويرسم لهم الحدود المشروعة للنزول:
«أيها الناس..
«لا تتمنوا لقاء العدو..»
واسألوا الله العافية..
«وإذا لقيتموهم، فاصبروا».
أرأيتم..؟؟
إنه إنسان ودود، مسالم.. لا يريد لقاء العدو، ولا يتمناه.
وإنه ليسأل الله فى ضراعة، أن يباعد بينه، وبين هذا اللقاء.
ولكن، إذا اضطره إليه واجب الدفاع عن الحق، وتأديب الباطل فسينهض من فوره، ويصبر على مشقات النضال..!!
ولقد عاش المسيح فى دعوته ثلاثة أعوام.
وعاش محمد فى دعوته ثلاثة وعشرين عامًا.
وعلى الرغم من قصر الزمن الذى عاشه المسيح داعيًا، وعلى الرغم من تنبئه بالتسامح المطلق.. فقد كانت مكايد المتربصين به تشد زناد غيظه، فيزجرهم بكلمات شِداد.. ويكاد- أحيانًا- يجنح إلى القصاص، ويشيد بالقوة العادلة..
فهو مثلًا يقول: «إذا شتمك أخوك، فوبخه.. فإن تاب فاغفر له».
ويقول: «حينما يحفظ القوى داره متسلحًا، تكون أمواله فى أمان».
وكثيرًا ما نراه، وهو يخاطب- أولاد الأفاعى- يحتدم غيظًا.. وكأنه يرغب فى أن يضربهم، ويدحرجهم على الأرض، كما فعل بموائد الصيارفة، وأقفاص الباعة حين دخل الهيكل.. ولكن إدراكه العميق لدوره. وإيمانه بأنه جاء الدنيا ليلقى عليها درسًا عظيمًا فى التسامح والمحبة جعلاه يكظم غيظه، ويشرب كأسه فى سلام..!!
قال لمن أراد أن يدافع عنه بسيفه، حين هاجمه أعداؤه ليلًا، ليأخذوه إلى رؤساء الكهنة، كى يحاكموه «رُدَّ سيفك إلى مكانه.. أتظن أنى لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبى فيقدم لى أكثر من اثنى عشر جيشًا من الملائكة..؟؟
«فكيف تكمل الكتب..؟ إنه هكذا ينبغى أن يكون»..!!
أجل.. هكذا ينبغى أن يكون.. «متى ٦: ٥٢».
ما دام قد جاء ليعلم الناس، كيف يمكن للحب أن يتفوق على الكراهية، وللسلام أن ينتصر على المؤامرة.
وبعد.. فهكذا كان ولاء محمد والمسيح للحياة..
وهكذا كان موقفهما مع السلام.
لقد حملا تبعات الوجود.. وأديا أمانة الحياة على نسق جد عظيم.
وعلى الطريق الذى سار عليه، لا تزال كلماتهما ترسل ضياء باهرًا، ولا تزال الدنيا تجد سكنية وأمنًا، فى كلمات المسيح.
«سلامًا، أترك لكم».. «متى ١٤: ٢٧».
وفى كلمات محمد: «كونوا عباد الله إخوانًا».