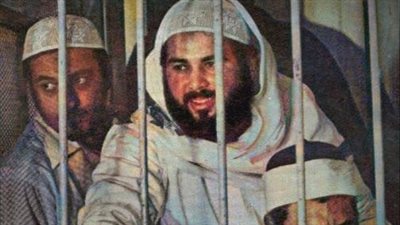غزوة هانى شنودة.. فصل من رواية «زمن سعاد»

سلمى فارس الأشمونى تتحدث
منذ أن تفتحت عيناى على الدنيا وأنا فى حالة حب مزمن، حتى كلية الطب التى يدخلها معظم الطلبة بحثًا عن المكانة والوجاهة الاجتماعية، أنا دخلتها عن حب وعشق للحياة، لكى أمنح قبلة الحياة لمريض غرق فى بحر الإحباط واليأس، أحببت أوراق شجر الخريف والكلاب البلدى والقطط البائسة والأطفال الذين يتسولون فى الإشارات، حتى أخى التوأم، طارق الذى تحول إلى سجان وموظف رقابة، واعتبر جسدى رهينة عنده، وبالرغم من أن فرق السن بيننا عشر دقائق كما أخبرتنى أمى، فقد كان يُشعرنى دومًا بأنه أكبر منى بعشر سنوات، بل أحيانًا عشرة قرون إلا أننى، ومع كل سخافاته، أحبه، لأنه ضحية، فعلى الرغم من أننا تربينا فى بيت واحد، فقد كان يقطن بيتًا آخر، هو حضن خديجة، وعقل خديجة، صار شخصًا غريبًا، يستحق الشفقة، كنت أتشاجر وأختلف معه، وأنا أصرخ من داخلى: «افهم بقى يا أخى أنت لا تمتلك كتالوج البنى آدمين ولا تحتكره، أنت لست إلهًا ولا تمتلك التوكيل من الشهر العقارى للجنة والفردوس، ليست معك نتيجتنا من الكونترول، افهم حرام عليك».

تفتحت عيناى على صور أمى فى الصالة وهى تتسلم الجوائز والدروع من الرئيس عبدالناصر، ووزير الثقافة ثروت عكاشة، وهى ما زالت على أعتاب الشباب، صورتها بالملاية اللف والجلابية المطرزة بخيوط القصب خلف فَرَاشَة فرقة رضا، فريدة فهمى، بصديرى وكاب البمبوطية وفساتين النوبة المزركشة، وهى ترنو إلى محمود رضا بإعجاب وغرام لا تخفيه وهو يقفز لمعانقة السحاب، أما غرفة النوم فهى ملك سعاد حسنى، تحتكرها السندريلا، حوائط غرفة نومها لا يظهر لون طلائها من خلف صور سعاد حسنى، بداية من «حسن ونعيمة» وهى ما زالت مراهقة ببشرة ناعمة كالحرير، حتى «الراعى والنساء» بتجاعيد الشجن تُوَسّد عينيها اللتين فقدتا الشغف.

أمى هى مخزن
أسرارى، وبالرغم من حبى لأبى، فإن سفره وبعده عنى جعل وقته فى مصر غير صالح للفضفضة، رؤيتى له مهمومًا مثقلًا بالحزن والخجل والانكسار وإحساس اللاجدوى، جعلنى أتجنب الشكوى ومصارحته بمشاكلى، لذلك عندما ولدت شرارة الحب بينى وبين أيمن، صارحتها على الفور، احتضنتنى حضن جوع للحب، حضن عطش للفهم، فرحت أكثر منى، لم أفسر وقتها وأنا محاطة بذراعيها القويتين ما سر تلك السعادة، لكننى فهمتها فيما بعد.
أيمن سليم جارنا، يقطن مع أسرته فى الدور الأخير، كنت أسمع عنه وعن تفوقه الدراسى كثيرًا، وكنت أسمع من أبى عن إعجابه بلوحاته التى كان يعرضها أيمن عليه ليأخذ رأيه الفنى فيها، كانت أمى تحكى لى عن المرحومة أمه التى رحلت فى عز شبابها، بصوتها الخفيض وجمالها الهادئ وقاموسها الذى لا يعرف كلمة نابية أو حتى لفظ تأفف أو تعبير غضب.
لم ألمح أبى تغمره السعادة كطفل، مثل اليوم الذى لمح فيه هذا الرجل الصاعد إلى شقة أيمن، سمعته يقول لأمى:
- لازم ألحقه بسرعة على السلم وأسلم عليه، ده أفضاله علينا كلنا.
سألتها عمن يكون هذا الرجل العجوز الرشيق، صاحب الابتسامة الحاضنة الحانية والشعر الخفيف الناعم الممشط بريشة فنان، قالت لى:
- دا الفنان العظيم حسين بيكار، قريب المرحومة أم أيمن، وكان أستاذ فارس فى كلية الفنون الجميلة.
بعد عودة أبى من لقائه السريع ببيكار، اقتربت منه فوجدت غلالة دمع تغلف حدقتيه، سألته أمى:
- مالك؟
- تخيلى بيكار كان محجوز فى القسم بيتحقق معاه عشان بهائى!
طب ما طول عمرنا عارفين إنه بهائى، إيه الجديد اللى خلاهم يكتشفوا فجأة إن البهائية دى جريمة؟! الرجل جميل وما يستحملش بهدلة.
- الجديد إن المجتمع اتغير، والناس ما عادتش طايقة ناس بره الباترون الجاهز.
كانت أول مرة أسمع كلمة بهائى، عرفتها من أيمن حين تشابكت أيدينا ونحن نحمل بلاطى المعمل البيضاء متجهين إلى قصر محمد على فى المنيل، وكما شممت رائحة الدخان فى معمل البيوكيمسترى، شممت رائحة الخطر على علاقتنا وأصابعنا المرتعشة تحاول العناق فالحب فى بلادى لا يتجاوز المياه الإقليمية للأديان، بيكار رسم ووثق نقل معبد «أبوسمبل»، وكتب الشعر وأصدر مجلة سندباد للأطفال، وعزف البزق وأحب الكون والكائنات، ولكن المجتمع لا يرحم ولا يسمح بالتحليق خارج السرب، وصمه بمجرد انتشار فيروس التصنيف والتمييز وامتداد سور الدين العظيم حول تفاصيل حياتنا، فما بالك بعلاقة حب أحد طرفيها بهائى مغمور، ليس فى شهرة بيكار، مجرد طالب متفوق فى كلية الطب، منتهى طموحه التعيين فى الجامعة والتدرج فى سلم الكادر الجامعى، الذى صار من ضمن شروطه خانة الديانة فى بطاقة الهُوية.
حاولتُ الخروج من خندق الكآبة التى خلقتها تلك المناقشة بينى وبينه حول مستقبل علاقتنا، قلت له:
- سمعت شريط فرقة المصريين الجديد؟
- طبعًا، تحفة.
- أنا اتفقت معاهم على حفلة من خلال أسرة الأمل، كلمت دكتور حسن البحراوى ووافق، وحياخد موافقة العميد بكره، وإنت معانا فى لجنة التحضير للحفلة.
- يا ستى بلاش أنا، كفاية إن مؤسس الفرقة مسيحى واسمه هانى شنودة، كمان تجيبى واحد بهائى يرتب الحفلة؟!
- ملكش دعوة إنت حتبقى حفلة تكسر الدنيا إن شاء الله.
توطدت العلاقة أكثر أثناء التحضير لحفلة المصريين، عبرت إلى الضفة الأخرى من شخصية أيمن هو ليس متفوقا فقط، أو «موس مذاكرة» و«دودة كتب»، كما هو الاسم الدارج للطلبة الأوائل، لكنه أيضًا شخص يمكن الاعتماد عليه، منظم، ومرتب، هادئ، وعنده رؤية شاملة لما يُقدِمُ عليه، لا يغرق فى التفاصيل مثلى، فتتعطل معه وعنده الأشياء، كنت أول مرة أسمع مصطلحات مثل نضع ١ Plan ولو لم تنفع نحول على ٢ plan، وكأننا نضع ترتيبات خطة عسكرية، كنا نجلس بعد المحاضرات مدة طويلة نحضر فى الدعوات والتذاكر وكتابة المخاطبات للجامعة وتحضيرات المسرح والصوت... إلخ، تفاصيل كثيرة جعلتنى أقترب أكثر ، وأتعلق أكثر، توارت كلمة البهائى إلى الخلف، وظهر فى مقدمة اللوحة عناق اثنين عاشقين، لمعة عيون مغرمة، بريق ابتسامة مطمئنة للاختيار الذى سيغزل خيوط المستقبل نبضات متسارعة أثناء حضن عابر، وقُبلة مسروقة. الغريب أن أيمن دائمًا كان الخائف المذعور، وكنت المطمئنة المتفائلة، سألنى عن إمكانية موافقة العائلة على الارتباط ببهائى، قلت له:
- أنا معرفش حاجة اسمها بهائى، أنا أعرف أيمن بس، وبعدين هو البهائى دا بتلات أرجل، ولا ناقص عين ولا ودن، ولا بيطلع نار من مناخيره.. ما هو بنى آدم زى أى بنى آدم.
- ما تضحكيش على نفسك، تقييم أى بنى آدم دلوقتى بالدين.
- قصدك باللى إحنا فاكرينه دين.
- ما تفرقش.
- لا تفرق، الدين حاجة، والتدين حاجة تانية، الدين ربنا، التدين بشر، بنى آدمين، وكل الأديان دى نسخ مختلفة لأصل واحد، وأفكارها كلها متشابهة، المهم مش طريقة صلاتك، المهم ضميرك، وإنت يا أيمن أجمل وأنقى ضمير قابلته.
- هل أهلك مقتنعين بالكلام دا؟
- معرفش ومش عاوزة أعرف كل اللى أعرفه إنى بحبك.
- وكل اللى مخوفنى إنى بحبك، وخايف على الحب دا.
كنت أصمت عندما يصل بنا النقاش إلى تلك النقطة، هل أصمت خوفًا، أم موافقة، أم توجسًا، أم انتظارًا؟ لا أعرف، لكن كل ما أعرفه أننى سأكون سعيدة مع أيمن أنا مقتنعة بالأسطورة الإغريقية التى جعلت كل كائن خُلق من نصفين، مهمة كل نصف أن يبحث عن نصفه الآخر، العاشق والمعشوق، مثل لعبة البازل، هذه التعرجات والفجوات لا يمكن تعشيقها ولا تلبيسها إلا فيما هو شبهها بالضبط وقد كنت متأكدة أن أيمن هو قطعة البازل فى كتالوج ولعبة حياتى المبهمة، لا يهمنى إن كانت هذه القطعة قد اكتسبت بصمة دينية مختلفة عنى، ليس ذنبى أن حيوانًا منويا لأب بهائى قابل بويضة لأم بهائية، فأنتجت جنينًا اسمه أيمن، فأنا كذلك نتاج هذا اللقاء العشوائى، اكتسبت منه ملامحى ولون شعرى وتجعيدته، ونبرة صوتى وطريقة مشيى، وأيضًا طريقة صلاتى، اكتسبت من هذا اللقاء دينى، فلماذا هذا النقاش العبثى والسؤال الأبدى؟ لماذا تخاف يا أيمن؟ لماذا نخاف من الحب والارتباط والحميمية كمفردات خارج الطبخة الاجتماعية؟ يأتينى صوت أيمن مخترقًا أذنى مثل طائرة نفاثة تخترق حاجز الصوت:
- لأننا فى مجتمع نعيش بشروطه، ولا نحتمل أن نكون منبوذين.
- لماذا منبوذون؟! وهل سيبنون مستعمرات للمحبين يعزلونهم فيها، خوفًا من العدوى مثل مستعمرات الجذام؟! نحن اثنان بالغان عاقلان، بيننا حب وفهم، سنستقل اقتصاديًا، ونتزوج، ما هى المشكلة؟ إجراء فى منتهى السهولة.
- ليس بتلك السهولة.
هكذا جاءنى الرد من أيمن حاول إفاقتى وسحب المخدر من دون الخوف من أعراض الانسحاب، حكى لى القصة وجسده يرتعش، وعيناه جاحظتان تغلفهما غلالة دموع شفافة أكاد أطل منها على سراديب روحه، صوته كانت فيه غصة، وبالرغم من كل التفاصيل المؤلمة التى حكاها، لم يكن به غل أو سواد.

حكى لى عن أسوار المستحيلات فى علاقتنا، أبرز فى البداية بطاقته الشخصية، لا يريدون الاعتراف بكلمة بهائى فى البطاقة، منتهى أملنا كطائفة الآن، ما داموا مُصرّين على خانة الديانة، أن يضعوا أمامها علامة شرطة، خطًا أفقيًا يعبر عن فراغ أو عدم اعتراف، أو عدم اكتراث، أكثر مما يعبر عن معنى أو عقيدة، علمت فيما بعد أن المحكمة وافقت على أن تضع الشرطة، الخط الأفقى فى خانة الديانة، أخبرنى بأن قريبه بيكار كانت بطاقته القديمة فيها كلمة بهائى من دون غضاضة ولا استهجان، تهدج صوته وهو يحكى:
- أبى لكى يستطيع أن ينفق علينا ويستكمل رحلة الحياة ويحصل على ميراثه، اضطر لأن يخفى هويته الدينية فى الأوراق الرسمية فميراث البهائى هباء، والزوجة البهائية لا ترث زوجها، وأمى أصرت على إعلان هويتها، وسُجلت فى البطاقة آنسة طبقًا للقوانين حتى لا ترث، تلك التفاصيل لم أشعر بها كثيرًا يا سلمى، لكنها تراكمت كلها لحظة وفاة أمى، لحظة البحث عن مدفن لها، فنحن محرومون، كطائفة، من بناء مدافن، محرومون من مواراة جثثنا، نلاحق ونحن أحياء ونطارد ونحن موتى، رفعوا فى وجه أبى حيثيات الحكم بـ «أنه يتعين إعلاء مصلحة المجتمع على الأفراد، لأن العقيدة البهائية مخالفة للنظام العام الذى يقوم فى أساسه على الشريعة الإسلامية»، ردد أبى النص البهائى من الذاكرة وهو يبكى: «حُرّم عليكم نقل الميت أزيد من مسافة ساعة من المدينة، ادفنوه بالروح والريحان فى مکان قریب»، كنا وقتها فى الإسكندرية، أخبرونا أنه من المستحيل دفنها هناك، كما أنه لا يوجد لها مقبرة فى محيط المليون كيلو متر مربع، لأنه، ووفقًا لفتوى شرعية، غير مسموح لها بأن تدفن فى مقابر المسلمين، الوطن الذى أسكنته أمى قلبها، لا تستطيع جثتها أن تسكن ترابه، تسلل أبى قبل الفجر، كفن أمى فى خمسة أثواب من الحرير، دفن جثتها تحت شجرة ليمون فى حديقة يملكها أحد أقاربنا، كانت تحب عطر شجر الليمون، إنها الآن فى عصارة تلك الشجرة، تسللت من الجذور، تسربت إلى الساق واللحاء، أزهرت ليمونًا يفوح بعطر الحياة وعصارة الأمل.
ظل يبكى بعد نهاية حكايته، تركته يبكى، أخذته فى حضنى كطفل برغم لزوجة النظرات المحيطة بنا، احتضنته واحتويته كرحم، استكان وتكوّر كجنين.
حاولت إزاحة هذا الموضوع الشائك جانبًا بالاستغراق فى موضوع آخر، تذكرت حكاية توفيق الحكيم التى قرأتها فى كتابه «يوميات نائب فى الأرياف» عن جثة الغريق التى يزيحونها من ترعة القرية لتكون تحت مسئولية نيابة أخرى فى منطقة أخرى! قمت بتلك الإزاحة وأغرقت أيمن فى قصة تحضيرات الحفلة؛ تجمعنا يوم الحفلة صباحًا عند نافورة الكلية، بعدما وضعنا الآلات الموسيقية فى خلفية المسرح، جهزنا قاعة الاحتفالات، خرجنا لنتناول السندوتشات، أشار أيمن إلى جهة باب الكلية بانزعاج:
- شايفة يا سلمى فى طلبة كلهم ملتحين داخلين من باب الكلية شكلهم غريب ما شفتهمش قبل كدا فى الكلية.
- فعلًا، غريبة! والأمن فين؟ دول مجموعات، والغريب إنهم كلهم متجهين لقاعة الاحتفالات.
بدأ عدد الوافدين على الكلية يزداد، وفجأة وجدنا بعض الطلبة من زملائنا يوزعون المنشورات فى المدرجات وفى ساحة الكلية والكافيتريا، بل وفى داخل طرقات المستشفى، المنشور مكتوب فيه:
«بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله الذى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، محمد ﷺ.
أخى المسلم، أختى المسلمة، لقد انتشر فى زماننا هذا الغناء والرقص، وأصبح الكثير يتهاون فيهما، رغم أن الشرع قد نهى عن ذلك لما فيه من الفتنة وإبعاد القلب عن ذكر الله. قال الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (لقمان: ٦). وقد فسَّر كثير من العلماء لهوَ الحديث بأنه الغناء وما يشمله من آلات اللهو، كما قال رسول الله ﷺ: «ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحِرَّ والحرير والخمر والمعازف» (رواه البخارى) وهذا يدل على أن المعازف والغناء من الأمور التى تُحرَّم، ولكن سيأتى زمان يستحلها الناس مع كونها حرامًا فى الأصل.
وحذرنا النبى ﷺ من اتباع الشهوات والغفلة، فقال: «ليكونن على آخر أمتى رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن معلونات» (رواه أحمد).
الزملاء طلبة كلية طب القاهرة، لا تجعلوا الدنيا تلهيكم عن الآخرة، هانى شنودة (كتبوها بهذا الفونت الكبير الغليظ) وفرقته لن يكونوا معكم فى القبر وأنتم تُسألون وتعذبون، لن يصحبوكم على الصراط، لن يتحملوا عنكم نار السعير ، ابتعدوا عن الغناء والرقص فإنهما يُضيّعان القلب ويشغلانه عن ذكر الله، ويجران إلى الفتنة والضلال.
نسأل الله أن يهدينا جميعًا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الغناء حرام
تحذير للشباب اتقوا الله
ذكر الله خير
شنودة طريقكم إلى جهنم وبئس المصير
عاش الرئيس المؤمن محمد أنور السادات
الجماعة الإسلامية
جامعات مصر».
ارتعدتُ وأنا أقرأ المنشور، كانت ألسنة اللهب تتصاعد من كلماته، وكأننى أسمع فحيح الثعبان الأقرع الذى كان مدرس الدين يحكى لنا عنه فى المدرسة، إذا كان تأثير مثل تلك الورقة على بهذا الشكل، وأنا من ضمن منظمى الحفل، فما الذى ستفعله بالطلبة الآخرين، أيمن كان هادئًا ومسيطرًا على أعصابه، كان يسمع المنشور وهو مطرق إلى الأرض، ممسك بفرع شجرة يكتب بها على الأرض: «المصريين» بحروف مرتبكة.
- لازم نفكر بهدوء وعقل، من الواضح إن فيه طلبة من الجماعة جاءوا من كليات مختلفة، ومحافظات مختلفة، وعندهم إصرار على إفساد الحفلة.
- أو يلغوها.
- دا أكيد المنشور لغته كلها تهديد وغل، والتصرف لازم يبقى حكيم، الأمن مش معانا، لازم نقنعهم بالأدب.
- هما دول ينفع معاهم عقل أو إقناع أو أدب، دول حافظين مش فاهمين.
- ندخل القاعة نشوف إيه الأول، وبعدين نتصرف.
اتجهنا إلى القاعة، وجدنا زحامًا شديدًا، فى جوانب القاعة توزعت طلبة يتميزون جميعًا بضخامة الجثة! وفى المنتصف وقفت صفوف المصلين تركع وتسجد من كثرة الركعات نسينا العدد، سألنى أيمن:
- هو فيه صلاة تراويح دلوقتى؟! مش شهر رمضان خلص ولا أنا بيتهيألى.
کتمت الضحكة، وتلفّت حولى خوفًا من أن يكون قد سمعنا طالب من الجماعة، فجأة وجدت أيمن يصعد إلى خشبة المسرح، ويمسك بالميكروفون، ويبدأ فى الحديث:
- زملائى وأحبائى، النشاط اللى بتعمله أسرتنا النهارده، نشاط كله بهجة وفرح، ما فيهوش أى نوع من الموبقات أو التجاوز أو الرذيلة، إحنا بنخاف على زميلاتنا زى إخواتنا بالظبط، وكلنا عارفين ربنا ...
عند تلك الكلمة صرخ صوت من آخر القاعة:
- هو إنت تعرف ربنا يا كافر، ما عادش إلا إنت اللى تكلمنا عن ربنا يا زندیق.
وكأنها إشارة الهجوم؛ لكمات وركلات، حتى من الزميل الذى كان يشرب معك العصير أمس فى الكافيتريا، وتعطيه كشكول المحاضرات لينقل منه ما فاته من دروس يضربك بكل غل وعنف وقسوة، صعدوا إلى المسرح، حطموا كل الآلات الموسيقية، وكأنهم فى غزوة، كان أكثرهم حماسًا من اتهم أيمن بالكفر والزندقة، عندما استدار منتهيًا من مهمته المقدسة وواجهنى، رأيته، حدقت فيه، لم أصدق، كتمت صرختى:
- معقول... طارق!