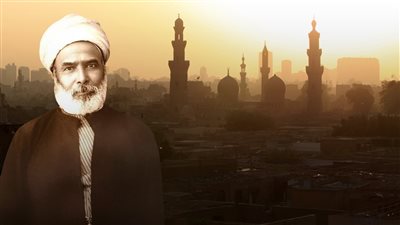رئيس المكاشفين.. الإشارات والتهويمات فى تفسير القرآن لابن عربى

- ابن عربى اتهم بأنه يسعى إلى إحداث اضطراب فى سياسة الدولة
- كان ابن عربى يعرف لوالده قدره ويدلنا على ذلك أنه تعامل معه على أنه من أولياء الله الصالحين
- لم يختلف الباحثون قديمًا وحديثًا حول شىء قدر اختلافهم حوله
- ما تركه خلفه كثير وهو ما جعله ليس الشيخ الأكبر ولكنه رئيس المكاشفين فقد كشف الله له ما لم يكشفه لغيره
هو رجل واحد..
لكن الرأى فيه ليس كذلك.
يقولون إذا اختلفت الآراء فى شخص ما ضاعت حقيقته.
ورغم أن الآراء تعددت واختلفت وتناقضت وتباينت وتقاربت وتباعدت فى الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى، فإن هذا الاختلاف زاده قيمة وثباتًا ورسوخًا وتأثيرًا، فهو العالم العابر للقرون.
من فرط الإعجاب به لدى مريديه، ومن فرط النفور منه لدى شانئيه، لا يمكنك أن تفصل بين ما هو حقيقى فى سيرته.. وما هو أسطورى مخترع.
فقد نسبوا له كل شىء.. ومن بين ما وضعوه بين يديه تفسيرًا للقرآن، قالوا ما فيه من آيات الإعجاب، ورفعوه على التفسيرات الأخرى، فقد جاء فيها بما لم يأتِ به من سبقوه ومن لحقوا به.
كعادتى لا تشغلنى الأساطير.
كل ما أحاوله أن أصل إلى الحد الأدنى من الحقيقة، ليس عن تفسير ابن عربى للقرآن فقط، ولكن عن محيى الدين نفسه.
ولد ابن عربى فى 28 يوليو 1165.
عمره الذى عاشه يصل إلى 75 عامًا، فقد توفى فى العام 1240.
أما عمره الذى لا يزال يعيشه حتى الآن فيصل إلى 860 عامًا.
لم يتوقف ابن عربى خلال هذه القرون عن إثارة الجدل والخيال حول ما قاله وما قدمه، وما كتبه وما عاشه أيضًا.
وقد تسأل: لماذا ينفرد الشيخ الأكبر بكل هذا الصخب؟
لماذ كان محط كل هذا الاهتمام فى الشرق والغرب؟
ولماذا لا تزال تصدر عنه الكتب؟
ولماذا تحول إلى مصدر إلهام للباحثين والمبدعين والهائمين على وجوههم؟
فى تصورى أن هناك عوامل كثيرة صاغت شخصيته، وأسهمت فى تشكيل هويته، وهى عوامل اختلط فيها الواقعى بالخيالى، تداخلت الرؤى والنبوءات والمواجهات والصداقات والرحلات فى صياغته، فأصبح ما هو عليه، ولم يرحل من حياتنا إلا بعد أن وضع ما يقرب من 800 كتاب، لم يبقَ منها إلا ما يقرب من 100 كتاب فقط.

بدايات تشكيله تعود إلى طبيعة العائلة التى ولد لها.
فهو أبوبكر محيى الدين محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عربى، الحاتمى الطائى الأندلسى.
والده كان ينتمى إلى قبيلة « طىء» العربية، خدم فى جيش حاكم « مرسية» ابن مردنيش الذى توفى فى نهايات العام ١١٧٢، وبعدها تحول إلى خدمة سلطان الموحدين أبويعقوب يوسف الأول، لينتقل بأسرته من «مرسية» إلى «إشبيلية» وكان عمر ابن عربى وقتها سبع سنوات.
لم يكن الأب محاربًا فقط، بل كان من أئمة الفقه والحديث، وعرف بأنه من أعلام الزهد والتقشف، وهو ما دفعه إلى أن يربى ابنه تربية دينية، فبمجرد قدرته على النطق أرسله إلى أبى بكر بن خلف عميد الفقهاء فى «إشبيلية» ليقرأ عليه القرآن، وقبل أن يتم العاشرة من عمره كان ملمًا بالقراءات السبع، ولما انتهى من القرآن جلس إلى رجال الحديث والفقه ليتعلم أصولهما.
كان ابن عربى يعرف لوالده قدره، ويدلنا على ذلك أنه تعامل معه على أنه من أولياء الله الصالحين.
فى كتابه «الفتوحات.. أحوال الأولياء بعد مماتهم» يحدثنا عن أبيه.
يقول: من كان عبدًا خالصًا لربه فى الأولى، كان فى الثانية ملكًا له جاهه وسيادته، ومن كان معرضًا زاهدًا فى مظاهرها، فلا يحجبه الموت ولا ينال منه الفناء عند صعود روحه إلى خالقها، فمن صفات صاحب هذا المقام أن من ينظر فى وجهه وهو ميت يقول: حى، ولقد رأيت من والدى رحمه الله ذلك، فإنا دفناه على شك مما كان عليه فى وجهه من صورة الأحياء، ومما كان عليه من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأموات، وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يومًا أخبرنى بموته، وأنه يموت يوم الأربعاء.
وفى صغره تأثر ابن عربى بأحد أعمامه، وكان اسمه يحيى الذى كان رغم ثرائه الشديد، وتوليه منصب أمير مدينة تلمسان، فإنه تخلى عن ثروته ومنصبه، واختار أن يكون متصوفًا عازفًا عن الدنيا وما فيها.
فى صباه كانت الإشارة الأولى، كما يقول الرواة، فقد مرض مرضًا شديدًا، وأحاطت به الحمى حتى رجت جسده رجًا، وبينما هو يعانى ما بين اليقظة والنوم إذ به يرى أشباحًا شريرة تحيط به من كل جانب، فبدأ يستغيث منها، وإذ برجل قوى مشرق الوجه، يصد عنه تلك الأرواح الشريرة ويفرقها بعيدًا عنه، سأله محيى: من أنت؟ فقال: أنا سورة يس.
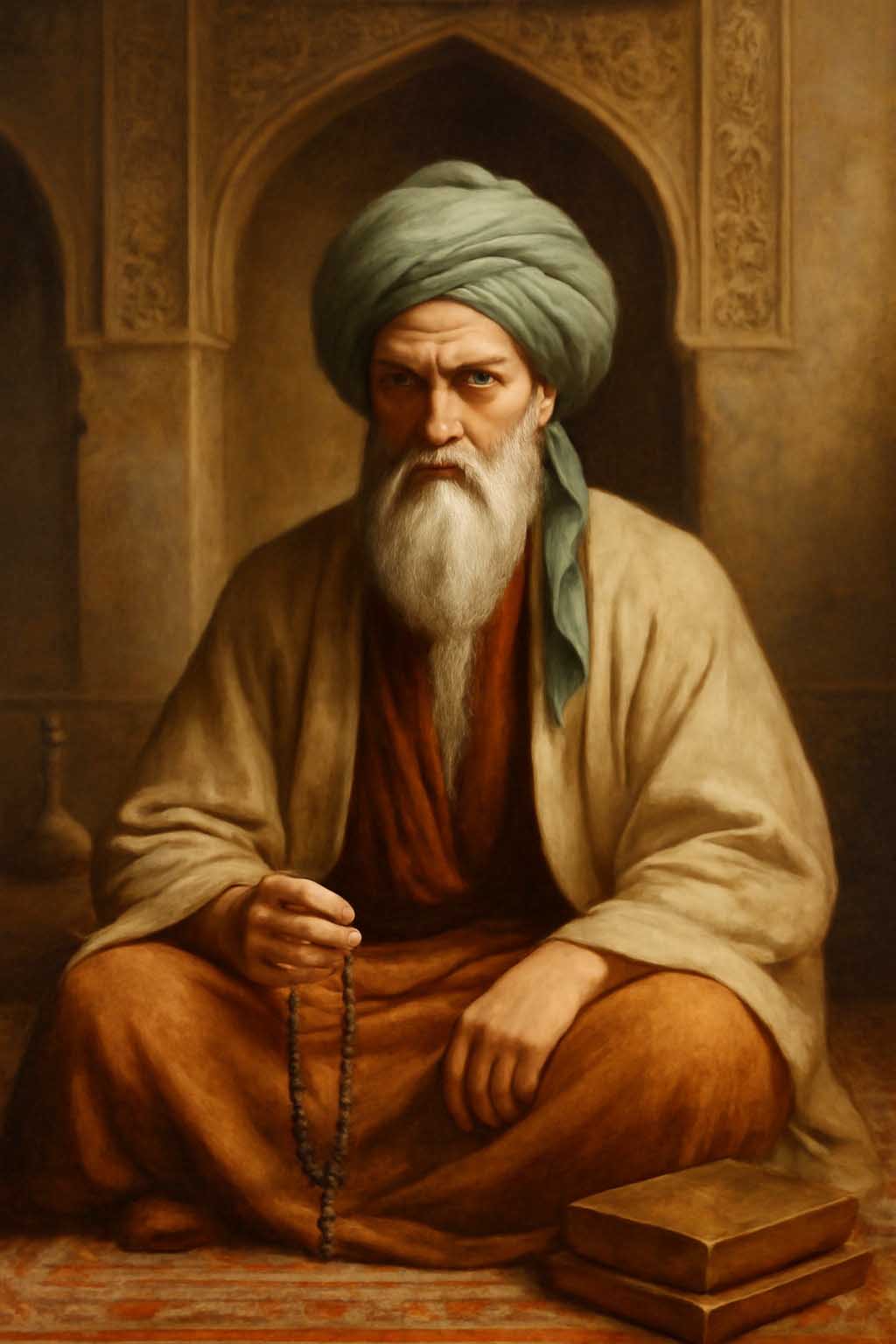
ولما استيقظ ابن عربى وجد والده جالسًا بجواره يقرأ سورة يس وقد وضع يده على رأسه، وبعد قليل شفى من الحمى التى عانى منها، ووقتها أدرك أن الله أرسل إليه إشارة بأنه اصطفاه ليكون واحدًا من القادة الروحيين لهذا العالم، فقرر أن يسير فى الطريق إلى منتهاه.
بعد هذه الرؤية تردد ابن عربى على إحدى مدارس الأندلس التى تعلم سرًا مذهب «الأمبيذوقلية»، وهو مذهب مفعم بالرموز والإشارات والتأويلات الموروثة عن الفيثاغورية والأورفيوسية والفطرية الهندية، وكانت هذه المدرسة هى الوحيدة التى تدرس لتلاميذها المبادئ الخفية والتعاليم.
فى التعريف به بمقدمة كتابه «الفتوحات المكية» يقول محققه أحمد شمس الدين: لم يكد ابن عربى يختم الحلقة الثانية من عمره حتى كان قد انغمس فى أنوار الكشف والإلهام، ولم يشارف العشرين حتى أعلن عن أنه جعل ليسير فى الطريق الروحانى بخطوات واسعة ثابتة، وأنه بدأ يطلع على أسرار الحياة الصوفية، وأن عددًا من الخفايا الكونية قد تكشف أمامه، وأن حياته منذ ذلك العهد المبكر لم تعد سوى سلسلة من البحث المتواصل عما يحقق الكمال لتلك الاستعدادات الفطرية التى تنير أضواؤها جوانب عقله وقلبه، ولم يزل عاكفًا على ذلك النشاط الروحانى حتى ظفر بأكبر قدر من الأسرار، ولم تكن آماله فى التغلغل إلى تلك الأسرار وبحوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حد، لأنه أيقن أنه مؤمن بمبادئ حقيقة أزلية مرت بجميع الأزمان الكونية، وطافت بكل الأجناس البشرية متممة ما فيها من نقص وقصور، وأنها جمعت كل الروحانيات فى الوحدة الفطرية التى تتمثل من حين إلى آخر فى صور تنسكية رفيعة تبدو على مسرح الإنسانية ردحًا من الزمن ثم تختفى، ولا يدرك حقيقتها إلا القليلون.
كان ابن عربى منفتحًا على كل وأى شىء يتعلق بإعداده الروحى.

يقول أحمد شمس الدين: عندما كان فى قرطبة تكشف له من أقطاب العصور البائدة عدد من حكماء الهند وفارس والإغريق كفيثاغورس وأمبيذوقليس وأفلاطون، ومن إليهم ممن ألقيت على كواهلهم مسئولية القطبية الروحية فى عصورهم المتعاقبة قبل ظهور الإسلام، وهو ما جعله شغوفًا بأن يطلع على جميع الدرجات التنسكية فى كل الأديان والمذاهب عن طريق أرواح رجالها الحقيقيين بهيئة مباشرة، وبصورة مؤسسة على الشرف العلمى الذى يحمل الباحث النزيه على الاعتماد عليه دون أدنى تردد أو ارتياب.
جاء ابن عربى إلى مصر دارت بينه وبين بعض الأمراء الموحدين مجادلات عنيفة وتعرض لمكائد ودسائس قوية ليلتقى بمجموعة من الصوفية الذين يطبقون حياة تنسكية قوية محافظة
هذا التكوين الروحى جعل ابن عربى يقف أمام اختيار طريق من طريقين:
الأول، طريق التيار العام وفيه يتقيد فى جميع أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وحركاته وسكناته بحرفية الدين التى لا روح فيها ولا حياة ولا سر ولا رمز ولا تأويل، وفى هذا الطريق تختفى شخصيته الحقيقية وتفشل رسالته الطبيعية.
والثانى، طريق فطرته فيترك لعقله حرية الانطلاق ولقلبه حرية التصرف.
اختار ابن عربى الطريق الثانى، وكانت النتيجة الطبيعية أن يصطدم وبعنف مع أهل الحل والعقد، وهو ما حدث بالفعل، فقد دارت بينه وبين بعض الأمراء الموحدين مجادلات عنيفة، وتعرض لمكائد ودسائس قوية، جرت عليه اتهامات ليست دينية فقط ولكن سياسية أيضًا، فقد اتهم بأنه يسعى إلى إحداث اضطراب فى سياسة الدولة.
قرر ابن عربى أن يرحل.
لكن قبل الرحيل كان لا بد له من إشارة، فهو رجل لا يتحرك إلا بالإشارات، أو هكذا أراد لنا أن نصدق.
وجاءت الإشارة بالفعل.. فى هذا الوقت المضطرب رأى فى حالة اليقظة، كما يدعى مترجموه، أنه يقف أمام العرش الإلهى المحمول على أعمدة من لهب متفجر، وإذ به يرى طائرًا جميلًا بديع الصنع يحلق حول العرش ويصدر إليه الأمر بأن يرحل إلى الشرق، ويخبره بأنه سيكون مرشده السماوى.
يحمل ابن عربى متاعه ويرحل إلى الشرق.
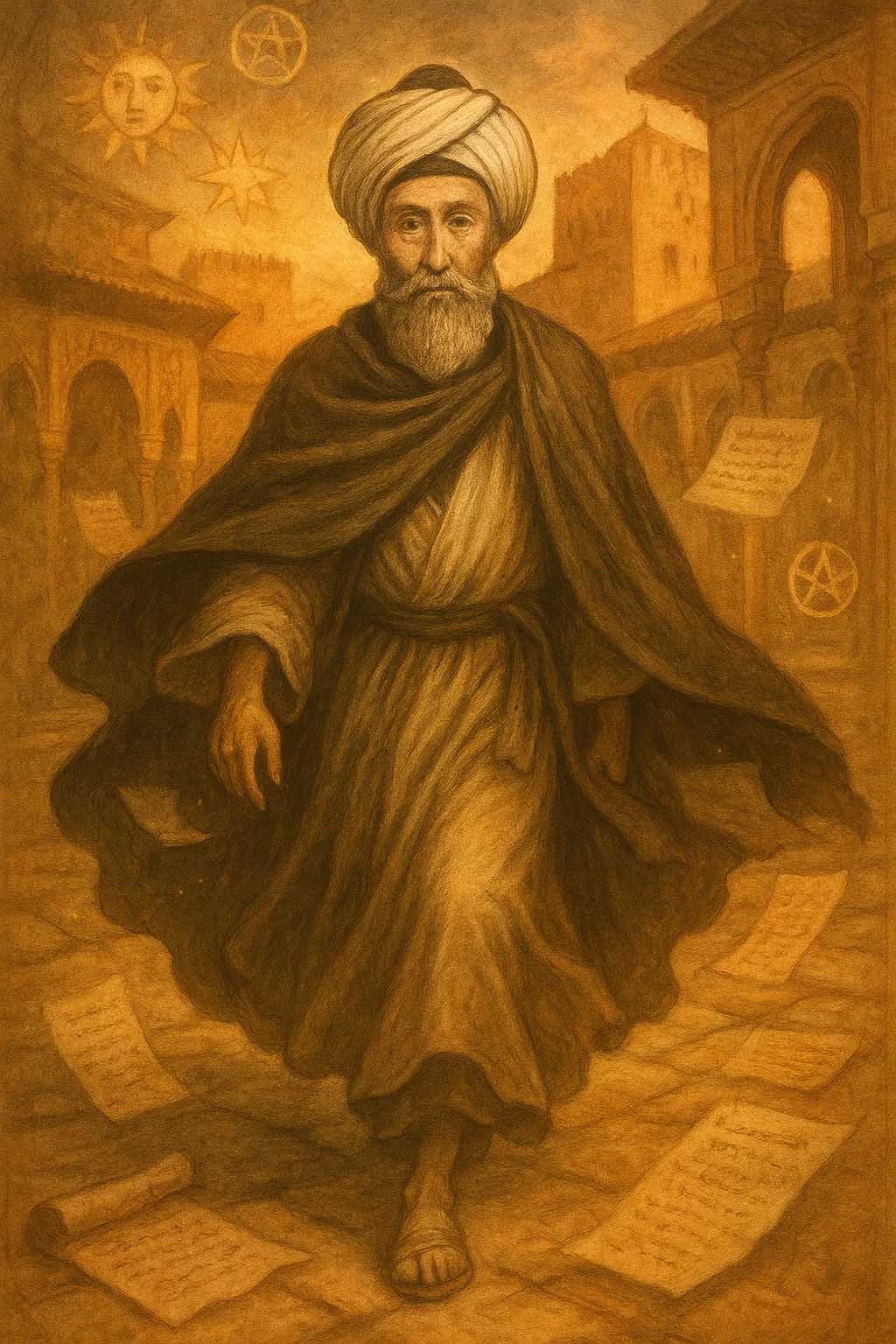
كانت محطته الأولى هى مكة، حدث هذا فى العام ١٢٠١ وهناك سطعت مواهبه العقلية والروحية، وفى إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة يظهر له مرشده السماوى، ويأمره بوضع كتابه «الفتوحات المكية»، وهو الكتاب الذى ضمنه أكثر وأهم آرائه الصوفية والعقلية ومبادئه الروحية.
فى مفتتح كتابه «الفتوحات المكية» يقول: هذا هو المقام المحمدى الأطهر، من رقى فيه فقد ورثه، وأرسله الحق حافظًا لحرمة الشريعة وبعثه، ووهبت فى ذلك الوقت مواهب الحكم، حتى كأنى أوتيت جوامع الكلم، فشكرت الله عز وجل وصعدت أعلاه، وحصلت فى موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم ومستواه، وبسط لى على الدرجة التى أنا فيها كم قميص أبيض، فوقفت عليه، حتى لا أباشر الموضع الذى باشره، صلى الله عليه وسلم بقدميه، تنزيهًا له وتشريفًا، وتنبيهًا لنا وتعريفًا، أن المقام الذى شاهده من ربه، لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه، ولولا ذلك لكشفنا ما كشف، وعرفنا ما عرف، ألا تقفوا أثره لتعلم خبره؟ لا تشاهد من طريق سلوكه ما شهد، ولا تعرف كيف تخبر بسلب الأوصاف عنه، وهنا سر خفى إن بحثت عليه، وصلت إليه، وهو من أجل أنه إمام، وقد حصل له الإمام، لا يشاهد أثرًا ولا يعرفه، فقد كشفت ما لا يكشفه، وهذا المقام قد ظهر، فى إنكار موسى، صلى الله على سيدنا وعليه وعلى الخضر، فلما وقفت ذلك الموقف الأسنى، بين يدى من كان من ربه ليلة إسرائه قاب قوسين أو أدنى، قمت مقنعًا خجلًا، ثم أيدت بروح القدس، فافتتحت مرتجلًا:
يا منزل الآيات والأنباء.. أنزل على معالم الأسماء
حتى أكون لحمد ذاتك جامعًا.. بمحامد السراء والضراء.
يقول ابن عربى عن الفتوحات المكية: الأغلب فيما أودعته هذه الرسالة ما فتح الله به علىّ عند طوافى ببيته المكرم، أو قعودى مراقبًا له بحرمه المشرف المعظم.
ويضيف: كما تتفاضل المنازل الروحانية كذلك تتفاضل المنازل الجسمانية، وقد تجد قلبك فى مسجد أكثر مما تجده فى غيره من المساجد، فالملائكة تعمر جميع الأرض، وأعلاهم مرتبة وأعظمهم علمًا ومعرفة عمرة المسجد الحرام، وعلى قدر جلسائك يكون وجودك، فإن لهم الجلساء فى قلب الجليس تأثيرًا، وهمهم على قدر مراتبهم، وقد طاف بالبيت مائة ألف نبى وأربعة وعشرون ألفًا سوى الأولياء، وما من نبى ولا ولى، إلا وقد ترك همته متعلقة به، لأنه البيت الذى اصطفاه الله على سائر البيوت.
ومن مكة إلى الموصل، وفى العام ١٢٠٤ يرحل ابن عربى ليلتقى هناك شيخه الصوفى الكبير على بن عبد الله بن جامع، الذى يقولون عنه إنه تلقى لبس الخرقة البالية عن سيدنا الخضر مباشرة، وهو من ألبس ابن عربى إياها، فجعل منها ملبسه بعد ذلك.
وفى العام ١٢٠٦ يأتى ابن عربى إلى القاهرة ليلتقى بمجموعة من الصوفية الذين يطبقون حياة تنسكية قوية محافظة.
ورغم قربه منهم وقربهم منه فإنهم لم يصبروا عليه.
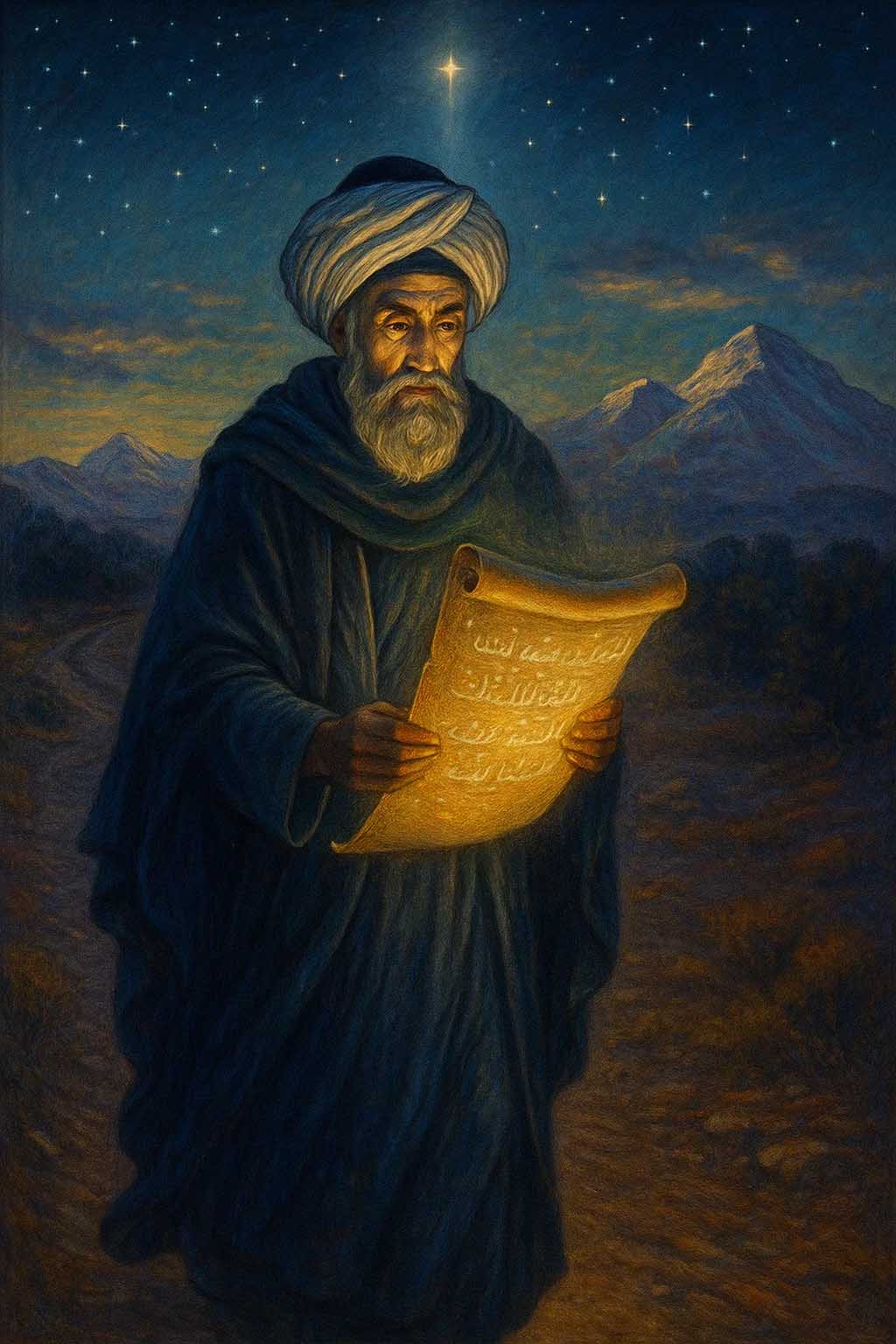
قضى ابن عربى عامًا واحدًا فى القاهرة، جاءه فى أوله مرشده السماوى وألقى فى قلبه مزيدًا من الإشارات والرموز التى أضافها إلى مذهبه، ولما حدث رفاقه بها وعرف بها بعض الفقهاء لفظوه وتنمروا عليه وسخروا منه، وكاد يقضى عليه لولا أن أخرجه أحد أصدقائه من مصر سالما، ليعود فى العام التالى مباشرة ١٢٠٧ إلى مكة.
ثلاث سنوات يقضيها فى مكه فى تأمل وتلقى لمزيد من الإشارات، وبعد ذلك يقرر أن يرحل إلى «قونية» بتركيا، وهناك استقبله أميرها السلجوقى فأكرمه وأحسن منزله.
لا يصبر ابن عربى على البقاء فى «قونية» كثيرًا، يقضى فيها عامًا واحدًا، يتوجه بعده إلى أرمينيا ومنها إلى بغداد فى العام ١٢٠١١، وهناك يلتقى بصاحب الإشراق شهاب الدين عمر السهروردى الذى يظل إلى جواره ثلاثة أعوام، ولما سألوا السهروردى عنه قال: هو بحر الحقائق.
يعود بعد ذلك إلى مكة محطته الأولى فى الشرق، لكنه هذه المرة يجد فيها ما لا يسره، وكان سبب الاضطراب امرأة اسمها نظام.
أما من هى «نظام» فهذه قصة خاصة ومؤثرة فى حياة ابن عربى.
فى نزوله الأول إلى مكه قابل شيخًا إيرانيًا اسمه أبى شجاع بن رستم الأصفهانى، وبين بنات أسرته كانت هناك فتاة تسمى «نظام» وجد فيها محيى الدين ما يريده من محاسن جسمية وميزات روحية، تزوجها وأخذ منها رمزًا ظاهريًا للحكمة الخالدة، وكتب فيها ديوانًا كاملًا.
الديوان كان اسمه «ترجمان الأشواق» ويحدثنا ابن عربى عن ظروفه نظمه.
يقول: إنى لما نزلت مكه ألفيت بها جماعة من الفضلاء، وعصابة من الأكابر الأدباء والصلحاء بين رجال ونساء، ولم أرَ فيهم مع فضلهم مشغولًا بنفسه، مشغوفًا فيما بين يومه وأمسه، مثل الشيخ العالم الإمام بمقام بمقام نزيل مكة البلد الأمين مكين الدين أبى شجاع بن رستم بن أبى الرجا الأصفهانى، وأخته المسنة العالمة شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم.
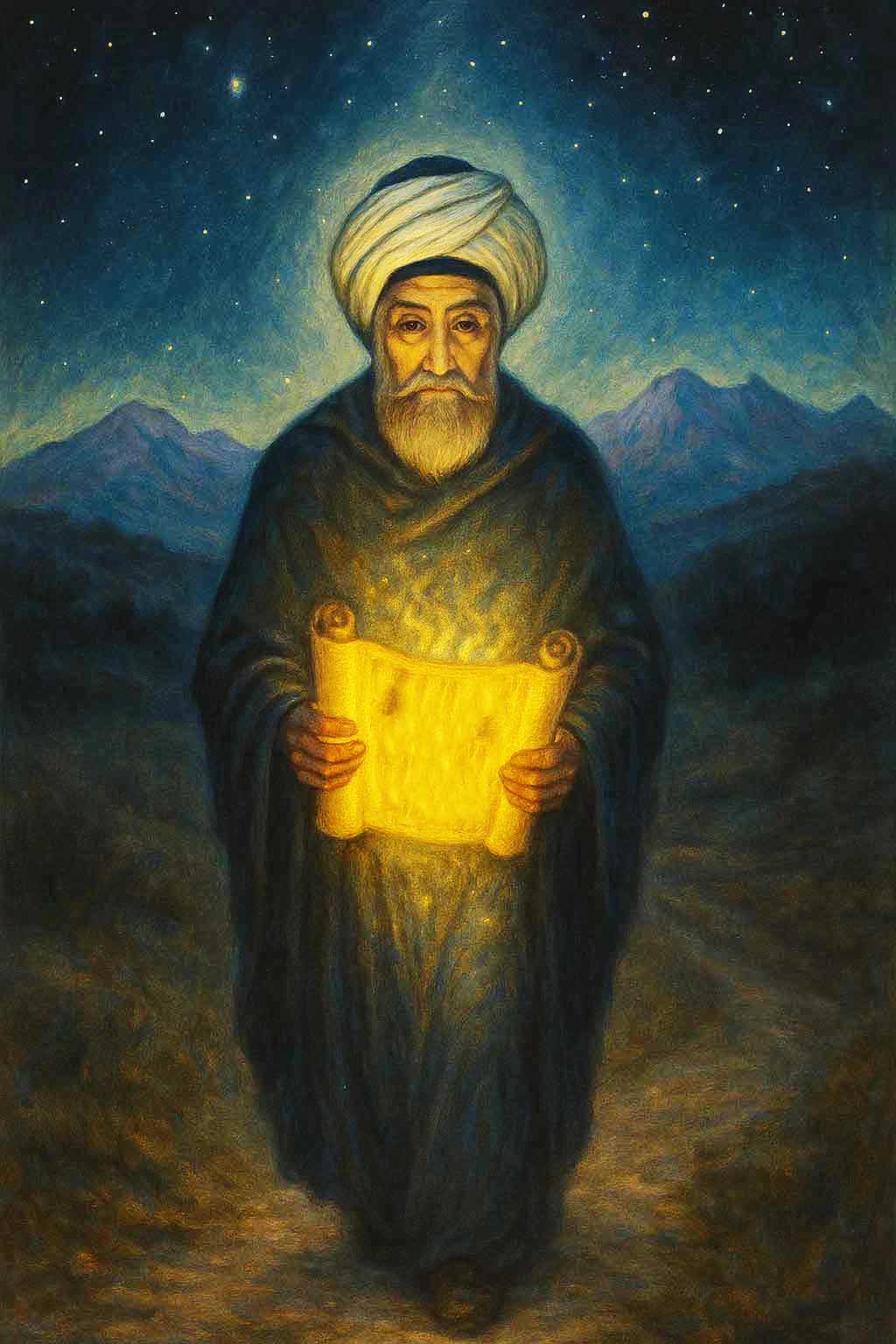
ويضيف ابن عربى: ومن بين جماعة الفضلاء الذين كانوا يرتادون دار تلك العائلة الفارسية المستقرة فى مكه، تبدو صورة نورانية متميزة غاية التميز، وكان لهذا الشيخ بنت عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وتزين المحاضر وتحير المناظر، تسمى بالنظام، وتلقب بعين الشمس والبهاء، من العابدات العلمات السائحات الزاهدات، شيخة الحرمين، وتربية البلد الأمين الأعظم بلا مين، ساحرة الطرف، عراقية الظرف، إن أسهبت أتعبت، وإن أوجزت أعجزت، وإن أفصحت أوضحت، إن نطقت خرس قس بن ساعدة، وإن كرمت خنس معن بن زائدة، وإن وفت قصر المسؤال خطاه، وأغرى بظهر الغرر وامتطاه، ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض، السيئة الأغراض، لأخذت فى شرح ما أودع الله فى خلقها من الحسن، وفى خلقها الذى هو روضة المزن، شمس بين العلماء، بستان بين الأدباء، حقة مختومة، واسطة عقد منظومة، يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابغة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، شريفة ناديها، مسكنها جياد، وبيتها من العين السواد، ومن الصدر الفؤاد، أشرقت بها تهامة، وفتح الروض لمجاورتها أكمامه، فنمت أعراف المعارف، بما تحمله من الرقائق واللطائف، علمها عملها، عليها مسحة ملك وهمة ملك.
ويقول ابن عربى عما قاله فيها فى ديوانه: فقلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق، وعبارات الغزل اللائق، ولم أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس، ويثيره الأنس، من كريم ودها، وقديم عهدها، ولطافة معناها، وطهارة مغناها، إذ هى السؤال والمأمول، والعذراء البتول، ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق، من تلك الذخائر والأعلاق، فأعربت عن نفس تواقة، ونبهت على ما عندنا من العلاقى، اهتمامًا بالأمر القديم، وإيثارًا لمجلسها الكريم.
ويضيف محيى الدين: كل اسم أذكره فعنها أكنى، وكل دار أندبها فدارها أعنى، ولم ألُ فيما نظمته على الإيماء إلى الواردات الإلهية، والتنزلات الروحانية، والمناسبات العلوية، جريًا على طريقتنا المثلى، فإن الآخرة خير لنا وأبقى، ولعلمها رضى الله عنها بما إليه أشير «ولا ينبئك مثل خبير»، والله يعصم قارئ هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، والهمم العلية، المتعلقة بالأمور السماوية.. آمين بعزة من لا رب غيره والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.
تتمثل أهمية ابن عربى فى حقيقة أنه يمثل همزة الوصل بين التراث الصوفى والفلسفى السابق عليه كله وبين كل المفكرين الذين جاءوا بعده والذين لم يكد ينجح واحد منهم فى تجاوز تأثير فلسفته
عندما عاد ابن عربى إلى مكة كان قد مر على رحيله عنها ثلاثة عشر عامًا، وكان خبر ديوانه فى مدح « نظام» قد وصل إلى فقهاء مكه، فوجدهم يشوهون صورته ويسئيون إليه ويطاردونه بما قاله فيه، لكنه واجههم وبيّن زيفهم، فهو لم يتجاوز فى وصفها، ورغم أنهم رحبوا به فإنه يخرج من مكة إلى حلب ومنها إلى دمشق التى يموت فيها فى العام ١٢٤٠.
قد تكون لابن عربى هذه الأهمية الروحية، لكن للرجل أهميته العلمية، وهو ما يطلعنا عليه نصر حامد أبوزيد فى دراسته الجرئية والمقتحمة «تأويل القرآن عند محيى الدين بن عربى».
يجيب نصر أبوزيد عن السؤال الذى يردده الجميع وهو: لماذا يحتل ابن عربى تحديدًا كل هذه المكانة؟.
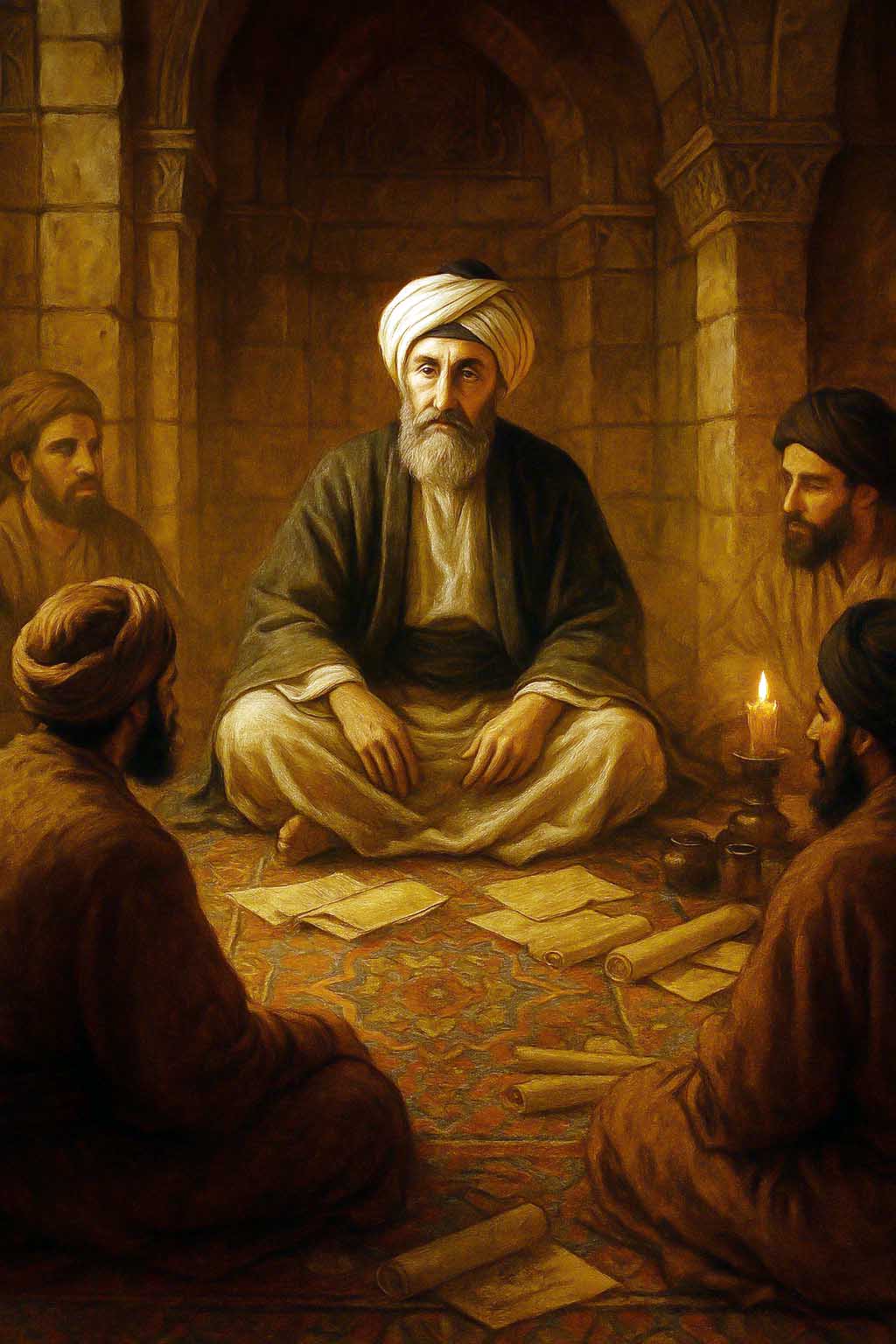
يقول: تتمثل أهمية ابن عربى فى حقيقة أنه يمثل همزة الوصل بين التراث الصوفى والفلسفى السابق عليه كله، وبين كل المفكرين الذين جاءوا بعده، والذين لم يكد ينجح واحد منهم فى تجاوز تأثير فلسفته بالسلب أو الإيجاب، بما فى ذلك ابن تيمية ومدرسته.
وتظهر أهمية ابن عربى بالنسبة للتراث السابق عليه، كما يقول نصر، فى أنه بلور كثيرًا من المفاهيم والتصورات التى توجد عند سابقيه بشكل ضمنى غامض، ومن هذه الزاوية تكشف دراسة ما قدمه ابن عربى كثيرًا من جوانب الغموض فى أفكار الصوفية السابقين عليه، خاصة أولئك الذين لم تصل كتبهم، أو وصلت لنا منهم مجرد أقوال متناثرة غامضة، كالحلاج والتسترى والنفرى وابن مسرة، فقراءته لتراث هؤلاء المتصوفة وتمثله له، يمكن أن تبدد كثيرًا من الغموض الذى يحيط بأفكار هؤلاء المتصوفة.
وعن أثر ابن عربى فى المفكرين التالين له، يشير أبوزيد إلى أنه كان أكثر وضوحًا وبروزًا، وهو الأثر الذى بدأ يتشكل خلال زيارته إلى «قونية» عام ١٢١٠ ميلادية، حينما اتخذ صدرالدين القونوى تلميذًا له، ومن خلال هذا الأخير وعلاقته ببعض المتصوفين العظام من الفرس، وصلت تعاليم ابن عربى إلى الشرق، فالقونوى كان أستاذًا لقطب الدين الشيرازى الشارح المعروف لفلسفة السهروردى، وكان صديقًا حميمًا لجلال الدين الرومى مؤلف «المثنوى»، النص العظيم الذى يلخص الحكمة الصوفية، وقد ألهمت تعاليم ابن عربى كاتبًا صوفيًا عظيمًا آخر، هو عبدالكريم الجيلى مؤلفه «الإنسان الكامل».
تجاوز تأثير ابن عربى الجانب النظرى للتصوف.
يقول أبوزيد: امتد محيى الدين بعمق إلى صياغة الحياة الصوفية كلها، فمن خلال الرومى فى الشرق، وأبى الحسن الشاذلى فى الغرب، تشكل بتعاليم ابن عربى طريقتان من كبرى الطرق الصوفية، ولم يقف مدى تأثيره وحدود انتشار أفكاره عند الثقافة الإسلامية فى الشرق والغرب، بل يتجاوز ذلك إلى الفلسفة المسيحية الغربية، ومن ذلك تأثيره فى «ريمون لول» وتأثيره فى «دانتى أليجرى» مؤلف الكوميديا الإلهية، حيث أثر فى الأول بمفهومه عن الأسماء الإلهية وحضراتها، وأثر فى الثانى بمفهومه عن الجنة والنار ومراتبهما المختلفة.
ويرصد نصر أبوزيد الخلاف حول ابن عربى، معتبرًا أنه لم يختلف الباحثون قديمًا وحديثًا حول شىء قدر اختلافهم حوله، فقد تأرجحوا بين طرفى النقيض، بعضهم اعتبره قديسًا عارفًا وليًا يتناسب دوره مع اسمه، فهو محيى الدين حقًا، والبعض الآخر اعتبره كافرًا ملحدًا زنديقًا مميتًا للدين.
عاش ابن عربى فى وطنه الأول الأندلس ذروة الصراع بين المسيحية والإسلام من جهة وبين الاتجاهات المختلفة فى هذا المجتمع من جهة أخرى
لكن لماذا كل هذا الخلاف؟
يمكننا من بين سطور ما كتبه نصر أن نصل إلى شىء من سر هذا الخلاف.
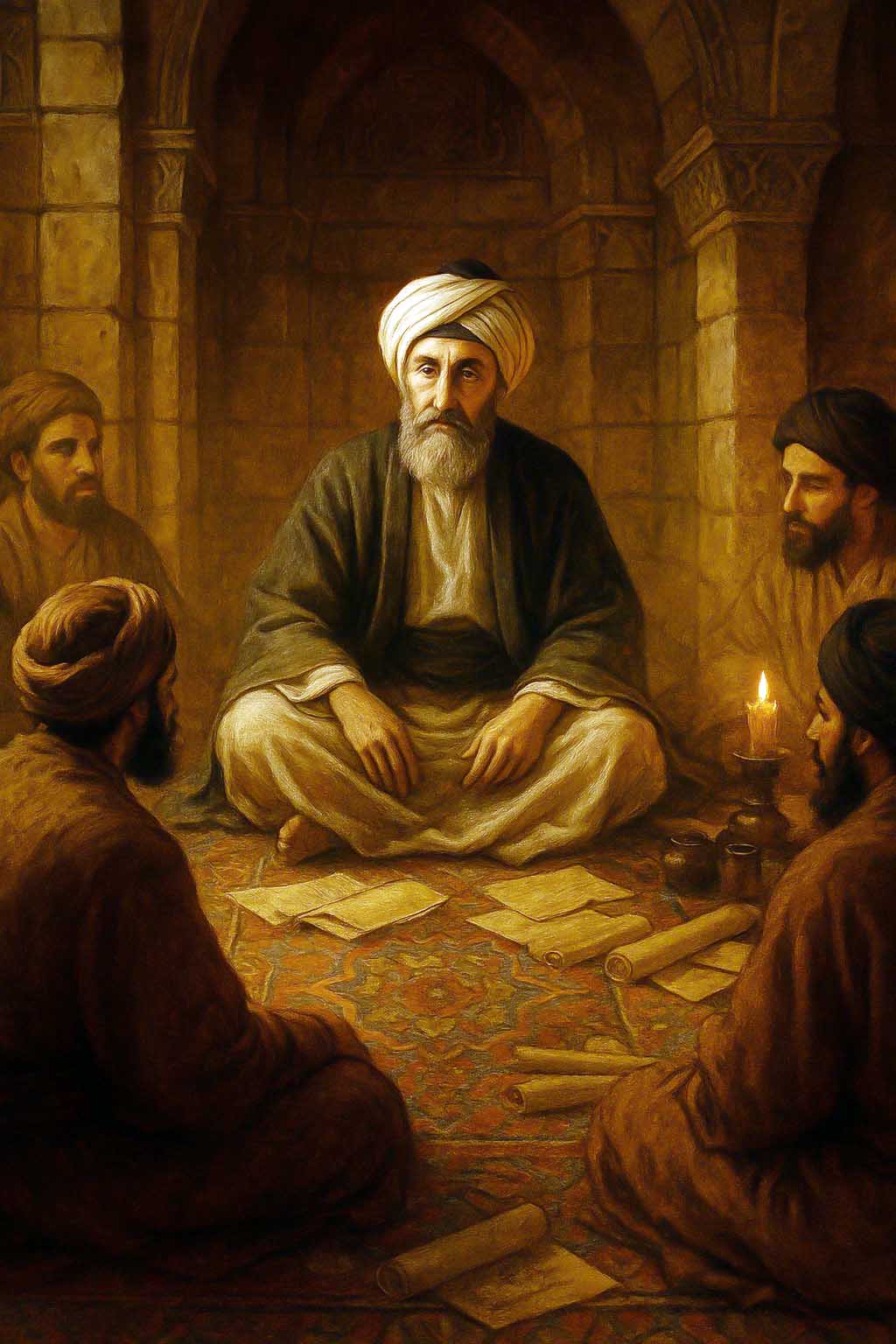
فقد عاش ابن عربى فى وطنه الأول، الأندلس، ذروة الصراع بين المسيحية والإسلام من جهة وبين الاتجاهات المختلفة فى هذا المجتمع من جهة أخرى، بين سنة وشيعة وأشعرية ومعتزلة وفقهاء وفلاسفة ومتصوفة، وحين غادر موطنه إلى المشرق لم يجد الأحوال فى العالم الإسلامى الفسيح تختلف كثيرًا عما تركه فى بلاده، فالخلافات مزقت وحدة الخلافة والدولة، وحولتها إلى دويلات صغيرة متنازعة، يتحالف بعضها مع أعداد الإسلام ضد جيرانهم المسلمين.
فى ظل هذا الجو الملبد بالصراع على جميع المستويات اجتماعيًا وسياسيًا وفكريًا دينيًا، عاش ابن عربى وتشكلت فلسفته ونظرته إلى العالم والكون، وهو ما جعله يشعر أن العالم بحاجة ماسة إلى مرشد يصلح أمره، ويقوده إلى الخير والنجاة.
يقول نصر: بحث ابن عربى عن هذا المرشد فى ذاته فأقام دولة باطنية، هى دولة الأولياء والعارفين، ووضع نفسه على رأسها مقارنًا بين نفسه وبين عيسى عليه السلام الذى يعود فى آخر الزمان ليحكم بشريعة الإسلام، وقد عم الكفر وطغى بظهور المسيح الدجال.
لم تكن هذه الفكرة لدى ابن عربى من فراغ.
فى كتابه «محيى الدين بن عربى» الذى وضعه طه عبد الباقى سرور فى العام ١٩٥٥ نقرأ عن الشيخ الأكبر ما يمكننا اعتباره تدشين لاعتقاده التفرد فى نفسه.
يقول ابن عربى: لقد أنعم الله على ببشارة عظمى بشرنى بها، وكنت لا أعرفها من حالى، وكانت حالى، فأوقفنى عليها الإمام خليفة القطب، فقد نهانى عند التقائى به عن الانتماء إلى من لقيت من الشيوخ، وقال لى: لا تنتمِ إلا إلى الله، فليس لأحد ممن لقيته عليك يد مما أنت فيه، بل الله تولاك برعايته وعنايته، فاذكر فضل من لقيت إن شئت، ولا تنتسب إلا إلى الله.
ويعلق سرور على ذلك بقوله: وبذلك دخل ابن عربى فى نطاق الذين أدبهم ربهم واجتباهم، وهم قلة فى الطريق لا يتجاوزون الآحاد، بل وضع قدمه على أول الطريق إلى القمة العلمية الربانية، وهى شرعة هو صاحبها وربانها وإمامها الأوحد.
هذه الصورة التى رسمها نصر قد تجعل كثيرين ينفضون عن ابن عربى، فلو حاكمنا ما فعله بمنطق زماننا هذا لاعتبرناه مدعيًا، أحد المجانين الذين يدعون أنهم المهدى المنتظر، أو أنبياء آخر الزمان، لكنه ينفض عنه غبار هذه الفكرة ويقول أنه كان ابن عصره، ولذلك كانت حلوله الفلسفية لمشاكل العالم تحمل فى باطنها كل جوانب الصراع الذى عاش فيه.
قد لا تهمنى كثيرًا حالة الجدل التى أحاطت بحياة بن عربى، وقد لا أثق كثيرًا فى الصورة التى وصلتنا عنه، فهناك من أضاف إليها وهناك من حذف منها، كل حسب موقفه منه، لكننى أتوقف عند ما وصلنا إليه من إنتاج فكرى.
والسمة الأساسية لهذا المشروع الفكرى كما رصد نصر أبوزيد هى «الوسطية التوفيقية».
ويوضح نصر أكثر، فالتوفيقية لدى ابن عربى ليست مجرد التوفيق الفكرى الفلسفى بين آراء وأفكار مختلفة متعارضة، بل التوفيقية التى تستهدف خلق إطار موحد يسمح بمشروعية كل الأفكار، باعتبارها تجليات مختلفة للحقيقة المطلقة المتعالية عن التقييد والحصر.
بهذه الصيغة يتحدد أمامنا مشروع ابن عربى الحقيقى بعيدًا عن التهويمات والاتهامات والتعصب له أو ضده، فمشروعه يمكن تلخيصه بأنه مشروع دينى مفتوح على الأديان جميعها والمذاهب كلها، ويحكمه أنه لم يتجاوز إطار الإسلام نفسه باعتباره آخر الأديان وأكملها وأشملها تعبيرًا عن الحقيقة المطلقة.

هذه الصيغة التى نسج بها ابن عربى مشروعه- وكما يرى نصر- جعلتنا نجد فى مشروعه تشابهات كثيرة مع أفكار قد ترتد فى بعضها إلى الأفلاطونية المحدثة أو إلى الأرسطية أو إلى المعتزلة والأشاعرة، أو إلى الشيعة.. وقد ترتد بعض هذه الأفكار إلى الفكر المسيحى أو اليهودى أو الغنوصى، وقد جعلت كل هذه الأفكار والعناصر فكر ابن عربى أقرب إلى مركب جديد له قدر من الجدة والأصالة.
يعبر من أدركوا حقيقة ما قدمه ابن عربى عن إنجازه الفكرى بأن له فى كل معسكر قدمًا، وهو توصيف دقيق لما قام به خلال حياته، ولا يزال يقدمه حتى الآن من خلال الكتب والدراسات والأبحاث الكثيرة التى تتناول أفكاره ومشروعه.
هذه الرحلة الطويلة مع ابن عربى تعمدت أن أقف فيها على ما فعله فى التفسير المنسوب إليه للقرآن الكريم، وأقول منسوبًا إليه لأن هناك من يشكك فيه.
كان لابن عربى منهج واضح فى كل ما يكتبه.
فى الفتوحات المكية مثلًا يقول: جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو إملاء إلهى وإلقاء ربانى، أو نفث روحانى فى روحى، كل ذلك بحكم الإرث للأنبياء، والتبعية لهم، لا بحكم الاستقلال.
ويقول: إن جميع ما أكتبه فى تأليفى ليس عن رؤية وفكر، وإنما هو عن نفث فى روعى على يد ملك الإلهام.
ويقول أيضًا: تصانيفى إنما هى من حضرة القرآن وخزائنه، فإننى أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه.
ويقول كذلك: ما عندنا بحمد الله تقليد لأحد، إنما هو فهم فى القرآن أعطيته، ومدد من رسولى اختصصت به، وفيض من ربى أكرمنى بأنواره.
ويقول محددًا منهجه: من رمى بميزان الشريعة من يده لحظة هلك.. لقد كتبت ما كتبت وأنا أقر بحمد الله تعالى أنى لم أذكر أمرًا غير مشروع، وما خرجت عن الكتاب والسُنة فى شىء، بل منهما استمددت، وبهما أنير طريقى.
وفى التأليف يقول: إن تأليفنا هذا وغيره لا يجرى على مجرى التأليف، ولا نجرى فيه نحن مجرى المؤلفين، فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره، وإن كان مجبورًا فى اختياره، أو تحت العلم الذى تعلمه خاصة، فيلقى ما يشاء ويمسك ما يشاء، أو يلقى ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة التى هو بصددها، حتى يبرز حقيقتها، ونحن فى تأليفنا لسنا كذلك، إنما هى قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهية، مراقبة لما ينفتح له الباب، فقيرة خالية من كل علم، لو سئلت فى ذلك المقام عن شىء، ما سمعت لفقدها إحساسها، فمهما برز لها من وراء ذلك الستر أمر ما، بادرت لامتثاله وألقته على حسب ما حد لها فى الأمر.
لم يكن الأمر سهلًا على ابن عربى، فمن يصل إلى هذه الدرجة لا بد أن يأخذ نفسه بالشدة.
يقول: ينبغى للعبد أن يستعمل همته فى الحضور فى مناماته، بحيث يكون حاكمًا على خياله يصرفه بعقله نومًا، كما كان يحكم على يقظته، فإذا حصل للعبد هذا وصار خلقًا له، وجد ثمرة ذلك، وانتفع به فى كل شىء.
استقرت آراء من تتبعوا أثر ابن عربى أن لديه ١٠٠ كتاب، من بينها «تفسير ابن عربى»، وهو التفسير الذى يعرفه الناس فى مجلدين مشهورين، وحول هذا التفسير تحديدًا تدور الريبة.
لكن هل هناك تفسير كامل وضعه ابن عربى للقرآن الكريم؟
ما لدينا فى المكتبة العربية يقودنا إلى أن هناك تفسيرات تحمل اسمه منها:
أولًا: «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن»، ويتناول فيه تفسيره لسورة البقرة، وفى الغالب طُبع مرة واحدة.

ثانيًا: «رحمة من الرحمن فى تفسير وإشارات القرآن».. وفيه إشارة إلى أنه من كلام الشيخ محيى الدين بن عربى جمعه أحد علماء دمشق وهو محمود الغراب، وقد استخرجه من كتابه «الفتوحات المكية»، وبه تفسيرات لآيات وإشارات من معانى القرآن، ولا يمكن أن نعتبره تفسيرًا كاملًا، وصدر لأول مرة فى أربعة مجلدات فى العام ١٩٨٩، ووضع على هامشه كتاب «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن».
لم يكن ما أنجزه الغراب بسيطًا، بل كان مركبًا ومرهقًا.
يقول فى تقديمه للتفسير الذى استخرجه من «الفتوحات المكية»: قمت بالعمل أكثر من خمس وعشرين سنة فى جمع وتصنيف وترتيب ما كتبه الشيخ الأكبر فى كتبه التى بين أيدينا، مما يصلح أن يكون تفسيرًا لبعض آيات القرآن سواء من الناحية الظاهرة على نسق التفاسير الأخرى من الأحكام الشرعية والمعانى العربية، أو ما يصلح أن يكون تفسيرًا صوفيًا لبعض آيات القرآن، وهو ما يسمى بالاعتبار والإشارة، فى التوحيد والسلوك وسميته «رحمة من الرحمن فى تفسير وإشارات القرآن»، تماشيًا مع عقيدة الشيخ الأكبر فى شمول الكتب التى لا نقطع بصحة نسبتها إلى الشيخ مثل كتاب «رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات» وكتاب «تلقيح الأذهان» وكتاب «فصوص الحكم»، فإنها معان لا تتعارض مع ما جمع من كتب ثابتة للشيخ، وقد قمت بإثبات الموجود من تفسير «إيجاز البيان» على هامش هذا التفسير تأكيدًا لاتفاق المعانى وتوضيحًا لأسلوب الشيخ ومنهاجه العلمى، كما سيجد القارئ كثيرًا من المعانى التى انفرد بها الشيخ رضى الله عنه فى تفسير القرآن، وهى من السهل الممتنع التى تطرب لها الأرواح، ويرتاح إليها كل ذى رحمة تدعو إلى رفع الجناح، وقد أفردت فى نهاية كل مجلد فهرسًا لمراجع تفسير الآيات، مشيرًا إلى مصادر جمعها المتعددة، ليسهل على المحقق الرجوع إليها، والله أسأل أن ينفعنى والمسلمين بهذا العلم الشريف.
ويكشف الغراب أن لابن عربى على القطع تفسيرين على الأقل هما:
كتاب «الجمع والتفصيل فى معرفة معانى التنزيل».
والثانى هو «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن».
يقول عن الأول فى الفتوحات المكية عند الكلام على حروف المعجم فى أوائل سور القرآن «ذكرناه فى كتاب الجمع والتفصيل فى معرفة معانى التنزيل».
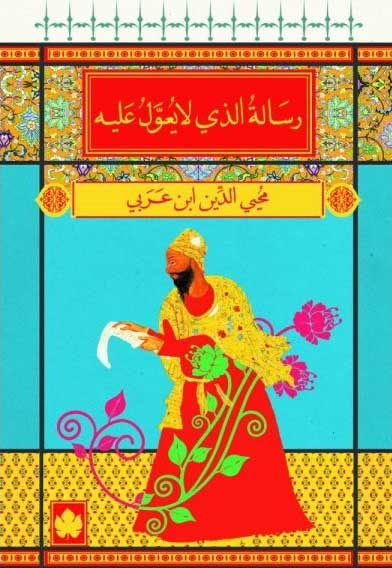
ويقول: وقد أشبعنا القول فى هذا الفصل عندما تكلمنا على قوله تعالى «اخلع نعليك» فى كتاب الجمع والتفصيل.
ويقول عند كلامه على مراتب الحروف: هذه كلها أسرار تتبعناها فى كتاب المبادئ والغايات وفى كتاب الجمع والتفصيل.
ويقول عند كلامه عن حروف المعجم: من أراد التشفى منها فليطالع تفسير القرآن الذى سميناه الجمع والتفصيل، وسنوفى الغرض من هذه الحروف إن شاء الله فى كتاب المبادئ والغايات لنا، وهو بين أيدينا.
أما عن التفسير الثانى «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن» فيقول فى الفتوحات المكية: قد بيناه فى كتاب «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن» فى قوله فى آل عمران «ولم يصروا على ما فعلوا» فانظره هناك.
وطبقًا للغراب فإن هذا يؤكد وجود التفسيرين للشيخ رضى الله عنه، ولا نعلم هل الإشارة بقوله «التفسير» أو «التفسير الكبير» أيشير بذلك إلى أحد هذين التفسيرين أو إلى كليهما، أم أن هناك تفسيرين آخرين له، حيث يقول عند كلامه عن الذكر فى الفتوحات المكية: اعلم أن كل ذكر ينتج خلاف المفهوم الأول منه فإنه يدل ما ينتجه على حال الذاكر، كما شرطناه فى التفسير الكبير لنا.
ويقول عندما يتكلم عن الذات والحدث والرابطة وأنه يدخل تحت كل منها أنواع كثيرة، وقد اتسع القول فى هذه الأنواع فى تفسير القرآن لنا.
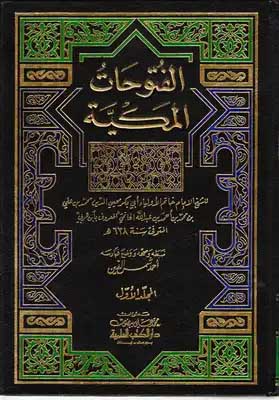
ويقول عند شرحه لقوله تعالى «رب العالمين»: وقد ذكرناه فى تفسير القرآن لنا.
ويقول عند كلامه على علم الجزاء الدنيوى والأخروى: وقد بيناه فى التفسير لنا فى فاتحة الكتاب فى قوله تعالى «ملك يوم الدين».
أشار الشيخ إلى بعض كتبه بكلمة «التفسير» تارة، وبكلمة التفسير الكبير تارة أخرى.
ولقد فقدت المكتبة الإسلامية للأسف الشديد هذا التراث العظيم ضمن ما فقدته، فإنه لا يوجد أثر لهذه التفاسير المشار إليها إلا تفسير فاتحة الكتاب وجزءين من سورة البقرة من تفسير «إيجاز البيان فى الترجمة عن القرآن»، أما التفسير الأكبر وهو «الجمع والتفصيل فى معرفة معانى التنزيل»، فإنه لم يبق منه أثر، ومما يدل على احتمال إكمال تفسير «إيجاز البيان» أن الشيخ يشير فيه إلى أنه سيأتى على تفسير آيات فى مواضعها من سورة النساء والمائدة والأعراف، وسورة محمد وطه وفصلت وص، كما نص فى الفتوحات المكية وأحال إلى الرجوع إلى سورة آل عمران من هذا التفسير.
ويضيف الغراب: أما تفسير القرآن المطبوع باسمه والذى يتداول بين أيدى الناس فى مجلدين، فهذا التفسير ليس للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى، ولا صلة له به، وإنما هو لعبدالرازق الكاشانى المتوفى فى سنة ٧٣٠ هجرية، أى بعد وفاة الشيخ الأكبر بحوالى مائة عام.
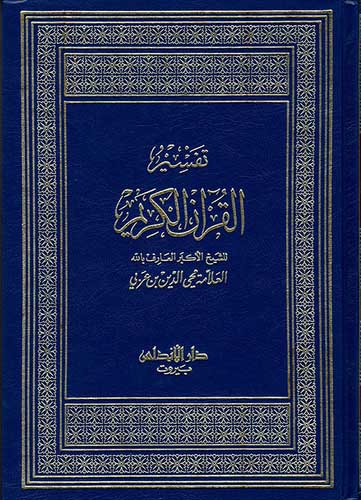
لم يكن الغراب أول من قال ذلك، ففى تفسير المنار ينقل محمد رشيد رضا عن أستاذه الشيخ الإمام محمد عبده عندما كان يتحدث عن التفسير الإشارى قوله: وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية، ومن ذلك التفسير الذى ينسبونه للشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى، وإنما هو الكاشانى الباطنى الشهير، وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز.
يقول الغراب إن النسخة الخطية لهذا التفسير موجودة بالمكتبة السليمانية بتركيا تحت رقم ١٧- ١٨، وتحمل خاتم المؤلف عبدالرازق الكاشانى، ويمكن أن يعرف القارئ والباحث عن الحقيقة الفرق الكبير بين أسلوب الشيخ رضى الله عنه فى تفسيره «إيجاز البيان» وفى التفسير الذى قمت بجمعه من كلامه وبين هذا التفسير المزور المنسوب إليه، كما يقف القارئ على الفرق بين المعانى الجميلة والإشارات اللطيفة فى كلام الشيخ وبين الكلام فى تفسير الكاشانى الذى لا يكاد يُفهم منه شىء، لأنه ينحو إلى الفكر والاتجاه الباطنى الذى يرمى القارئ فى متاهات الحيرة فلا يعرف الخروج منها.
الكلام نفسه نقرأه فى كتاب «تفسير ابن عربى للقرآن حقيقته وخطره» لمحمد حسين الذهبى الصادر عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
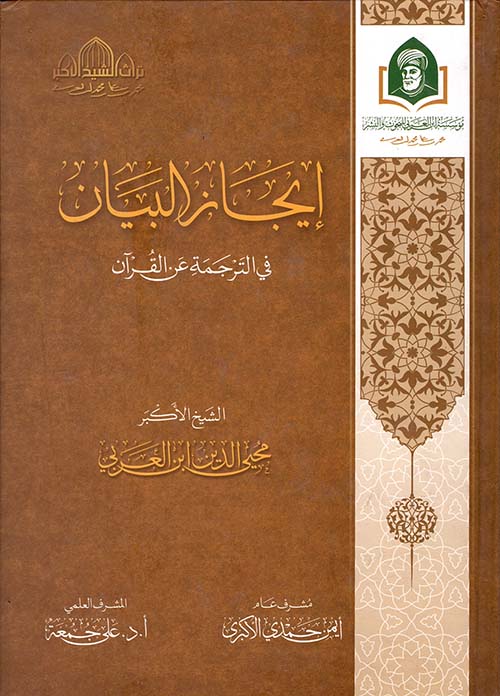
فهو يدلل على أن التفسير للكاشانى وليس لابن عربى بالآتى:
أولًا: جميع النسخ الخطية لهذا التفسير منسوبة للكاشانى، والاعتماد على النسخ المخطوطة أقوى، لأنها الأصل الذى أخذت عنه النسخ المطبوعة.
ثانيًا: فى كتاب «تأويلات القرآن المعروف بتأويلات الكاشانى» يبدأ بقوله: الحمد لله الذى جعل مناظم كلامه مظاهر حسن صفاته، وفى التفسير المنسوب لابن عربى فى النسخ المطبوعة هذه العبارة مذكورة بنصها.
ثالثًا: فى تفسيره لـ«واضمم إليك جناحك من الرهب» ورد: وقد سمعت شيخنا نور الدين عبدالصمد، ومعروف أنه كان شيخًا لعبدالرازق الكاشانى وليس لابن عربى.
يمكننا أن نستبعد التفسير المشهور لدى الناس بأنه تفسير ابن عربى من قائمة تفاسير القرآن، ونركن إلى ما ثبت أنه له، وهو ما أوضحته دراسة الغراب.
وإذا أردنا أن نعرف الفارق بين التفاسير التقليدية وتفسير ابن عربى، فيمكننا أن نقارن بين ما قاله الإمام القرطبى وابن عربى فى تفسير سورة الفاتحة.
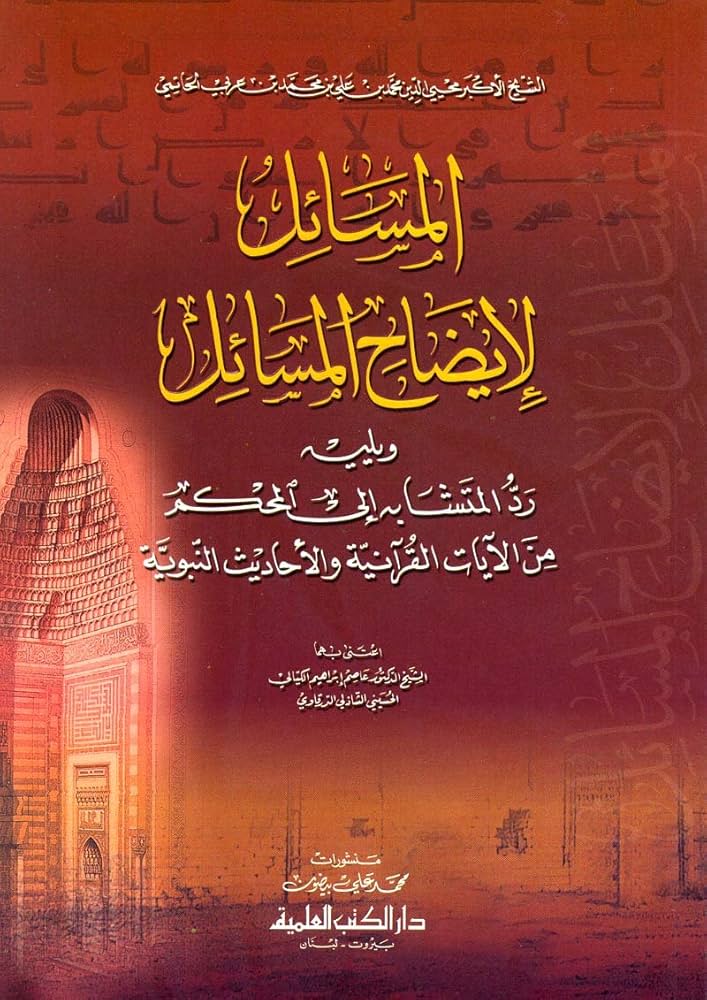
نبدأ أولًا بتفسير القرطبى الذى تتوالى المعانى على يديه على النحو التالى:
يقول القرطبى إن سورة الفاتحة هى أعظم سور القرآن وأم الكتاب، وأجمع العلماء على أنها مفتاح الصلاة وأساسها، وورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وتبدأ سورة الفاتحة بالبسملة، فبسم الله تأكيد على أن كل أمر يبدأ بالله وباسمه.
«الرحمن الرحيم» هما صفتان لله تعالى تدلان على الرحمة الواسعة، فالرحمن لرحمة شاملة لكل المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين.
«والحمد لله رب العالمين» فيها أن الحمد هو الثناء الكامل لله، ورب العالمين معناها أن الله هو رب كل شىء، مالكه ومدبره، من العوالم كلها، سواء كانت هذه العوالم سماوية أو أرضية.
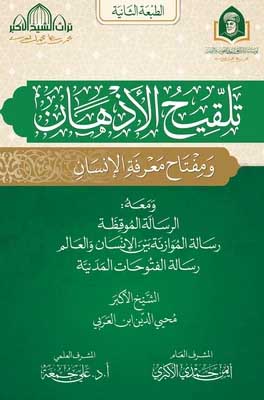
«الرحمن الرحيم» التكرار هنا فى الآية يدل على تأكيد رحمة الله التى أحاطت بكل شىء.
وأما معنى «مالك يوم الدين» فالله هو صاحب الملك والسلطان فى يوم الجزاء يوم القيامة، وهو اليوم الذى يحاسب فيه الخلائق ويجازى كل إنسان على عمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.
«وفى إياك نعبد وإياك نستعين» إقرار بوحدانية الله، لا نعبد إلا الله وحده، ونسأله العون والمساعدة فى جميع الأحوال.
و«اهدنا الصراط المستقيم» فيها طلب من الله أن يهدينا الطريق الصحيح، طريق الدين القويم الذى يؤدى إلى رضاه والجنة التى هى خير الجزاء.
عندما نأتى إلى تفسير ابن عربى لمعانى سورة الفاتحة سنجده يسبح فى عالم مختلف تمامًا
وفى «صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».. توضيح لأن الصراط هو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله عليهم بالهداية، والمغضوب عليهم هم الذين عصوا الله وعملوا الحق لكنهم أغضبوه بما فعلوه، أما الضالون فهم الذين ضلوا عن الحق ولم يهتدوا، وماتوا على ضلالتهم.
عندما نأتى إلى تفسير ابن عربى لمعانى سورة الفاتحة، سنجده يسبح فى عالم مختلف تمامًا،
فهو ينظر إلى «بسم الله» على أنها نداء مستمر من الذات الإلهية للخلق، حيث الله هو الاسم الأعظم، وكل شىء لا بد أن يبدأ بتسمية الذات الإلهية، وفى «الرحمن الرحيم» كشف عن سعة رحمة الله التى تشمل كل ما فى الوجود، فهى صفة الحب والحنان التى تحيط بكل الكائنات.
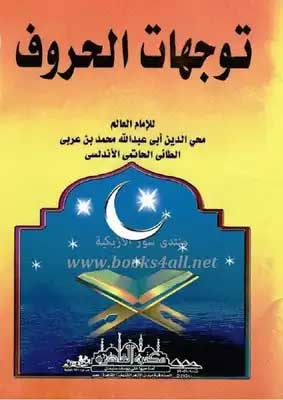
«والحمد لله رب العالمين» فالحمد هو الشكر والاعتراف بالفضل لله، والرب هو المربى والمالك، و«رب العالمين» هذه تعنى أن الله هو الأصل فى كل الموجودات، والربوبية تعنى التنشئة والاعتناء بكل مراحل الوجود من العوالم الظاهرة والباطنة.
ويعتبر ابن عربى أن «الرحمن الرحيم» تكرار يدل على استمرار الرحمة الإلهية وتنوعها، فهى ليست المرة الأولى، بل متجددة، تشمل كل ما يحيى الروح ويهب الحياة.
أما فى «مالك يوم الدين» فالملك هنا هو السلطان الكامل، ويوم الدين هو يوم الجزاء الإلهى، وهذا اليوم واقع داخلى لدى كل إنسان، فالإنسان يحاسب نفسه روحيًا على كل أفعاله ما أظهر منها وما أخفى.
أما إياك نعبد وإياك نستعين».. فيذهب ابن عربى إلى أن العبادة ليست فقط فى الطقوس، بل هى العشق الخالص لله، وهى عبادة محلها القلب الذى هو مركز الحب الإلهى، و«إياك نعبد» تعنى أن كل القلوب موجهة لله وحده، وعن «إياك نستعين» يقول إننا جميعًا مطالبون بأن نطلب من الله القوة التى تدفعنا فى طريق الوجود والوعى.
و«الصراط المستقيم» بالنسبة له هو الطريق الذى يربط بين الخالق والمخلوق، والمستقيم هو طريق الحقيقة والوعى الإلهى الذى لا يحيد من يسير فيه عن الحق، وهو طريق الأنبياء والصالحين والمخلصين الذين أنعم الله عليهم بالهداية.
وعندما يصل إلى «المغضوب عليهم» فلا يعتبرهم الذين عصوا الله فقط، ولكن هم الذين رفضوا الحقيقة، فخرجوا على صاحبها فأغضبوه، والضالون هم الذين غابت عنهم الهداية، فضلوا عن طريق الوعى الإلهى.
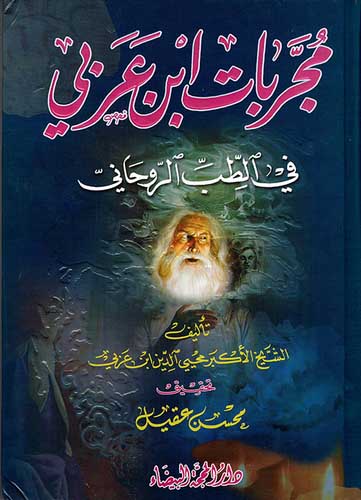
يمكننى أن أتركك الآن لتبحث عن تفسير ابن عربى للقرآن، وقد دللتك عليه، ومؤكد أنك ستجد فيه من المعانى ما يسعفك فى حياتك، لكن ولأنه لا بد لك من دليل، فإننا سأضع أمامك بعضًا من تفسيراته لآيات محددة من القرآن، لعلها تجعلك تطمع فى المزيد.
فى الآية ٣٠ من سورة البقرة «إنى جاعل فى الأرض خليفة».
يذهب ابن عربى إلى أن الخلافة ليست مجرد ولاية أو حكم أرضى، بل تعنى أن الإنسان الكامل هو خليفة الله فى إظهار أسمائه وصفاته فى الكون، ويضيف على ذلك أن الخليفة الحقيقى هو من تحقق بالفناء فى الله، فصار مظهرًا له، ولهذا لا تكون الخلافة إلا لمن أدرك سر الأسماء كلها.
وفى الآية ٣١ من سورة البقرة يقول الله تعالى «علم آدم الأسماء كلها».
الإشارة فى الآية إلى أن الأسماء هنا ليست مجرد أسماء الأشياء، بل هى أسماء الله وصفاته ما نعرفها منها وما لا نعرف، فالله أودع فى الإنسان القدرة على أن يكون مرآة للتجليات الإلهية كلها، ولهذا سجدت له الملائكة.
لهذه الآية معنى باطنى عند ابن عربى، فهو يشير إلى أن الإنسان الكامل جامع كل حضرات الوجود، ويقدر على الشهود الكامل، لأن لديه استعدادًا فطريًا لتجلى الأسماء الإلهية فيه.

ومن سورة البقرة أيضًا الآية رقم ١١٥ «فأينما تولوا فثم وجه الله».. يصف ابن عربى وجه الله بأنه الحق المتجلى فى كل وجهة وكل كائن، فالعالم بأسره مظهر لصفات الله، وعليه فلا تخلو وجهة من وجود الله فيها، والعارف لا يرى فى الوجود شيئًا إلا ويرى فيه وجه الله، ولذلك لا يتقيد بقبلة حسية فقط، بل توجهه قلبه حيث يظهر الحق.
ومن سورة النور فى الآية ٣٥ نقرأ «الله نور السموات والأرض»، والنور عند ابن عربى هو الوجود الإلهى الذى ظهر به كل شىء، ولا يرتبط النور هنا بالهداية، بل عن حقيقة الوجود نفسه، فالله هو الوجود الحقيقى، وكل ما سواه مظاهر وتجليات لهذا النور، ولهذا فإن العالم كله ظهور لله، ولا وجود مستقل له عن الله.
وفى الآية «إليه يرجع الأمر كله» من سورة هود رقم ١٢٣ يقول ابن عربى إن رجوع الأمر ليس فقط بعد الموت أو فى يوم القيامة، بل هو رجوع دائم، كل شىء يعود إلى أصله، ولأنه لا وجود مستقل عن الله، فالكل يعود فى النهاية إلى الله، وكل شىء فى الوجود دائر فى فلك الحقيقة الإلهية، وما تظنه وجودًا منفصلًا ليس إلا مظهرًا لوجود الحق.
وفى سورة الحجر الآية ٢٩ تقول «ونفخت فيه من روحى»، يرى ابن عربى أن النفخة الإلهية تعنى أن فى الإنسان عنصرًا إلهيًا، لا بمعنى الحلول، ولكن بمعنى الاستعداد الأسمى للاتصال بالله، فالروح التى نفخت فى الإنسان جعلته كائنًا ذا بعد إلهى، ولذا يمكنه الترقى حتى يشهد الحقيقة، ويصل إلى مقام العرفان.
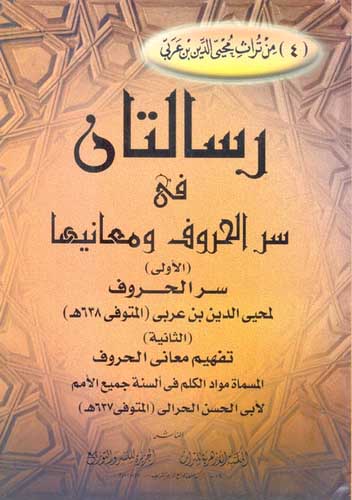
عندما يصل الإنسان إلى درجة العارف عند ابن عربى فيرى أنه لا وجود لذاته
ومقام العرفان عند ابن عربى هو الوصول إلى درجة عالية من المعرفة بالله، تتجاوز المعرفة الظاهرة أو العلمية، وتصل إلى التجربة الوجدانية المباشرة مع الحقائق الإلهية، وهى درجة تتحقق فيها للعارف وحدة الوجود، فيرى الله فى كل شىء.
وعندما يصل الإنسان إلى درجة العارف عند ابن عربى، فيرى أنه لا وجود لذاته، بل هو فان فى ذات الله، يتخلق بأخلاق الله، ويتصف بصفاته، وتنعكس فى سلوكه وأفعاله، ويتبرأ من حوله وقوته، ويعتمد على الله وحده فى كل أموره.
ويصل بنا ابن عربى إلى «وإن ربك واسع المغفرة» الآية ٣٢ من سورة النجم، ويقول إننا لا يمكن أن نقيد الله بمفاهيمنا البشرية عن الذنب والعقوبة، فالمغفرة ليست فقط سترًا للذنب، بل هى أيضًا تجل من تجليات الرحمة الإلهية التى تشكل حتى أهل الجهل والبعد، إذ لا يخرج شىء عن دائرة الحق.
والمثال الأخير معنا هنا هو قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» الآية ٤ من سورة التين، ويرى ابن عربى أن «أحسن تقويم» لا تعنى فقط الجسد المتوازن، بل الاستعداد الروحى الفريد الذى يجعل الإنسان قادرًا على التجلى بالأسماء الإلهية.
الوصول إلى تفسير ابن عربى سهل، لكن العمل بما فيه صعب، وإذا كان هناك من حاول الطعن فيه، فطعنه عليه، فليس لنا ما فعله، ولكن لنا ما تركه خلفه كثير، وهو ما جعله ليس الشيخ الأكبر، ولكنه رئيس المكاشفين.. فقد كشف الله له ما لم يكشفه لغيره.. ويقينى أن الله يمكن أن يكشف لك ما لم يكشفه لغيرك.. هذا فقط إذا أردت.