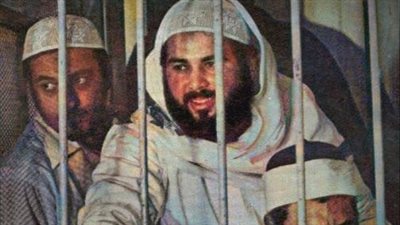فن صناعة الفزع.. المثقفون فى حفل زار جماعى

- أخشى على مصر من الغفلة التى تسيطر على بعض نخبتها
قبل سنوات حرص واحد من كتابنا الكبار فى مقالاته وحواراته الصحفية والتليفزيونية على ما أسميته وقتها «إثارة الفزع حول الرئيس».
كان هذا الكاتب يتقمص دور الندابة، لا يعجبه شىء، ولا يرى فيما يحدث شيئًا واحدًا إيجابيًا، فالصورة سوداء، والمستقبل لا يبشر بخير، ينتقص من قدر الرجال، ويعمم أحكامه التى لم تكن تستند إلى معلومات موثقة أو صحيحة على كل تصرفات النظام.
لم يكن كاتبنا الكبير ينطق عن الهوى، ولكنه كان ابن تكوينه وانتمائه الكامل لكاتب كبير آخر، احترف رسم صورة سوداء حتى يجد النظام نفسه مضطرًا إلى اللجوء إليه والجلوس بين يديه ليسأله النصح والنصيحة، ويأخذ منه المشورة ويخضع لتوجيهاته وآرائه وأفكاره، وينفذ سيناريوهاته.
لم تكن هذه الصيغة مجدية فى بدايات عصر جديد دخلته مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولم يكن ما فعله الكاتب الكبير مثير الفزع الجديد مؤثرًا، فقد أدرك من يقرأون له أنه لا علم له بشىء، ولا إدراك عنده بما يحدث على الأرض، فلم يلتفت أحد إلى ما يقوله، وتقريبًا ذاب بما يكتبه فى الزحام، فلم يعد له أثر ولا تأثير.
يعرف النظام إلى حد بعيد التحديات التى يواجهها، ويدرك تمامًا أن هناك أسبابًا داخلية لأزماته، لكن هناك أسبابًا خارجية أكثر، بعضها نعرفه نحن، وبعضها الآخر لا نحيط به بشكل كامل، وحتى من يحيطون بتفاصيلها، لا يريدون الاعتراف بها.
لا أريد لكلامى أن يكون مبهمًا أو غير مفهوم، ولذلك سأتحدث معكم بصراحة.
بعد ثورة ٣٠ يونيو حسم المصريون أمرهم، وقاموا باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ليقود المرحلة، وهى القيادة التى جاءت على ثلاثة أجنحة تشكل معركة كبيرة.
الجناح الأول هو البقاء.. وتم العمل خلاله لمواجهة جماعات إرهابية كانت تعمل بدأب لإسقاط الدولة المصرية، وهى الجماعات التى لم تكن تعمل بمفردها، ولكنها كانت مدفوعة من دول وأجهزة خارجية، وفرت لها المال والسلاح والدعم الإعلامى من خلال قنوات تم إطلاقها من الخارج، وبدأ العاملون فى هذه القنوات فى شن أكبر حملة إعلامية على الدولة المصرية، وهى حملة شككت فى كل شىء، وحاولت زرع الفتنة بين فئات وطبقات المجتمع المختلفة، ولم يتردد أصحابها عن التحريض على الدولة واغتيال رموزها وتخريب كل ما تطاله الأيدى.
الجناح الثانى هو البناء.. وخاضت خلاله الدولة أكبر عملية ترميم للبنية التحتية، وبدأت تنطلق فى إصلاح عيوب كنا نعرفها، والتصدى لمشكلات كنا نعانى منها، واستطاعت الدولة فى سنوات قليلة وهى تخوض حربها ضد الإرهاب أن تبنى وتعمر وتنهى أزمة العشوائيات، وتؤسس مدينة جديدة، وتمد منظومة طرق هائلة، وتحدّث البنية التكنولوجية، ولم تترك فى جهدها جهدًا إلا وبذلته من أجل أن تصلب الدولة طولها، وهو ما كانت له تكلفة كبيرة، دفعها المواطنون، وأعتقد أن الأجيال القادمة ستتكفل بنصيبها منها.

الجناح الثالث كان الوعى.. وتعاملت الدولة على أن هذا الجناح من المعركة هو الأهم، فحتى تنتصر الدولة فى معركتى البقاء والبناء، فلا بد أن يكون هناك وعى مجتمعى عام وشامل وناضج بما تواجهه الدولة من تحديات، فهذا الوعى سيكون داعمًا للجبهة الداخلية فى أن تتوحد وتقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فى معركتها الكبرى، فلا يمكن لقائد أن يخوض حربًا وظهره مكشوف.
فى اجتماعه الأول مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين بعد أقل من شهر من توليه شئون البلاد فى العام ٢٠١٤، قال لهم الرئيس بوضوح: لدينا تحديات خارجية كثيرة، ولدينا تحديات داخلية أكثر، ولا بد أن نعمل معًا، التحديات الخارجية سأكون أنا كفيلًا بها، أما التحديات الداخلية فلن نستطيع مواجهتها إلا بجهود كل الإعلاميين، الذين يجب أن يوضحوا للناس ما الذى تواجهه مصر.
الأمر نفسه تكرر فى لقاء الرئيس مع المثقفين، الذين التقاهم فى لقاء موسع، وطلب منهم أن يعدوا تصورًا لما تواجهه مصر من مشكلات، وأن يسهموا بكتابة تصوراتهم للخروج من مأزق هذه المشاكل.
مرت الأيام وتعاقبت السنوات.
لم يقم الإعلاميون بدورهم.
وتاه المثقفون ولم يقدموا شيئًا من المطلوب منهم على أى مستوى من المستويات.
تذكرت ذلك كله وأنا أتابع ما اعتبرته حفل زار جماعيًا اندمجت فيه النخبة المثقفة فى مصر، وهى تتابع بعض الحوادث الأخيرة، وعلى رأسها حادث الطريق الإقليمى الذى راح ضحيته بنات العنب، وحادث سنترال رمسيس الذى كانت له آثار كبيرة وضخمة ومزلزلة.
لا ينكر أحد أن هناك تقصيرًا، وأن هناك مظاهر إهمال وتراخيًا فى الجهاز الحكومى، ورغم أن الحكومة أدارت الأزمتين بشكل احترافى بعد وقوعهما، فإن هناك حالة مسعورة- اسمحوا لى أن أطلق عليها هذا التوصيف- فى التفاعل مع مثل هذه الحوادث.
يمكننا أن نركن إلى الأرقام قليلًا، والأرقام فى الغالب لا تكذب ولا تتجمل.

طبقًا لإحصائيات صادرة عن «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء» فقد بلغ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية فى العام ٢٠٢٢ ما يقرب من ٤٩٣٤١ حريقًا، وفى العام ٢٠٢٣ وصل عدد الحرائق إلى ٤٥٤٣٥، أى أن العدد انخفض بنسبة تقترب من ٧.٩ بالمائة.
فى العام ٢٠٢٤ زاد عدد الحرائق عن عام ٢٠٢٣ بنسبة ٣.٢ بالمائة، حيث كان العدد ٤٦٩٢٥ حريقًا.
خبراء الإحصاء يشيرون إلى أن نسب الحرائق تتراوح ما بين ٥ و١٠ بالمائة انخفاضًا وارتفاعًا من عام إلى آخر، ويعتبرون أن هذا هو المعدل الطبيعى، وهو ما يشير إلى أنه لا شىء غير طبيعى يحدث فى مصر، فكل عام تحدث الحرائق، ولها أسبابها المعروفة والمحددة، وسواء كان هناك من يشكك فى أسباب الحرائق أو من يتعامل معها بشكل برىء إلا أنها تظل فى شكلها ومعدلها الطبيعى.
لكن خلال الأسابيع الماضية تركزت الأصوات الناقدة والزاعقة على أن ما يحدث شىء غير طبيعى، وأن الحرائق فى زيادة غير طبيعية، وبدلًا من البحث عن أسبابها التى قد تكون طبيعية فى الغالب، إلا أن هناك من اختار أن يقيم محاكمة شاملة وعاملة وساحقة وماحقة للحكومة وللنظام ولكل من يمثله، على أساس أنه من يتحمل وحده مسئولية كل هذه الحرائق.
وقد يكون حريق سنترال رمسيس وحجمه وآثاره الكبيرة هى التى عززت هذا الهجوم، ومنحته منطقًا لا يمكن أن نغفله أو نتغافل عنه، رغم أن التعامل الحكومى معه كان على مستوى مقبول، ويليق بحجم الأزمة.
الأمر نفسه تكرر فيما يتعلق بحوادث الطرق.

فقد شهد العام ٢٠٢٤ ارتفاعًا فى عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث بلغت ٧٦.٣٦٢ إصابة، بنسبة زيادة ٧.٥ بالمائة، مقارنة بإصابات عام ٢٠٢٣.
وطبقًا لإحصائيات الجهار المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفض معدل قسوة الحوادث «عدد الوفيات لكل ١٠٠ مصاب» من ٨.٣ فى عام ٢٠٢٣ إلى ٦. ٩ فى عام ٢٠٢٤، بنسبة انخفاض تصل إلى ١٦.٩ بالمائة.
ويحدد خبراء الطرق أسباب الحوادث على النحو التالى:
أولًا: السرعة الزائدة والإهمال.
ثانيًا: الدراجات البخارية والسكوتر.
ثالثًا: البنية التحتية للطرق وغياب الصيانة الدورية لها، وعدم وجود ممرات آمنة للمشاة والدراجات.
عندما نضع هذه المعلومات البسيطة الأولية أمامنا فإننا يمكن أن نناقش ما يحدث بهدوء حتى لو كان قاسيًا، وهى المناقشة التى يمكن أن تكون داعمة ومعينة لمن يعملون فى الجهاز الحكومى على تجاوز الأزمات أو على الأقل التعامل معها بشكل احترافى يخفف من آثارها، ليس بعد وقوعها ولكن قبل أن تحدث من الأساس، وهو من زاوية ما مطلوب بقوة.
مثلنا مثل كل بلاد خلق الله، لن تنتهى عندنا الحرائق، لن نستيقظ من نومنا فنجد أن معدل الحرائق أصبح صفرًا.
وهو ما ينطبق أيضًا على حوادث الطرق، لن يأتى يوم ونجد أنها تلاشت وتبددت فى مصر، فهذا يخالف تمامًا منطق الأشياء ولا يستقيم معه.
لكن ما لا يستقيم مع طبيعة الأشياء ويخالف منطقها تمامًا، هو تعاملنا مع هذه الحوادث، وجعلها سببًا فى إشاعة حالة من القلق والتوتر والفزع، وهى حالة بكل المقاييس ليست صحية، ولا يمكن أن تسهم فى حل أى مشكلة حتى ولو كانت صغيرة.
لقد رأينا إعلاميين كبارًا يتعاملون بسطحية شديدة مع ما يجرى، تحدثوا وكأننا نعيش فى مجتمع خرب تمامًا.
ورأينا مثقفين يسيرون على طريق هؤلاء الإعلاميين فيرددون ما يسمعونه دون تمحيص ولا تدقيق ولا محاولة للفهم.
والنتيجة فى النهاية أن المواطن العادى الذى يستمع إليهم وينقل عنهم يجد نفسه فى مواجهة حالة من اليأس التام.

فإذا كان هذا هو الوضع كما يصفه الخبراء والفاهمون والعالمون ببواطن الأمور، فما الذى يمكن أن يفعله.. إنه حتمًا سيستسلم لحالة يأس كاملة، وهى الحالة التى تشل تفكيره، بل ستجعله مهيأ لأن ينهار كل شىء من حوله دون أن تكون لديه القدرة على المقاومة، هذا غير أنه سيفتقد الرغبة فى أن يكون له أى دور للإصلاح.
كان الرهان الأكبر على هزيمة مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو أن يتم تخريب الجبهة الداخلية، أن يتفرق الناس، أن يصبحوا جبهات متنافرة، وفرق متناحرة، وفئات متحاربة، الكل يشكك فى الكل، والكل ضد الكل، وهى الحالة الوحيدة التى يمكن أن تضمن لأى خصم خارجى أن يتصرف كما يشاء، فالدولة أمامه فاشلة ومهزومة ومفتتة وأهلها متفرقون ومشتتون، فما أسهل السيطرة عليها والعبث بها.
فى مرحلة من المراحل كانت النيابة العامة توجه اتهامًا لمن يزرعون اليأس فى النفوس من خلال ما يكتبون أو يقولون وصفته بأنه «إشاعة مناخ تشاؤمى».
سخر كثيرون من الاتهام، وقاموا بالتنكيت على التوصيف، وهو ما عكس حالة من عدم الفهم، وعدم الوعى، فالاتهام صحيح، والتوصيف دقيق، فأخطر ما يمكن أن تواجهه دولة تحاول أن تقوم وتبنى وتعمر هو إشاعة مناخ تشاؤمى حول ما تقوم به، لأن هذا المناخ التشاؤمى من شأنه أن يزرع حالة من الإحباط فى نفوس الجميع.
وعندما يسود مناخ التشاؤم وتعم حالة الإحباط، فلن تجد هناك دافعًا لأن يفعل أحد شيئًا، ساعتها لن يجد مسئول أهمية لما يمكن أن يقوم به، فيقعد عن العمل تمامًا، ولن يجد الموظف ضرورة لأن يذهب إلى عمله، ولن يجد العامل أهمية لأن يستيقظ من نومه ليتجه إلى عمله، ولن يجد الطالب ضرورة أن يذهب إلى مدرسته أو جامعته، ولن تجد ست البيت المصرية جدوى من القيام بدورها، ولن يعثر كاتب على عائد مما يمكن أن يكتبه، ولن يجد إعلامى فائدة لما يقوله، فيلزم الصمت، بل إن بعضهم يمكن أن يستسلم ويتماهى ويتحول من منصة العقل والمنطق والواقع ليعتلى منصة الهجوم على أى وكل شىء يحدث فى الدولة.
ما لم يلتفت إليه كثيرون أن المناخ التشاؤمى كان يشيعه من حولنا من يتصدرون المنصات الإعلامية الخارجية، ومن يقومون على تمويل اللجان الإلكترونية، وكنا نفهم دوافع هؤلاء، فلديهم خطة معدة ومقصودة ومتعمدة لهدم كل شىء فى مصر تمهيدًا للانقضاض علينا فى أى لحظة.
لكننا الآن نعانى من إعلاميين ومثقفين وقادة رأى وأدباء ومبدعين يقومون فى الداخل بنفس الدور، يشيعون اليأس ويصورون ما يحدث على أنه النهاية الحتمية والأكيدة، فكل شىء خرب، وكل ما يقال ليس صحيحًا، وكل جهد لا فائدة منه ولا أهمية له، والمؤسف أن هذا الحفل الهستيرى الذى يقيمه هؤلاء يندمج فيه مواطنون لا دراية كاملة لديهم بما يحدث على الأرض، فيتحول ما يقولون إلى هبد مجرد، يسهمون من خلاله فى تضخيم حالة الفزع التى تحيط بنا جميعًا.
لا يلتفت من يقومون بذلك- بعضهم يفعل ذلك بوعى لصالح أصحاب أهداف ومصالح- أن حالة الفزع التى يصنعونها بمبالغة شديدة، لن تصب أبدًا فى مصلحة استقرار الدولة أو أمنها.
لا يمكننى أن أنكر أن هناك مشاكل كثيرة نعانى منها، لكن لا بد أن ننظر إليها بعين موضوعية، فهى لا تعنى أبدًا أننا نقف على حافة النهاية.
فليس معنى أن يقع حادث على الطريق الإقليمى مهما كانت خسائره وعدد ضحاياه، أن نهيل التراب على كل ما تحقق فى منظومة الطرق والبنية التحتية.
وليس معنى أن يشتعل حريق فى سنترال رمسيس فتهتز منظومة الاتصالات والإنترنت لساعات حتى لو طالت، أن المنظومة الرقمية فى مصر هشة وضعيفة.
ما يحاول الناعقون تأكيده والتركيز عليه هو ما يريده تمامًا من يخططون لإسقاط الدولة، فهل يسهم من نثق فى وطنيتهم فى هدم الدولة وتخريبها.
إننا جميعًا سنخسر إذا تعرضت الدولة لهزة عنيفة، ولن يستفيد من هذه الهزة إلا خصومها الذين ينتظرون على أحر من الجمر أن ينهار من حولنا كل شىء، فهل نقدم لهم ما يريدون على طبق من ذهب؟
إننى لا أدعو إلى الصمت، ولا أصادر على من يرى عيبًا أو خطأ أن يشير إليه، لكن هناك فارق كبير بين من يتحدث وهو يسعى إلى الإصلاح، ومن يفعل ذلك وهو يهيل التراب على كل شىء، وكأنه لم يحدث شىء خلال السنوات التى أعقبت ٣٠ يونيو.
إننى لا أخاف على مصر من التآمر والمؤامرات والتخطيط الخبيث لها، ولكننى أخشى عليه أكثر من الغفلة التى تسيطر على بعض نخبتها، التى اكتشف الناس أنها ليست إلا أبطالًا من ورق... يقودنا الجميع إلى طريق المهالك معتقدين أنهم من المصلحين.
نحتاج إلى وقفة حقيقية مع ما نقوله ونردده.. فما أسهل الكلام.. وما أصعب الفعل.. فهل تتخلى نخبتنا عن الصوت العالى والكلام العشوائى.. أم أنهم يصرون على أن يكونوا سببًا فى نكبتنا؟