وصفة فتحى غانم.. العقل فى مواجهة التخلف الدينى

- لم ينضم فتحى غانم إلى خلية شيوعية ولم ينضم إلى الإخوان رغم أنه ذهب إلى بيت حسن البنا وجلس ليستمع إليه
- قال عن الإخوان والشيوعيين: كانوا يضيقون بى عندما أحاول أن أناقشهم بحرية
- يرى أنه بغير تحكم العقل تتعرض المجتمعات الإسلامية لمخاطر تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقًا سطحيًا ظاهريًا
- المطلوب طبقًا لما يرى غانم هو القدرة السليمة على التفكير
- يرى أن غياب النشاط العقلى عند المواطن المسلم هو السبب المباشر لأزمة الإسلام والسياسة
- اعتمد المصريون على العقل والنظر فى أحوال الكون فوصلوا إلى التوحيد قبل أن يصل إليها الناس بوحى ورسالة من السماء
- يعتبر غانم أن الإسلام هو الدعوة الحقة للعلمانية باعتبار أنه يقدم للإنسان الرؤية الروحية والمادية للحياة
- يتوقف فتحى غانم عند ما يسميه النزعة التدميرية للجماعات الدينية والتى يعتبرها خطرها الأكبر
نعرف الكاتب الكبير فتحى غانم «1924 - 1999» بأكثر من صفة.
فهو الصحفى الذى بدأ حياته الصحفية فى مطابخ الصحف الكبرى وبين أساتذة المهنة الكبار، رافقهم وجالسهم وساهم معهم فى بناء المؤسسات الصحفية بجهد متواصل ودأب لم ينقطع.
وهو رئيس التحرير الذى تولى مسئولية عدة جرائد ومجلات، كان له فيها صولات وجولات ومعارك وإضافات مهنية مهمة، فمن جريدة الجمهورية إلى مجلتى «صباح الخير» و«روزاليوسف».
وهو كاتب المقال الذى كان حادًا ومؤثرًا وحاسمًا فى نشر أفكاره والتعبير عن آرائه، فلم يتردد يومًا عن قول ما يرى أنه صحيح مهما كانت العواقب والتبعات، ولم يخشَ دخول أعتى المعارك الفكرية مهما كان حجم الغبار الذى تثيره من حوله.
وهو أيضًا الأديب الروائى الذى كانت له بصمات واضحة، تحرر من خلالها من أَسْر الصحافة، فتقريبًا هو الصحفى الوحيد الذى لم تؤثر الصحافة على إنتاجه الروائى، بما يجعله يطاول كبار الروائيين قيمة وقامة. شهد له نجيب محفوظ ببراعته، وتعامل معه النقاد على أنه روائى قبل أن يكون صحفيًا، وهو ما ظهر فى رواياته المهمة «الرجل الذى فقد ظله» و«زينب والعرش» و«الأفيال» و«حكاية تو» و«الساخن والبارد» و«قليل من الحب كثير من العنف» و«الرجل المناسب» و«أحمد وداود».
وهو بين كل هذه الصفات، وربما قبلها، المفكر الذى جعل من كتاباته على اختلاف أنواعها منصات لتمكين العقل، وإفساح الطريق أمامه ليسيطر ويحكم، حتى إننا يمكننا التعامل معه على أنه واحد من أهم من وضعوا خريطة للتجديد الدينى، دون أن يقصد ذلك أو يعمد إليه.

وهنا يمكننا الوقوف أمام نصين فى غاية الأهمية.
الأول مقاله الذى نشره فى مجلة «العربى» عدد 1 يناير 1998 وقبل وفاته بعام واحد، فى باب «مرفأ الذاكرة»، وهو المقال الذى يكشف فيه عن ملامح تكوينه الدينى.
والثانى كتابه المهم «أزمة الإسلام مع السياسة»، الذى صدر عن سلسلة «كتاب اليوم» فى يوليو 1998 قبل وفاته بشهور قليلة، وتحديدًا مقدمته التى وضع لها عنوانًا دالًا وكاشفًا وهو «عقولنا.. أين؟».
فى «مرفأ الذاكرة» يكتب فتحى غانم تحت عنوان «مغامرة التفكير الحر»: نشأت فى بيت يهتم بالعلم، وكان يتردد عليه كبار الأدباء والمفكرين، بينهم العقاد وطه حسين وعبدالرزاق السنهورى، وترك لى والدى مكتبة كبيرة حاولت أن أشرع فى مراجعتها وترتيبها على نحو أفهم منه موضوعاتها المختلفة، فكان لذلك تأثير لازم يدفعنى أن أراجع بعقلى كل ما أتعرض له من أفكار، وكانت هناك كتب فى المكتبة تتحدانى، بينها كتب التراث الإسلامى، وقد نبهنى إليها منذ طفولتى أستاذى الأزهرى الذى قرأت معه القرآن وأنا فى الخامسة.
ستأخذنا هنا الكاتبة الكبيرة سناء البيسى بصورتها القلمية الرائعة التى كتبتها عن فتحى غانم بعنوان «قلم لم ينصفه أحد»، ونشرتها فى كتابها «سيرة الحبايب»، فهى تأتى على ذكر أثر القرآن فى حياة فتحى.

تقول سناء: أول علاقة لفتحى غانم مع الكلمات كانت فى سن الخامسة، حين أحضر له والده الشيخ محمد البدوى صديقه ليحفّظه القرآن، فاختار الشيخ بعض السور القصيرة، ثم دخل مباشرة فى سورة «يوسف» «الر، تلك آيات الكتاب المبين».. الر.. كلمة لا تحمل معنى، ولكنها وضعت أمامه بموسيقى تتجاوب معها النفس بصفاء وجدانى من نوع خاص، وبقى فتحى يذكر حوارًا دار بين والده والشيخ محمد حول سورة «يوسف» بالذات، وهل من الصحيح أن يشرح للطفل الصغير العلاقة بين يوسف وامرأة العزيز، وكان فتحى يدرك أن هناك شيئًا غامضًا، وتظل سورة «يوسف» فى وجدانه ليظهر تأثيرها فى أعماله الأدبية التى تبدأ عادة من ذروة أو أزمة ينسج منها شخصياته.
وتنقل سناء عن فتحى ما قاله عن تأثير سورة «يوسف» فى كتابته الأدبية: هناك درس أخذته فى الكتابة الدرامية من قراءتى القرآن الكريم فى سورة «يوسف»، أتذكر دائمًا فى سرد هذه القصة أنها كانت تنتقل من ذروة إلى ذروة مباشرة، بمعنى أن القصة تبدأ بأن يوسف مطلوب منه أن يرحل مع إخوته، وهناك شك حول هذه الرحلة، وننتقل من هذا إلى وضعه فى الجُب ثم إخراجه منه ليدخل قصر العزيز، وننتقل إلى عملية إغراء امرأة العزيز له، ومن هذا إلى وضعه فى السجن، ثم خروجه بتفسيره للأحلام، ثم انتقالًا إلى المجاعة وقصة السنين السمان والعجاف، وطبعًا أنا لا أستطيع أو أجرؤ أن أفكر حتى فى الاقتراب من ذلك، لكنى أتعلم منه على الأقل، إنه يرشدنى إلى أن أفضل الوسائل لتناول القصة مع القارئ هو أن تقدم له دائمًا الذروة، أو خلاصة الأمر فى لحظته الدرامية، ذلك درس مستقر فى أعماقى بشكل قوى وأعتقد أن له تأثيره.
أعود بكم مرة أخرى إلى حديث فتحى غانم عن تكوينه الدينى، فمن بين الكتب التى كان يرى أنها تتحداه فى مكتبة والده «الفصل فى الملل والنحل» للإمام ابن حزم، و«الملل والنحل» للإمام الشهرستانى، وكتاب «تهافت الفلاسفة» للإمام أبى حامد الغزالى.
يقول فتحى: فوجئت بكتاب كبير مترجم بالإنجليزية عن الألمانية لفيلسوف التاريخ «أوزفلد شبنجلر» عنوانه «أفول الغرب»، وكان يتكلم عن الحضارة العربية أو السحرية بين حضارات الفراعنة واليونان والغرب، وكان يذكر أسماء كبار المفكرين المسلمين كالغزالى وابن رشد والبيرونى، ويتكلم عن نشأة الحضارات وازدهارها ثم شيخوختها وموتها، ووجدت فى هذه الحركة لأطوار الحياة ما يجيب عن عدة استفسارات كنت أكتمها فى صدرى عن أسباب أفول الخلافة الإسلامية والهزائم التى انتهت بسقوط الخلافة فى تركيا على يد كمال أتاتورك.
فى هذه الفترة تأثر فتحى غانم بكتاب «رسالة التوحيد» للشيخ محمد عبده، والذى نشره محمد رشيد رضا، وذكر فيه أن ما جاء فى الكتاب لا يجوز ذكره أمام العامة من الناس، وكان يتناول الإيمان وضرورة أن يكون عن طريق العقل، ويسأل ماذا لو فكر الإنسان بعقله فلم يصل إلى اقتناع، هل يموت كافرًا؟ وأجاب عن السؤال بأن الشك ليس كفرًا، لأن عملية التفكير والشك هى الطريق إلى الإيمان الصحيح، فالكفر لا يتحقق إلا بالإنكار والنفى، وجاء فى كتاب «رسالة التوحيد» عشرات الآيات من القرآن الكريم التى تدعو إلى التفكير والتدبر للوصول إلى يقين بوجود الله.
أفادت هذه الكتب فتحى غانم عندما دخل مجتمع الجامعة ليدرس فى كلية الحقوق.
ومن خلال ما كتبه هو يمكننا أن نرسم صورة كاملة لما جرى له بين جدران الجامعة.

ففى كلية الحقوق عرف للمرة الأولى الشباب الشيوعى، وكانت لهم طريقتهم الخاصة لتجنيد الشيوعيين، وهى الدخول فى علاقات شخصية وصداقات حميمة ومناقشات مستمرة فى جو لا يخلو من المرح، وعرف شبابًا من اليهود كانوا يروّجون للأفكار الشيوعية من خلال حفلات الشاى والرحلات والرقص.
وكان هناك تيار آخر قوى يرفع شعارات الإخوان المسلمين، وكان تيارًا مشروعًا ترحب به السراى وتراه يساندها ضد الأحزاب السياسية التى تتبادل الحكم، وكان مسموحًا للشيخ حسن البنا، المرشد العام للإخوان، بأن يلقى محاضرات فى قاعة الاحتفالات الكبرى تحت قبة الجامعة.
حسم فتحى غانم موقفه من هذه التيارات.
يقول: برغم أننى تعرضت لكلا التيارين الإخوانى والشيوعى، فإننى لم أنجذب لهذا أو ذاك، وكان الإحساس الذى يغالبنى هو أنى لا أفهم بالضبط ماذا يريدون، فحفلات الشيوعيين لا تريحنى، وهتافات الحناجر والعروق النافرة للإخوان لا تدعو إلى الاطمئنان.
لم ينضم فتحى غانم إلى خلية شيوعية مع أنه حضر جلسات لخلايا شيوعية.
ولم ينضم إلى الإخوان رغم أنه ذهب إلى بيت حسن البنا وجلس ليستمع إليه.
عن هذا اللقاء يقول غانم: سألنى عن اسمى مرحبًا بى كطالب فى الجامعة يدخل داره لأول مرة، وبهرنى الاجتماع، لكنه لم يصل إلى إقناع عقلى، حتى جاء بعض الأصدقاء يدعوننى إلى اجتماع، فإذا به دعوة إلى تكوين خلية إرهابية، وقد جلست معهم أستمع، أحاول أن أفهم وأقتنع، حتى كانت جلسة ثانية جاء فيها أحد أعضاء الخلية ومعه منشور مطبوع استعدادًا لتوزيعه، ووقف، وهو طالب فى الحقوق، يناقش جدوى الاستمرار فى المشروع ويرى أن الوقت غير مناسب والإمكانات غير متاحة، إلا إذا ارتبطنا بالآخرين أى الشيوعيين أو الإخوان.
كان لنفور فتحى غانم من الشيوعيين والإخوان أساس، يعيده هو إلى الكتب التى قرأها والمناقشات التى شارك فيها، ويسجل سمة مهمة من سمات هذه الجماعات المركوبة فكريًا، عندما يقول: كانوا يضيقون بى عندما أحاول أن أناقشهم بحرية ويتهموننى بأنى شاب مرفّه يتشدق بفلسفات وسفسطات، ويذكر أسماء كتب ومفكرين، لكنه لا يعمل من أجل قضية وطنه، قضية العمال والفلاحين فى نظر الشيوعيين، وقضية عودة أيام مجد الخلفاء الراشدين فى نظر الإخوان.
ورغم نفور فتحى غانم من الإخوان إلا أنه وجد نفسه متهمًا بالتعاطف معهم فى العام ١٩٥٤، وتحديدًا بعد محاولة الجماعة اغتيال عبدالناصر فى حادث المنشية.
كانت الصحف تستقصى كل شىء عن المتهم بمحاولة اغتيال عبدالناصر، وكان فتحى غانم وقتها يعمل فى صحف أخبار اليوم، استدعاه على أمين وكلفه بأن يذهب إلى منزل محمود عبداللطيف ليكتب عن البيئة التى يعيش فيها.

ذهب فتحى إلى حى بولاق، حيث كان يعيش عبداللطيف، وعاد ليكتب عن بيته: سلم فى بيت قديم متآكل، حجرة بها سرير فوقه مفرش كاروهات، مشنة عيش، ترابيزة خشب متواضعة، امرأة صغيرة السن تحمل طفلًا رضيعًا فى عينيها ذهول وخوف شديدان، ومن حولها أعداد ضخمة من رجال الأمن.
قرأ جمال عبدالناصر التقرير الذى كتبه فتحى غانم واتهمه بالتعاطف مع القاتل، أو على الأقل فإن ما كتبه يمكن أن يثير التعاطف معه، وكاد غانم أن يتعرض لمشكلة لولا تدخل على أمين لدى عبدالناصر، حيث شرح له أن الكاتب روائى يغلب عليه الحس الأدبى، وأنه لا يقصد التعاطف مع الإخوان، بل هو ضدهم وينفر منهم، وهو ما جعل عبدالناصر يتراجع عن إلحاق الأذى بفتحى غانم.
من بين الكتب المهمة التى ساعدت فتحى غانم فى بحثه عن حرية العقل كوسيلة لفهم الحياة كتاب المؤرخ الإنحليزى «لورد أكتون» «أبحاث ودراسات تاريخية».
فى هذا الكتاب يشرح «أكتون» مفهوم الليبرالية، وأجاب عن السؤال الذى كان يشغل فتحى غانم، وهو «هل تصل الحرية إلى حد الفوضى؟».
كانت الإجابة أن لله قانونه الطبيعى، أو ما يسمى بالعناية الإلهية التى تتكفل بإصلاح أى خلل يطرأ على الموازين، فالشر إذا طغى قابله الخير، والمرض إذا استشرى تصدت له عوامل المقاومة والشقاء.
يقول فتحى: أعجبتنى هذه الإجابة وأفادنى حديث «أكتون» عن الصلة بين الدين والليبرالية، فى أن أتتبع بعد ذلك موقف التيارات الفكرية الحديثة من قضايا الدين، ولاحظت أنها جميعًا لها موقف تفاهم أو تفسير أو مصالحة مع الدين، وحتى الحداثة وما بعد الحداثة فى أيامنا هذه تقوم على تفسير مفاهيم الدين بالرؤية الجديدة للعلاقات المتشابكة والمراوغة فى حياتنا المعاصرة.
خرج فتحى غانم بتكوينه الليبرالى إلى أن قضيتنا الأولى- لا تزال كذلك بالطبع- هى البحث عن العقل العربى الغائب أو المعطل، فهناك من يهرب إلى فكر غربى، وهناك من يلجأون إلى فكر شرقى، وهناك من اختاروا الراحة فعطلوا العقل ورفضوا التفكير فى انتظار المعجزة أو تصاريف القدر.
يعترف فتحى غانم بأن طلب التفكير الحر ليس مطلبًا سهلًا.
فمن يستطيع أن يحرر أفكاره؟ وكيف؟
ومن يستطيع أن يصدر قرارًا بأن نستخدم عقولنا فى تفكير سليم حر؟

التقى فتحى مدير مكتبة الكونجرس، كان يزور القاهرة ودعاه إلى عشاء فى مطعم بميدان سيدنا الحسين، وكان معهما فى هذا اللقاء المؤرخ الأمريكى «دانيل بروتشتين»، الذى دار بينه وبين غانم هذا الحوار:
دانيل: هل تستطيع أن تقول مثلنا أنا خالق هذا الشىء؟
غانم: الخالق عندنا هو الله، سبحانه وتعالى، وقد نقول هذا من اختراعى وابتكارى واكتشافى، ولكننا لا نقول هذا من خلقى.
دانيل: عالمنا المسيحى يرى أن الإنسان قد خلقه الله على صورته.
غانم: ونحن نفهم ذلك فى الإسلام.
دانيل: لذلك من واجبنا أن نفعل كما يفعل الخالق.
علّق فتحى على هذا الحوار بقوله: هذه صورة من ارتباط التفكير الحر بالدين، وهى ليست واضحة فى أذهاننا منذ إغلاق أبواب الاجتهاد، فهل يعد المسلم ليعرف متى يكون مسيّرًا ومتى يكون مخيّرًا؟
ويعترف فتحى غانم: كان مطلبى منذ البداية هو أن أكون مفكرًا حرًا، ولا شك أن الظروف السياسية والاجتماعية التى مررت بها ما كانت لتسمح بتنمية الفكر الحر الذى يحتاج إلى مناخ عام تسود فيه حرية الرأى على نحو ما زالت قيود كثيرة تمنع تحقيق هذا المناخ، لكننى مارست الفكر الحر بكل حريتى فى أعمالى الروائية.
لم يكن فتحى غانم دقيقًا فيما قاله عن ممارسته التفكير الحر فى رواياته فقط، فقد فعل ذلك فى نصه الثانى المهم، وهو كتاب «أزمة الإسلام مع السياسة».
مقدمة الكتاب قد تكون كافية بالنسبة لنا للتأكد من أنه كان يفكر بشكل حر تمامًا، ولا أبالغ إذا قلت إنها ملهمة لمن يريد أن يعرف كيف يمكن تجديد الخطاب الدينى.
يبدأ غانم مقدمة كتابه بقوله: أخطر قضايانا المستعصية هى قضية العلاقة بين العقل والتفكير الحر من ناحية والعقيدة الدينية من ناحية أخرى، هناك حاجز قائم يعزل العقل عن الدين، مع أن كلمة العقل ومرادفاتها ترددت أكثر من أى كلمة أخرى فى آيات الذكر الحكيم، والذى يتشكك فى ذلك عليه الرجوع إلى معاجم كلمات القرآن، وواضح أن هذه التنبيه المتكرر إلى استخدام العقل والرجوع إليه، سواء فيما يتصل بالإيمان أو يتصل بشئون الحياة، إنما لموازنة الأحكام الكثيرة التى تشكل الأحوال الشخصية والمعاملات المالية والتجارية، وحتى يتنبه العقل الإنسانى إلى أنه مُطالب فى كل وقت باستخدام عقله، ليتبين الظروف الحقيقية الواقعية من حوله، ويسترشد بالمبادئ العامة التى تقوده إلى التصرف السليم.

ويرجع فتحى غاتم إلى تاريخ الدين الإسلامى، ليؤكد أنه دين الحداثة، لأنه قام على تجديد النظرة الدينية إلى العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهو يعترف بأديان السماء التى سبقته، ويكمل بناء العقيدة ويجدده، ولذلك كان من الطبيعى أن يكون العقل هو أساس الإيمان، وكان من الضرورى أن يشعر من يواجه تعاليم الإسلام لأول مرة بأنه يثور ولا يتمرد ولا يرفض الأديان التى سبقت، بل هناك إضافات جاءت من السماء، وهى أساسًا إضافات تقوم على الاعتراف بحقه فى استخدام العقل الذى هو أكبر نعمة منحها الله إياه.
ويقارن فتحى غانم بين عصر الثقافة الذهبى للإسلام، والعصر الذى توقف فيه الاجتهاد.
ففى العصر الذهبى للإسلام وجدنا نهمًا إلى العلم- علوم الفلسفة والمنطق الإغريقية- أعاد المفكر الإسلامى استكشافها، وقدم للإنسانية أرسطو وأفلاطون وكل الفلاسفة الذين صنعوا الثقافة اليونانية، حدث نفس الشىء لعلماء الفرس والهند والصين، فما من عالم درس أى مجال من مجالات الحياة فى الرياضيات أو الكيمياء أو البصريات أو الفلك أو الإدارة إلا وكان يباشر نشاطه فى مجتمع إسلامى يحترم العلم والعقل.
أما فى العصر الذى توقف فيه الاجتهاد وتعطل العقل، فقد انصرف الاهتمام إلى الترف والصراعات بين الرئاسات، فاستقر فى أذهان السلطات الحاكمة أن الله يحفظ المسلمين من كل سوء، وأنهم انتصروا على الصليبيين وعلى التتار، ولن يهزمهم أحد، فلما جاء نابليون بتكنولوجيا عسكرية جديدة، أسقط فى يد العالم الإسلامى، وما زال حتى يومنا هذا يبحث عن مخرج للأزمة التى وقع فيها، ولكنه ينفر من الذين يذكّرونه بأنه خسر معاركه لأنه عطّل عقله، ولم يعد مصدر إشعاع فكرى وثقافى كما كان الأمر أيام أمجاد الماضى.
وعلى عكس كثيرين يعادون الحداثة ويعتبرونها خصمًا للدين، يذهب فتحى غانم إلى أن الحداثة هى استمرار دعم العلاقة بين العقل والدين، بين اكتشافات العلم الحديث والأسس التى جاءت بها العقيدة، ويؤكد أن من بين جميع أديان السماء لا نجد مثل الدين الإسلامى فى حرصه الشديد على هذا الارتباط الوثيق بين العلم والعقيدة.
يرصد غانم ما أطلق عليه انكماش وانغلاق الفكر الدينى، وهو ما يمكننا تسميته «التخلف الدينى»، يقول: ازداد الفكر الإسلامى انكماشًا وانغلاقًا، فأصبح فى حدود ترديد أحاديث من العبادات، وكيف تكون الصلاة، وكيف يكون الحج، وما هى شروط الإفطار فى شهر رمضان؟ وكيف يكون الدخول إلى المسجد أو البيت؟ ومتى تقدم رجلك اليمنى ومتى تقدم اليسرى؟
ويضيف: بدأت مع تكاثر التحديات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية تظهر عقول تريد أن تفكر، من بين شباب بلغ سن الرشد أو كاد، فى مجتمع قامت تقاليده على الفصل بين العقل والتفكير فى الدين، الجوائز لحفظ القرآن وليس لفهمه، والذين يتحدثون فى الدين يتشنجون- معظمهم- ويملون الأحكام ويصدرون التعليمات، وكأن كلامهم حاسم ونهائى، وأغلب السامعين محرومون من القدرة على مناقشة ما يسمعونه، وعليهم الإذعان والخضوع.
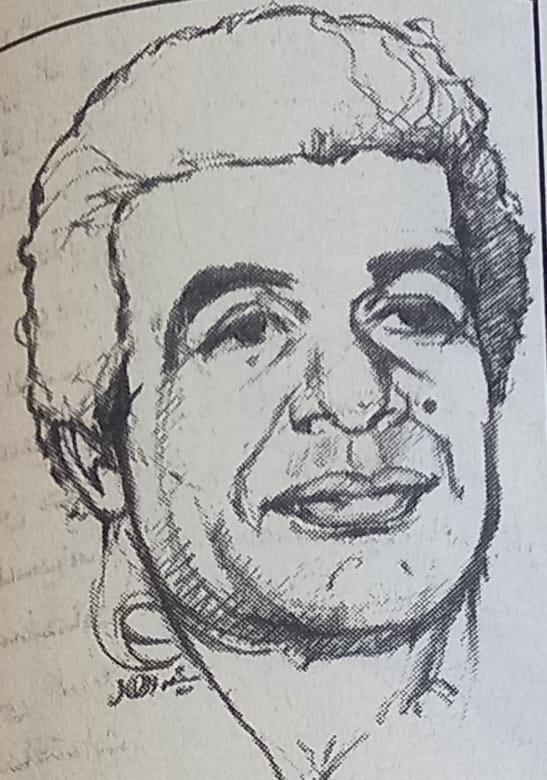
كانت النتيجة الطبيعية لما رصده فتحى غانم أننا أصبحنا نحتشد فى مجتمعات عاجزة تمامًا عن فهم لغة العصر، عاجزة تمامًا عن المشاركة فى العلوم والفنون والابتكارات التكنولوجية التى تعتمد على قدرة التمييز والإدراك والتعامل مع أدوات تتطلب سرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرار- بما فى لمح البصر- وهو أمر لن يتحقق لطفل قضى حياته الأولى يحلم بجائزة حفظ آيات القرآن الكريم، وأصبح الحفظ- لا الفهم- هو السلوك الذى اعتاد عليه.
يرسم لنا فتحى غانم أول ملامح خريطة التجديد عندما يقر بأنه ليس من الإسلام فى شىء إلا نواجه القضايا الأساسية بعقولنا.
ويقول: الإيمان بالله مطلوب أولًا بالعقل، وهذا هو الضمان الأكبر لبقاء الإسلام ولازدهار الإيمان، أن يكون الإيمان بالعقل، وأن يكون مجتمع المؤمنين مجتمع عقلاء، تكون السيادة فيه للعقل أولًا، وتكون للقدرة العقلية للمؤمن حد أدنى من السلامة والأصالة الفطرية، وهى التى تجعل المؤمن قادرًا على التصدى لتحديات عصره، وقضايا زمانه، والتى لا بد أن يستخدم فيها عقله.
ويقفز بنا فتحى غانم إلى قلب المشكلة، فهو يرى أنه بغير تحكم العقل تتعرض المجتمعات الإسلامية لمخاطر تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقًا سطحيًا ظاهريًا، فيتحول هذا التطبيق إلى فرض أحكام جائرة، ومظالم بشعة، وغسيل عقول للشباب، بل للصبية الذين يلقون وقودًا فى حروب باسم الإسلام، وهم ما زالوا أطفالًا دون سن البلوغ.
لا يرفض فتحى غانم تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنه يضع سؤالًا أعتقد أنه منطقى للغاية، وهو: أين العقل الذى تستخدمونه وتواجهون به قضايا التحديث والتحدى الحضارى، وثورة التكنولوجيا، وتخزين المعلومات، والسيطرة على أبعاد مكانية وزمانية على اتساع الكون كله؟
وفى رفع لشأن العقل، يرى غانم أن المسلم الحقيقى إذا لم يهتدِ إلى أهمية العقل، الذى تعلم أن يعرف به ربه الذى لا شريك له، فلن يهتدى أبدًا إلى مشاكل التحديث المعاصرة، ذلك لأنه عرف ربه بأسلوب التقليد والمحاكاة، أو بأسلوب لا عقلانى، فتجاهل الطريق المأمون للحفاظ على الإيمان وازدهاره.
ويرصد فتحى غانم أسباب انجذاب فئات عديدة إلى الدين.
فهناك من ينجذب إلى الدين رغبة فى إثبات الذات، أو شعورًا بالتحدى لمظاهر تستفزه، كارتداء الزى الغربى، أو الكلام بلسان أجنبى، أو ممارسة عادات أجنبية هو بحكم ظروفه التى نشأ فيها يجهل عنها كل شىء.

وهناك من ينحذب مدفوعًا بالإحباط أو اليأس من الحياة بما فيها من مظالم وأحكام تعسفية، فيندفع ناحية الدين عن طريق الغضب والانفعال والرغبة فى الخلاص من المأزق، أو التشفى والانتقام من الظالمين.
ورغم تعدد الأسباب إلا أنها تعبّر فى حقيقتها عن مأساة فقدان الاعتماد على العقل، وأنها لا تمثل تعبيرًا صحيحًا عن الإيمان بالله عن الطريق المأمون، طريق التأمل والتفكير والتبصر بالعقل.
وينتقل بنا فتحى غانم إلى المنطقة الساخنة التى يمكن أن تكون السبب الرئيسى فيما نعانيه من تخلف دينى.
يرى غانم أن هناك مَن يحاول تسييس الدعوة الدينية فيصورها على أنها ليست مجرد رؤية ونظام حياة، بل هى معركة حضارية، ضد أخطار الصهيونية والصليبية والإمبريالية والإلحاد الشيوعى، ثم يضع كل هذه الأخطار فى سلة واحدة هى سلة العلمانية فيهاجمها ويهاجم دعاتها، وكأنهم الطاعون، ويرفض أن يرى فى الدعوة للعلمانية أى احتمال للتفاهم معها، أو يكون صاحب هذه الدعوة من بين المسلمين، مع أن كثيرًا من المسلمين رفعوا شعار العلمانية منذ ثورة ١٩١٩ دون أن يلاقوا مثل هذه الاتهامات الرهيبة ضدهم وإدانتهم بأنهم صهيونيون صليبيون إمبرياليون.
يدافع غانم عن العلمانية بحياد وتجرد، بل ويعتبر أن من ينادى بها عند الشكل ويكتفى بترديد شعارها، هو أيضًا أحد أسباب إثارة الريبة حول شعاره الذى يرفعه، وغالبًا ما يكون هذا الشعار مرتبطًا بالديمقراطية والدعوة لها بمفهوم ليبرالى عام وغامض.
بالنسبة لغانم فلن يمتحن هذه الدعوة إلا العقل الذى يستخدمه المؤمن، حتى يقبل منها ما يقبله، أو يعدل فيها، أو يطورها، أو ينتهى إلى رفضها بناءً على أحكام عقله، لا بناءً على انفعالات تعتمد على استسهال ترديد الشعارات، وإطلاق الأحكام والتلويح بالاتهامات، فقد يكون الذى نأخذه- دون أن تحس إيمان المؤمن- من العلمانية، هو تفسير لها يرتبط بالقوة الصناعية الثالثة، ورؤية تستمد عناصرها من تصور المستقبل، وقدرة على التبصر بما يجرى فى العالم وما فيه من قوى تتربص ببعضها بعضًا، ثم يضاف إلى ذلك خيال فيه رحابة وتفاؤل بالإنسانية، وبملكوت السماء والأرض، كما خلقه الله، وبنظرة فيها براءة طفل وحكمة شيخ وحدس فنان وعقل عالم.
ويخلص فتحى غانم فى مقدمته إلى أن حجر الزاوية فى كل هذا هو العقل، فإذا لم نتمسك به فلا جدال ولا مناقشة ولا دين ولا علمانية ولا ديمقراطية ولا أى شىء، وعندئذ يستطيع من يريد أن يطلق شعارًا دينيًا ويهتف هتافًا دينيًا، فيؤثر فى الجماهير، ويستطيع محرض غاضب حانق ثائر أن يصرخ ويطالب بالانتقام لأى سبب، ويندفع للتدمير والتفجير، ويجد الجماهير تنساق وراءه بغير وعى.
وكنتيجة طبيعية فإن غياب النشاط العقلى عند المواطن المسلم هو السبب المباشر لأزمة الإسلام والسياسة.

فى كتابه يطل فتحى غانم إطلالات سريعة على عدة قضايا، يمكننا أن نتوقف عند بعضها باعتبارها قضايا يمكن من خلال مناقشتها أن نعرف سبب العطب الذى أصاب الخطاب الدينى، ووصوله إلى الحالة المزرية التى هو عليها الآن.
يرصد غانم ما واجهته المجتمعات الإسلامية من هزائم سياسية وعسكرية منذ أيام نابليون بونابرت، وهى الهزائم التى خلفت وراءها رد فعل لدى فريقين.
الفريق الأول ينادى بالإصلاح الدينى وفتح باب الاجتهاد، واتهام المجتمع الإسلامى الذى يزعم بأنه يطبق الشريعة الإسلامية بالجمود والتخلف، وعدم فهم الإسلام كما ينبغى، وتبنى الدعوة إلى التجديد والإصلاح.
والفريق الثانى يطالب بالأخذ بالثقافة الأوروبية، ودراستها وأن نأخذ منها ما يفيدنا، واهتم أغلب هؤلاء بالنظريات والفلسفات الأوروبية، كما لو كانت أوروبا هى هذه النظريات، وليست مجتمعات بشرية، وصلت إلى نظرياتها وحققت فلسفاتها من خلال تجارب بشرية، وأزمات واجهها الناس فى حياتهم اليومية، لا فى صفحات الكتب التى ينقل عنها مفكرونا الكبار.
حدث صراع بين التيارين، وهو ما أصاب المجتمع بازدواج معطل فى الثقافة، لا يسمح بتطوير سليم لهذه الثقافة أو تلك، وكان أخطر وسائل العلاج لهذا الازدواج تلك الدعوة للتوفيق بين الثقافتين، ثقافة إسلامية عربية، وثقافة أوروبية، وهى دعوة شديدة الغموض، لا تفلح فى أغلب الأحوال، إلا فى إخراج مثقفين منافقين أو انتهازيين، يستطيعون الحديث بلغة مزدوجة، وبوجهين، وجه إسلامى أحيانًا، ووجه أوروبى غربى أحيانًا، دون أن تكون هناك أصالة حقيقية لهذا الوجه أو ذاك.
يمسك فتحى غانم بالمشكلة الحقيقية التى يرى أنها لا تبدأ من الثقافة، سواء كانت إسلامية أو أوروبية، وإنما تبدأ من الإنسان ذاته، وهل هو مؤهل لاستخدام ملكاته العقلية، بحيث يستطيع أن يواجه مسئولياته على أى مستوى مواجهة صحيحة.
المطلوب طبقًا لما يرى غانم هو القدرة السليمة على التفكير، وليس المطلوب عملية توفيق بين ثقافتين، أو اللجوء إلى أساليب النعام بدفن رءوسنا فى تراب الماضى وذكرياته، أو اللجوء إلى أساليب القرود، نقلد ما نراه فى المجتمعات الصناعية المتقدمة والمتفوقة عسكريًا وماديًا، دون أن نستوعب معنى التقدم الذى نقلده ونخضعه لما تصلح به حياتنا.
يقف فتحى غانم عند من فقد الثقة تمامًا فى كل هذا، فرفض الحاضر بكل مشاكله وزعم لنفسه أن العلاج فى الدعوة إلى استرداد أيام السلف الصالح، والعودة إلى مجتمع الخلفاء الراشدين.
ويتساءل: ما صلة الدين بهذه الدعوة؟
ويجيب بصراحة: إنها أولًا دعوة مستحيلة، فالماضى لا يعود، وإعادة أيام السلف الصالح ضرب من الوهم، وحنين رومانتيكى ساذج إلى ذكريات مهما كانت روعتها وأمجادها، إلا أنها ستظل مجرد ذكريات، وإذا كان المطلوب هو أن نعود إلى القيم التى تعامل بها السلف الصالح، واتباع قواعد سلوكهم، فالمطلوب أيضًا عودة نفس النماذج البشرية المثالية التى عرفتها مجتمعات ذلك الزمان الذى انقضى، ومن يستطيع أن يسترجع إنسانًا كأبى بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو على بن أبى طالب أو عثمان بن عفان.

ينقضّ فتحى غانم على هذا الطرح فيبدده تمامًا.
يقول: حتى لو استعدنا واسترجعنا هذا المجتمع بشخصياته، وهذا لا يدخل فى باب الدين والإيمان، بل يدخل فى باب تحضير الأرواح، فإننا لا نستطيع أن نستعيد أيام أبى بكر دون أن نستعيد حركات الردة ومسيلمة الكذاب، ولا نستطيع أن نسترجع أيام عمر دون أن نسترجع قاتله، والذين عارضوه، وكرهوا أيامه ومن بينهم مجتمعات إسلامية توارثت هذه الكراهية حتى يومنا هذا، فمن يستطيع أن ينطق باسم عمر فى البصرة بالعراق أو يسمى ابنه باسم عمر فى إيران، وكذلك الذين يحلمون باستعادة أيام على، لن يهربوا من عودة الخوارج والأمويين، والذين سفكوا دماء علىّ وولديه الحسن والحسين وذبحوا أهله وعشيرته، ولا نستطيع أن نستعيد أيام عثمان بن عفان، دون أن نستعيد الفتنة، والنزاع الدموى على توزيع الثروات، ومن هو أحق بأموال المسلمين.
وبحسم يغلق غانم هذا الباب بمنطق واضح فحديت استعادة الماضى ليس حديثًا فى الدين، وهو وهْم مستحيل، وأيضًا وهم خادع ومضلل، يروح ضحيته آلاف من المسلمين، تضيع أيامهم فى انتظار الوهم الذى لن يتحقق، وتتعطل طاقاتهم وتتبدد جهودهم وهم فى حالة الانتظار، والذين ينادون باستعادة الماضى يزيفون التاريخ، ويتجاهلون الأحداث التى جرت، والتناقضات والصراعات التى نشبت والتى واجهها الرسول، عليه السلام، وهو يؤدى رسالته.
يستعيد فتحى غانم أيام الرسول، صلى الله عليه وسلم، ولكن على طريقته.
يضع أيدينا على قصة ذى الخويصرة التميمى الذى ذهب متشنجًا إلى الرسول عليه السلام وقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل.
فقال الرسول، عليه الصلاة والسلام: إن لم أعدل فمن يعدل؟
فعاود اللعين قائلًا للرسول، صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى.
ويعلق غانم على ما فعله ذو الخويصرة، يقول: كأن هذا التميمى المتشنج والمتحمس للعدل يهتم به، ويدافع عن وجه الله تعالى أكثر من الرسول، وهذا مَثل عَلى نموذج معروف فى النفاق.
ويصف الذين يزعمون أنهم قادرون على استعادة أيام السلف وأيام الخلفاء الراشدين بأنهم أشبه بالمنافقين الذين يتظاهرون بالغيرة والحماس، ويطالبون بالمناظر والمواقف التى تستثير الحماس والنشوة، ولو كانت قلوبهم تعرف الإيمان الحقيقى وعقولهم اقتنعت بحقيقة الدين ومنهاجه، لانصرفوا إلى الحاضر يواجهونه بضمائرهم وعقولم المؤمنة، التى لا تتهرب من الواقع الذى سبق وإن هزمها، لا تتهرب من الصاروخ إلى الناقة ومن القنبلة الذرية إلى السيف، فهذا هو الخداع الذى يلغى العقل ويلغى بالتالى الدين، ولا يحفظ منه إلا مشاهد تاريخية يعيش بها الناس مضللين.

وبشجاعة فكرية نادرة يقول فتحى: إن النفاق هو الذى يزين الماضى اليوم، كما لو كانت أيام فجر الإسلام وصدره نعيمًا خالصًا ومجتمعًا نموذجيًا مثاليًا، ولن نستعيد عقولنا حتى نتخلص من هذا الوهم، ولن نتغلب على الهزال الفكرى الذى انتشر بيننا، حتى ندرك أننا فى حاجة إلى عقولنا، وأنها أهم من مجرد تقليد ما قرأناه أو سمعنا به عن أيام مضت، ولن نخرج من ظلمات الجهل والنفاق، حتى ندرك أن التقوى الصحيحة هى تقوى العقل وتلك التى يدعمها العلم، أما تحويل الناس إلى مجرد أنفار وأرقام متشابهة، فى الملبس وفى إطلاق اللحية، وفى ترديد نفس الكلمات والمناداة الصارخة المتشنجة بنفس الشعارات باسم التقى والورع، وتحويل النساء إلى شياطين شهوة، فلا بد من اعتقالها داخل حجاب سميك وإعلان أن مجرد صوت المرأة قد يكون فتنة، والذى يقرر ذلك أى رجل مصاب بهوس أو مرض نفسى، فلن يؤدى هذا إلا إلى تحويل مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات عبيد، سادتهم يعيشون فى قصور باذخة فى الأندلس وشواطئ جنوب فرنسا وإمارة موناكو وقصور هوليوود ودالاس ولاس فيجاس.
وينتهى غانم إلى أن هؤلاء السادة استراحوا تمامًا إلى ما وصل إليه هؤلاء المسلمون، فقد تحولوا إلى إمعات لا تفكر يحكمها باسم الشرع طغاة قساة لهم دعاة متشنجون، يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا هو ما يتمناه أعداء الإسلام التقليديون، وما أكثرهم فى الغرب والشرق!، وما أكثرهم بين من يزعمون نفاقًا أنهم سادة بين المسلمين أو بين العرب!.
تحت عنوان «الإسلام عقيدة علمانية» يقول فتحى غانم: لم تعرف مصر الصراعات الدينية، لا بين أصحاب العقيدة الواحدة ولا بين أصحاب عقائد مختلفة، وهذه الحقيقة واحدة من أهم ملامح العبقرية المصرية، وإذا نظرنا حولنا نظرة جغرافية أو تاريخية سوف نرى مجتمعات أخرى كثيرة، تعرضت لأبشع ألوان الصراع الدينى والمذهبى، واقتتل فيها أصحاب الدين الواحد، وأقاموا المذابح وسفكوا الدماء فيما بينهم، والهجرة الأوروبية إلى أمريكا قامت على عناصر كثيرة من الهاربين من الاضطهاد والمذابح الدينية التى ارتكبتها طوائف مسيحية ضد بعضها بعضًا، مذابح البروتستانت، والهوجنوت والصراع الدموى الذى ما زال قائمًا حتى اليوم فى أيرلندا بين الكاثوليك والبروتستانت، وكذلك عرفت المجتمعات الإسلامية هذه المذابح، سواء بين شيعة وسنة أو غيرهما من الطوائف والفرق الدينية، حتى شاع بين البعض أن هناك حديثًا نبويًا شريفًا، بأن أمة الإسلام سوف تتفرق إلى اثنتين وسبعين فرقة، وفرقة واحدة من بينها، هى التى سوف يكتب لها النجاة أما الباقون فمصيرهم جهنم وبئس المصير.
فى ظل هذه الصراعات كانت مصر مختلفة، وهو ما أشار إليه فتحى غانم، فالذى أنقذ مصر من وجهة نظره من هذه الصراعات الدينية ليس الصدفة ولكنه جهد عبقرى قام به مصريون متحضرون على مستوى رفيع من الثقافة.
فقد سأل المصريون منذ آلاف السنين الأسئلة الهامة التى يسعى إلى معرفة الإجابة عنها كل إنسان يحترم نفسه ويفكر فى لحظات حياته، كلحظات مثمرة منتجة، ولا يفكر فى حياته كموظف فى مكتب فى القاهرة خائف ولا يكسب رضاء رؤسائه بغير النفاق.
سأل المصريون: من الذى خلقنا؟
وكانت الإجابة ومن قبل أن تهبط الرسالات: لا بد أن يكون للكون خالق واحد.
يصف غانم هذه الإجابة بأنها ليست بسيطة ولا سهلة فى عالم تسيطر عليه قوى كثيرة، وتتصارع فيه مصالح متعددة ومتناقضة، مما يشجع كل قوة على أن تختار لها رمزًا يتفق مع مصالحها، وتجعل منه إلهًا تحاول أن تفرضه بالقوة على الآلهة التى يعبدها الآخرون.

جاءت الإجابة المصرية من قبل انتشار الوحى، وتعاليم السماء، لتقول إن خالق الكون هو إله واحد، مع كل ما لا بد أن يترتب على هذه الإجابة من نتائج، منها أن يرتفع البشر، مع استمرار الإيمان بالتوحيد، إلى مدارك النظرة الشاملة للكون، التى تربط بين جميع الأجناس، وكل الحضارات، وتوجه كل الثقافات فى اتجاه مصلحة عليا لجميع البشر، يحكمهم قانون واحد أساسه العدالة، وليس أساسه التفرقة العنصرية، وتمييز أجناس على أجناس، وطبقات على طبقات بناء على مصالح مؤقتة، ولفئة دون فئة أخرى من البشر.
اعتمد المصريون على العقل والتأمل والتفكير والنظر فى أحوال الكون، فوصلوا إلى التوحيد بإجابة مصرية، قبل أن يصل إليها الناس بوحى ورسالة من السماء، ثم هبطت الرسالة توضح الإجابة السابقة وتصححها وتدعمها وتوجهها الوجهة السليمة لكل البشر.
من هنا، كما يرى فتحى، ارتبطت العقيدة الدينية بتراث المصرى الحضارى والثقافى على نحو فريد، ليس له مثيل فى أى مجتمع آخر، فالمصرى يجد فى أعماق شخصيته تلك الإجابة الدينية، على امتداد تاريخ الحضارة فى وادى النيل، والتدين عنصر أساسى فى الشخصية المصرية، تلمسه واضحًا حتى بين الذين لا يمارسون العبادات لسبب أو لآخر، ولا يترددون على المساجد أو الكنائس، نجدهم جميعًا فى قرارة أنفسهم يتعاملون بمفاتيح للنفس كلها قائمة على نظرة التوحيد وعقيدته، فكل شىء عند المصرى بمشيئة الله وبإذنه ورؤيته للكون، وتوقعاته للأحداث سواء على المستوى العام أو الخاص وتصرفاته ومعاملاته، تحكمها عقلية مؤمنة أى مقتنعة اقتناعًا عقليًا بوجود الله ووحدانيته.
ويدخل فتحى غانم إلى رؤيته الواضحة بأن الإسلام دين علمانى من خلال تمهيد واضح بأن الشعور الذى ساد بين المصريين الذين أسلموا فى القرن الأول من الفتح الإسلامى أنهم يستكملون دينهم بتعاليم جديدة متطورة تهتم بأمور الدنيا إلى جانب أمور الدين، أى أن الإسلام كان بمثابة تطور علمانى فى أحد جوانبه لعقيدة المصرى.
من هذه الرؤية يعتبر غانم أن الإسلام هو الدعوة الحقة للعلمانية، باعتبار أنه يقدم للإنسان الرؤية الروحية والمادية للحياة، والنظرة الدينية الدنيوية للوجود، وهى بمعنى آخر النظرة الروحية العلمانية أو الدينية العلمانية، والذين يريدون أن يحدث اشتباك عدائى بين الدنيا والآخرة ويرفضون العلمانية، باعتبارها خروجًا على الدين يعملون بلا وعى على حرمان إضافة حقيقية ولها أهميتها وخطورتها فى العقيدة الدينية التى جاء بها الإسلام، وهى العلمانية، لأن الإسلام يطلب منا أن نستعين بعقولنا فى كل لحظة، والإيمان يزداد وينقص، بقدر ما يحصل عليه العقل من مزيد من المعارف والدراسات فى الكون من حوله فيزداد مع كل معرفة جديدة إيماننا بالله، أى أن العلمانية باهتمامها بالحياة الدنيا وكأننا نعيش أبدًا، هى أيضًا طريق موصل إلى الإيمان بالله.
ويتعرض فتحى غانم فى كتابه «أزمة الإسلام مع السياسة» للجماعات الدينية التى يعتبرها ظاهرة خطيرة، وتحديدًا عندما تتحول إلى جماعات سرية.
وقد نبه إلى ذلك فى روايته الأفيال التى جاء فيها: لما انفجر فى البلاد كالوباء بعد كارثة ١٩٦٧، سقطت هيبة الكبار، والقوة الرهيبة المنتصرة تحولت إلى رماد فى دقائق، وقال الأولاد لأنفسهم أفقنا من خدعة أذلتنا وأهانتنا، وانطلقوا وراء قوى سرية تصدر لهم القرارات وتطالبهم بالطاعة العمياء، وانصاعوا إليها ليتخلصوا من ذل الطاعة العلنية لمن قادوهم إلى الهزيمة، اتجهوا إلى الجماعات السرية بحثًا عن سلطة جديدة أو طمعًا فى الارتباط بسلطة لم تنهزم، أو وصولًا لسلطة تعوض المهانة بأعمال سرية فيها بطش وانتقام واستعلاء.
ويرصد فتحى ما يحدث داخل هذه الجماعات، يقول: الطاعة العمياء هى السمة الأساسية لأعضاء مثل هذه التنظيمات الإرهابية، وهى نتيجة الطبيعة السرية المحكمة لمثل هذه التنظيمات، فعندما يدخل الشاب الجديد فى التنظيم الدينى يكتشف أنه دخل جماعة تحميه وتعوضه عن فقدان سلطة الأب أو القبيلة أو العشيرة التى ينتمى إليها، وعندما يشعر الطالب بأنه محكوم بتعليمات وتوجيهات صادرة عن قيادة، فغالبًا ما تكون لها هيبة السرية، يجد نفسه منتميًا إلى قوة قادرة على حمايته.
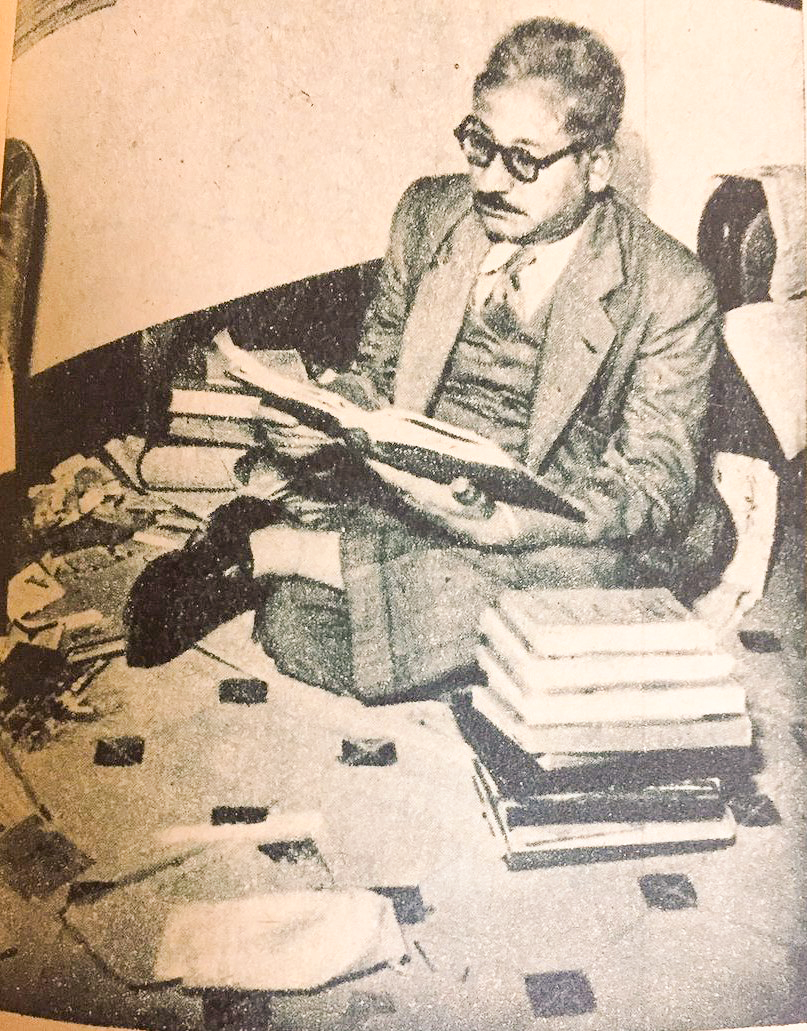
ويضيف: والذين ينضمون إلى الجماعات الدينية تصبح لهم درجات أو مراتب، فأولًا مرتبة المستجيب لمن يدعونه، ثم مرتبة اللاصق الذى أقسم على الارتباط بهم، ثم مرتبة التأنيس والحديث معه عن المضايقات التى يتعرض لها فى الحياة من أهله ومن مجتمعه، وخروج الجميع على أحكام الدين، حتى ترتفع الروح المعنوية عند الشباب ويركبهم الغرور، وعندئذ يدخلونهم فى امتحان السيطرة كاملة عليهم، فبعد أن اطمأن الشاب وأدمن الثقة بأصحابه الملاصقين له يهددونه بالطرد من مجتمعهم، فيشعر بالخوف والضياع ويعلن عن استعداده للقيام بأى شىء من أجل البقاء فى نفس الحظيرة، وعندئذ يتحول إلى مجرد أداة سلمت عقلها وإرادتها لمن يقودها إلى حيث يشاء، وقد خلع الشاب الماضى من حياته كما يخلع الضرس الذى نخره السوس، وقد خضع لعملية جبارة من عمليات غسل المخ، وأصبح واحدًا ممن نراهم اليوم يوزعون منشورات تطالب بإلغاء الديمقراطية والحكم بأوامر خليفة لا ندرى عنه شيئًا يريد أن يحكم المسلمين باسم الإسلام.
ويحذر غانم من التهوين من الأمر، فهناك من يقول إن خطر مثل هذه الجماعات ليس كبيرًا ولا يستحق أن نصوره فى حجم أكبر مما يستحقه، فمثل هذا التحرك باسم الدين عرفته مصر فى كل العصور والعهود، كظاهرة تعلو وتهبط، ولكنها لا تزيد على حجمها التقليدى.
ويستشهد فتحى بما كتبه زكى مبارك فى كتابه «اللغة والدين والتقاليد فى حياة الاستقلال» الذى صدر فى العام ١٩٣٦.
يقول مبارك: إن فى الحاضر عبرة، فقد وجدت فى مصر نفسها فترة دينية يعرفها من يخالط السواد فى الأحياء الشعبية، ويكفى أن يعرف القارئ أن فى القاهرة مساجد يدخلها الناس، ويطرد منها ناس، وأن فى بعض القرى عائلات تتقاطع أبشع التقاطع بفضل الانقسام فى مذاهب الدين، ولست بهذا أوجب أن يقفل باب الاجتهاد، وإنما أوصى لأن تحصر الأبحاث الدينية على البيئات العلمية، وأنصح بأن يحرس العامة حراسة شديدة من المشاركة فى الخلافات المذهبية والدينية، ومن البلاء أن تتكرر المأساة التى وقعت فى شبين الكوم منذ عام، والتى تقع أشباهها فى كل يوم، وإن لم تدون أخبارها فى محاضر البوليس.
ويعلق فتحى غانم على ما قاله زكى مبارك: والآن وبعد نصف قرن لا يذكر أحد ما الذى حدث فى شبين الكوم، وما هى الأحداث التى تكررت والتى لا تدون فى محاضر البوليس، ولكننا نعرف أحداثًا مشابهة تقع فى مصر اليوم، وبعضها لا تذكره محاضر الشرطة، ولكن يبقى أن الظاهرة ليست جديدة، لا تدعو لغرابة أو دهشة، أو كأن الذى يحدث أعجوبة لم نسمع عنها من قبل.

ويتوقف فتحى غانم عند ما يسميه النزعة التدميرية للجماعات الدينية، والتى يعتبرها خطرها الأكبر، يقول عن ذلك: لقد تعودنا فى الماضى، وفى مصر بالذات، على أن يكون الخلاف فى الرأى فى مسائل الدين، لا يخرج الناس من دينهم، ولكن الذى يحدث فى الحاضر، هو أن التطرف فى الرأى، تصاحبه مشاعر يأس وإحباط، وفقدان الرجاء فى أى شىء قد يأتى من هؤلاء الآخرين، الذين لا يتفقون مع الرأى المتطرف ولا يؤيدونه، وغالبًا ما تتحول مشاعر اليأس، إلى طاقة تدميرية، تريد القضاء على كل ما يعترضها، أى يتحول الرأى، فيما قد نتصور أمرًا من أمور الدين، إلى موقف سياسى من نظام الحكم، يسعى إلى فرض نفسه، بوسائل لا صلة لها بالديمقراطية، واحترام الرأى والرأى الآخر، ولا تستمد شرعيتها من إيمان بها قائم على الاقتناع، بل هى آراء واجبة التطبيق والتنفيذ بالقهر والإرهاب المعنوى أحيانًا والمادى أحيانًا أخرى.
إننا لسنا أمام عالم دين، ولا شيخ من شيوخ الأزهر، ولا كاتب يصف نفسه بأنه مفكر إسلامى، ولكننا أمام كاتب صحفى وروائى له مكان ومكانة، قرأ وعرف، خبر الناس بما هم عليه، فحص الحالة الدينية، وخرج لنا بنظرية واضحة لتجديد الخطاب الدينى، أو لنقل التعامل مع مسألة الدين، وهى نظرية تقوم على أن العقل هو السبيل الوحيد لكل تجديد وتطوير وتحديث.
فهل وصلت رسالته؟
أتمنى أن تكون قد وصلت بالفعل.








