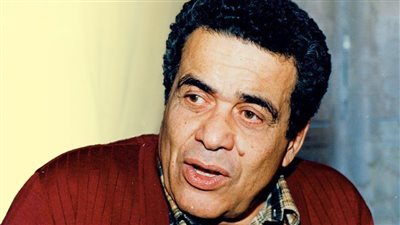كشك وعدوية فى أيام الوعظ والسلطنة.. المغنى ينتصر على الداعية

- حكاية حسن البنا الذى جاءه فى المنام هذه ليست إلا أكذوبة
- كان يجعل من البنا نبيًا أو على الأقل وليًا من أولياء الله يحمل رسائل ويوصلها للناس عبر المنام
- تعامل كشك مع سيد قطب وكأنه أحد المرسلين المكلفين بالدعوة
- حاول صنع بطولة لقاتل وتصنيع أسطورة لمن خالف شرع الله
- صاحب أكبر خطاب غوغائى شهدته مصر فى تاريخها
- صوّر صراعه مع جماعة الإخوان على أنه حرب على الإسلام ورغبة فى إزاحته من الساحة تمامًا
- السادات كان مهتمًا بظاهرة عدوية كما كان مهتمًا بظاهرة كشك تمامًا
- كان كشك وحتى عام 1981 وهو العام الأخير فى حياة الرئيس السادات ضيفًا مرحبًا به فى المناسبات الرسمية
فى عام 2018 انتهيت من كتابى «كشك وعدوية.. أيام الوعظ والسلطنة».
كانت الفكرة بالنسبة لكثيرين ممن تابعوا إعدادى لها مجنونة، مفارقة للمنطق والواقع، إذ كيف لى أن أجمع بين الشيخ عبدالحميد كشك الداعية والواعظ، وبين المطرب أحمد عدوية المغنى الشعبى الذى ظل طوال حياته متهمًا بالابتذال؟
كانت هذه المفارقة وحدها كافية لأن أخترق عليهما عالمهما، فلم يكن كشك فى حقيقته داعية يستحق ما يتعامل به الناس معه من تقدير يصل إلى درجة التقديس، فقد كان يخفى تحت جلده الكثير من الأوهام والأكاذيب، ولم يكن أحمد عدوية هو المطرب المبتذل، فقد أعادت له الأيام اعتباره، وأصبح له قيمته فى سيرة ومسيرة الغناء المصرى.
لم أتجاهل من سألوا عن فكرة الجمع بينهما.
فمن خلال ما جمعته عنهما أجبت على السؤال ببساطة.
فقد كان شخصًا واحدًا، الفارق الوحيد بينهما، أن كلًا منهما سار فى طريق مختلف، جمعت بينهما ظروف النشأة والقدرة على الاختيار والتأثير والشعبية، ولم أكن أعرف أن هناك شيئًا آخر سيجمع بينهما، وهو أن شهرًا واحدًا هو الذى سيشهد الحدث الأخير من حياتهما وهو الموت، فقد توفى كشك فى 6 ديسمبر 1996، وتوفى عدوية فى 29 ديسمبر 2024.
مغرم أنا بالجمع بين الثنائيات التى يعتقد الناس أنها متناقضة، لكنها فى حقيقتها متشابهة وإلى قدر كبير، وكنت قد بدأت رحلة الجمع بين هذه الشخصيات مبكرًا، تقريبًا من بداية رحلتى لإصدار الكتب عام 1996.
ففى عام 1997 صدر كتابى «الشعراوى والسادات.. الدين فى فراش السلطة»، وفى عام 2024 صدر كتابى «هيكل ومبارك.. حروب باردة بين الكاتب والرئيس»، وما بينهما صدرت لى كتب كثيرة تعتمد المقارنات بين ثنائيات كثيرة، إلا أن «كشك وعدوية.. أيام الوعظ والسلطنة» يظل هو الأكثر بريقًا بالنسبة لى، ربما لشدة التناقض بين الشخصيتين.
أعمل الآن على إصدار طبعة جديدة من الكتاب، فقد صدر منذ سنوات، ولأنه لم يعد متاحًا الآن للجميع، فإننى أعيد بعضًا مما كتبته فيه هنا، فى خلال الشهر الذى شهد وفاتهما معًا، وكعادتى لن أوجه من يقرأ إلى شىء، فأمامك ما كتبت، ولك وحدك الحكم عليه.
الأسطورة الزائفة..أكاذيب الشيخ كشك عن حسن البنا؟

قد تُحيط بك الدهشة والاستنكار، وتُسارع إلى اتهامى بالجنون، إذا وجدتنى أسالك: أيهما أكثر تدينًا من الآخر.. الشيخ كشك أم المطرب أحمد عدوية؟
لن تجيبنى على سؤالى، أليس كذلك؟
وإذا حاولت أن تفعل ذلك، فحتمًا ستسبق أى كلام لك بالاستغفار، وربما تطلب لى الهداية وتطالبنى بأن أستغفر الله عن مجرد طرح الفكرة.
لكن ما رأيك أن نتحدث معًا بالمنطق؟ واسمح لى أن أضع أمامك سؤالًا آخر: ما الذى يجعلك تستبعد أن يكون أحمد عدوية أكثر تدينًا وقربًا إلى الله من الشيخ عبدالحميد كشك؟
هل لأن كشك كان واعظًا وعدوية كان مغنيًا؟
هل لأن كشك كان يعمل فى المساجد ويتحدث إلى الناس من فوق المنابر، وعدوية يعمل فى الأفراح والكباريهات ويغنى من فوق المسارح؟
هل لأن كشك كان يعظ الناس بما قاله الله وقاله الرسول، وعدوية يغنى كلمات يعتبرها البعض هابطة ومبتذلة؟
هل لأن كشك كان يستعرض على الناس بطاعته لله وعمله لخدمة الإسلام باعتباره مبلغًا لرسالات الله كما قال هو، وعدوية لا يرجو من الله إلا الرحمة والمغفرة والغفران؟
يمكن أن نشير إلى مقارنات كثيرة بين الواعظ والمغنى، وكلها تبدو من ظاهر القول فى مصلحة الشيخ وضد المطرب، لكن ولأن الله أعلم بالنوايا ومُطلع على السرائر، فلا يمكننا أن نجزم نحن بشىء، لا يمكننا أن نقول كشك أقرب إلى الله من عدوية، أو أن عدوية أفضل عند الله من كشك، كلها أمور غيبية لا نستطيع أن نتدخل فيها، وقد يكون من حقنا فقط أن نتساءل، أو نقول ما نعتقد أنه منطقى.
فأن تكون عالمًا فى الدين فهذا لا يعنى أنك أكثر تقوى من الآخرين.
عندما تكون حافظًا للقرآن ومطلعًا على سنة وسيرة النبى محمد «صلى الله عليه وسلم»، ومتبحرًا فى العلوم الشرعية المختلفة، وتستخدم هذا كله فى وعظ الناس وتعريفهم بأمور دينهم، لا يعنى ذلك أنك أكثر منهم إيمانًا أو تقوى أو قربًا أو حظوة عند الله، ولكن يعنى فقط أنك أكثر علمًا منهم، والعلم فى نهايته وظيفة يمكن ألا تؤهلك من الأساس لتدخل رحمة الله، فى الوقت الذى قد يكون أمامك عبد لا يكاد يفقه شيئًا مما تقوله، يكون أفضل عند الله كثيرًا منك، لأنه يعرف الله حق المعرفة، ولأنه يؤدى ما عليه لله دون أن يمن عليه بطاعته له.
هل أدلكم على طريق آخر يمكن أن نسير عليه ونحن نبحث عن إجابة لتساؤلاتنا عن أيهما أقرب إلى الله كشك أم عدوية؟
هذا الطريق هو طريق الإخلاص، فأيهما كان يعمل مخلصًا لله، لم يكن ما فعله كشك كله لوجه الله، كان يقصد به خدمة جماعات أخذت من الإسلام مطية لتحقيق أهدافها، أما عدوية فأغلب الظن أنه كان يحاول أن يسعد الناس وأجره على الله، صحيح أنه كون ثروة هائلة من غنائه، وإدخاله السرور على قلوب الناس، لكنه لم يتطاول على أحد، ولم ينصب نفسه حكمًا على دين الناس وقربهم من الله، كما فعل كشك.
لا أفارق الواقع أو ما جرى على الأرض عندما أقول لكم إن كشك لم يكن داعية فى مدرسة محمد «صلى الله عليه وسلم» كما كان يدّعى ويخدع الناس، بل كان داعية فى مدرسة الإخوان، وكان دجالهم الأكبر حسن البنا هو مرشده وقدوته الذى يسير على خطوه وخطوته وطريقه وطريقته، ولا يمكن أن أتجاهل الدور الذى لعبه كشك مستغلًا منبره وغفلة الناس فى تحويل حسن البنا من مجرد إرهابى أسس جماعة إرهابية إلى أسطورة إيمانية.
فى واحدة من خطبه التى كان يتحدث فيها كشك عن اغتيال حسن البنا، قال نصًا: «فى اليوم الثانى عشر من فبراير ١٩٤٩، فى مساء هذا اليوم انطلقت رصاصات مجرمة آثمة إلى صدر رجل امتلأ قلبه يقينًا بالله، وفى أحد شوارع القاهرة انطلقت الرصاصات فى صدر الإمام الشهيد مجدد شباب الإسلام حسن البنا رضى الله عنه».
ويتساءل كشك بحماس -ما زلت أحسده عليه كلما سمعته وهو يردد هراءه- لماذا حسن البنا بالذات؟ لماذا اغتيل حسن البنا بالذات؟
ويجيب الشيخ الذى يسيطر التضليل على نبرات صوته: جرى له ذلك لأنه وقف فى مدينة الإسماعيلية سنة ١٩٢٨ وفى حشد حاشد ورفع المصحف بيمينه ونادى على المسلمين: الطريق ها هنا، كلمة ما قال غيرها، وكان الرجل صادقًا فيها، ودعا إلى الله ٢٠ عامًا فى مصر وخارجها، فانضوى تحت لوائه ٣ ملايين من المسلمين، اجتمع أصحاب البرانيط واجتمع قادة الصهيونية، لأنه قاد الجيوش إلى فلسطين، وقاتل اليهود تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فاليهود لا يخافون أسلحتنا ولا دباباتنا ولكنهم يخافون من سلاح «لا إله إلا الله»، لأنهم أهل عقيدة ولا يخافون إلا من أهل العقيدة.
فى هذه العبارات القصيرة تتجسد كل جرائم الشيخ كشك، وتجعل منه المروج الشعبى الأول لجماعة الإخوان، ولأنه كان رسول الجماعة إلى عامة الناس، فقد خدعهم بأدائه وبعموميات كان يسوقها إليهم، وهو يعرف أنهم لن يفكروا فيها على الإطلاق.
فحسن البنا لم يقتل لأنه قال للمسلمين وهو يرفع القرآن بيمينه: الطريق ها هنا.
ولكنه اغتيل لأنه كان جزءًا من الحياة السياسية فى مصر، وهى حياة كانت تقوم على الصراع بين فرقاء على السلطة، ثم إن اغتياله تم ردًا على اغتيال جماعته بتحريض مباشر منه لرئيس وزراء مصر محمود فهمى النقراشى، وبحكم هذه الجماعات وبعقليتها، فإن حسن البنا قتل قصاصًا، لكن كشك روج لأسطورة أن مؤسس الجماعة اغتيل لأنه كان فقط يدعو إلى الإسلام.
من بين الضلال الذى روجه كشك عن حسن البنا محاولة تقديس مؤسس الجماعة الضالة.
فرغم أن البنا لم يكن أكثر من مؤسس جماعة سياسية أخذت من الدين ستارًا لتنفيذ كل أهدافها، إلا أن كشك وضعه فى مرتبة «النبى صلى الله عليه وسلم»، وإلا فبماذا نفسر قوله إن البنا انضوى تحت لوائه ٣ ملايين مسلم، فهل كان لحسن البنا لواء، وهل هناك لواء أصلًا غير لواء النبى محمد؟
كنت أتعجب من سلوك الإخوان الذين يتعاملون مع حسن البنا وكأنه نبى مرسل من الله، وأن دعوته دعوة سماوية، لكن عندما كنت أقرأ ما يكتبه الإخوان عنه يزول تعجبى، ولم يخرج كشك فى قليل أو كثير عما فعله الإخوان مع دجالهم الكبير الذين ينظرون إليه بقداسة أعتقد أنهم لا يقدمونها بين يدى النبى محمد وهم يتحدثون عنه.
تضليل كشك ينصرف إلى أن حسن البنا قاد الجيوش إلى فلسطين، مرددًا أكاذيب الجماعة عن دورها فى حرب ٤٨، والسؤال عن أى جيوش يتحدث هذا الواهم؟
لقد خدعت الجماعة ملايين من العرب والمسلمين بحديث عن دورها فى الحرب ضد اليهود، وأن لها شهداء وأبطالًا وفرسانًا هناك، رغم أننا لا نعرف غير بعض المتطوعين الذين ذهبوا إلى فلسطين، ولم يكن الهدف أرض الله الطاهرة، ولكن حسن البنا رأى إيفاد أبناء جماعته لتدريبهم على المعارك الحية، لأن معركته الأساسية كانت هنا فى مصر، وهى الوصول إلى السلطة، ولم يكن هناك شىء غير ذلك على الإطلاق.
الضلالة الكبرى التى مارسها كشك وهو يتحدث عن حسن البنا كانت فى كلمته أن الصهاينة اجتمعوا لاغتيال حسن البنا، وشفع ذلك بقوله إن «اليهود لا يخافون الأسلحة أو الدبابات ولكنهم يخافون من لا إله إلا الله محمد رسول الله».
لا يمكن لأحد منا أن يزايد على «لا إله إلا الله»، لكن الشيخ كشك وحده من كان يزايد عليها، بل وكان يخدع الناس بها، ويسوقهم بعيدًا عن أسباب القوة، فليس صحيحًا أن اليهود لا يخافون من الدبابات أو السلاح، ولكنهم يخافون فقط من سلاح «لا إله إلا الله».
كان كشك مثل غيره من الدعاة والوعاظ يحبطون الناس ويثبطون عزائمهم، فلا يمكن أن نقاتل بسلاح «لا إله إلا الله» وحده، لا يمكن أن نذهب إلى أى معركة دون أن تكون لدينا أسباب للنصر، بدونها لا يمكن أن ينصرنا الله، أو يجعل يده خلف ظهورنا.
حاول كشك أن يبرئ نفسه مرة، أراد أن يقول للناس إنه لم يقابل حسن البنا ولم يجلس إليه، وهذا طبيعى، فالواعظ لم يصل القاهرة تقريبًا إلا بعد مقتل حسن البنا، وكأنه يقول للناس إنه واعظ موضوعى، ومن خلال موضوعيته المزعومة يستطيع أن يمرر أى وكل شىء.
فى خطبته رقم ٣٠٥ التى ألقاها فى ١٦ ديسمبر ١٩٧٩، قال كشك لمستمعيه: «وأقسم لكم بالله أننى إذا تكلمت عن حسن البنا، إنما أتكلم عن جهاده وسيرته العاطرة وأنا لم أره ولم أسمعه فى حياتى، وحتى لا أكون حانثًا فى يمينى ما رأيته إلا مرة واحدة فى المنام».
ويسأل كشك بطريقته التى يقصد بها التشويق: أتدرون ليلة ماذا؟
ويجيب هو: ليلة الجمعة يوم أن انقطع التيار الكهربائى هنا بعد عشر دقائق من الخطبة، رأيت ليلتها الشهيد قبل أن آتى إلى صلاة الجمعة، ولما استقبلنى جلست أمامه فسمعته يقرأ فى أذنى سورة الأنفال، وفى سورة الأنفال قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا للَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، قلت لابد أن فى الأمر حدثًا سيحدث، فإن سورة الأنفال تتكلم عن معركة وشدة من الشدائد، وصعدت المنبر يومها، وانقطعت الكهرباء بعد عشر دقائق والله أعلم مَنْ قطعها.
تذكرون ما قاله كشك بعد هذه الخطبة التى يعتقد أن هناك من قطع عن المسجد الكهرباء حتى لا يتيح له فرصة الحديث مع جمهوره، ادعى أن أجهزة الأمن تدس جواسيس من الكفرة بين المصلين، وقال إفكًا إنهم أمسكوا بشاب مسيحى بين المصلين، حتى ينقل أخبارهم.
وأعتقد أن حكاية حسن البنا الذى جاءه فى المنام هذه ليست إلا أكذوبة وإفكًا أيضًا، ولا أدرى كيف عرف كشك أن من زاره فى المنام هو حسن البنا بشحمه ولحمه، إنه لم يره، وطبيعى أنه لم يتطلع إلى صوره، فهل قدم البنا نفسه للشيخ فى المنام قبل أن يتحدث ويهمس فى أذنه بآية سورة الأنفال؟
على أية حال كانت هذه حيلة من حيل كشك، للترويج لحسن البنا، الذى يجعل منه نبيًا أو على الأقل وليًا من أولياء الله يحمل رسائل، ويوصلها للناس عبر المنام، ولم يخطر على بال كشك أنه كان على باطل كما كان حسن البنا نفسه على باطل.
جذور الإخوانية فى نفس وروح كشك كانت متأصلة، إعحابه بسيرة حسن البنا بدت لى مبكرًا، وأنا أطالع مذكراته، فعندما دعى ليلقى محاضرة على عمال أحد المصانع، تذكر حسن البنا وأثنى عليه، دون أن يذكر اسمه قال عنه نصًا: لقد كان أحد رجال الدعوة وهو من الأفذاذ العباقرة، كان يقتحم على الناس فى المقاهى مجالسهم، ويقدم لهم الدروس والمواعظ، فكانت دعوته تجد آذانًا صاغية وقلوبًا واعية فتتمكن من النفوس فضل تمكن.
لقد قدم كشك لجماعة الإخوان أعظم خدمة فى تاريخها، لم يقم بغسل تاريخ حسن البنا القذر فقط، ولكنه صدّره كصاحب رسالة فى الحياة، وكان يؤكد طول الوقت أنه ما قُتل إلا لأنه كان ينصر الإسلام، عازفًا بذلك على وتر عاطفى حساس جدًا، ولأنه كان صاحب خيال واسع للغاية، فقد استخدم كل ما لديه من إمكانات دعائية لرسم صورة براقة لهذا الذى مات قاتلًا، لكن أصرت جماعته على أنه كان شهيدًا.
فى الخطبة رقم ٣٧٨ التى ألقاها كشك فى ٢٨ أغسطس ١٩٨٠، قال عن البنا، وأرجو أن تنتبهوا إلى الحالة الدرامية الجبارة التى نسجها الشيخ، هادفًا من خلالها احتلال قلوب مستمعيه من البسطاء.
يقول: حُمل جثمان البنا إلى بيته، وصدرت الأوامر ألا يغسله أحد، أتدرون من الذى غسل جثمان البنا؟ إن الذى غسل جثمان البنا هو أبوه، فقد مات وهو فى ريعان الشباب، كان عنده من العمر ثلاث وأربعون سنة، ملأ فيها الأرض علمًا وهدى وإرشادًا.
ولأن الأسطورة لا تكتمل إلا بالأكاذيب، يصر كشك على أن يقول: لقد سيّر إلى ميدان فلسطين عشرينًا شابًا مدربًا على حمل السلاح، جعلوا من اليهود نعاجًا، جعلوا من اليهود فئرانًا وجرذانًا.
كلام مطلق لا دليل عليه، لكن كشك كان يحلو له أن يردده بحماس وقوة، لأنه كان يعرف ما يفعله جيدًا، ويكفى أن تعرفوا أن خطب كشك التى كان يأتى فيها على سيرة حسن البنا وسيد قطب، جعلت آلاف الشباب يدخلون إلى الجماعة الإرهابية عن طيب خاطر، معتقدين أن الواعظ الذى يبدو متجردًا يسوقهم إلى الخير رغم أنه كان يسوقهم إلى الجحيم الكامل.
هذه مرة ثالثة سأجعلها أخيرة هنا، رغم أن كشك تحدث عن البنا كثيرًا.
الخطبة ألقيت فى ١٣ فبراير ١٩٨١، جاء فيها كشك عرضًا على البنا، قال عنه: لماذا اغتيل حسن البنا رضى الله عنه «كان يستخدم هذه الصيغة كلما تحدث عن مؤسس جماعة الإخوان» معتبرًا إياه - كذبًا وزورًا - من الصحابة أو التابعين أو الأولياء؟
ويجيب كشك مضللًا ومدلسًا، يقول: لأنه فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، فهم الإسلام على أنه دين ودولة، عقيدة وشريعة ومسجد وقيادة وعبادة وريادة، فلما علم الشرق والغرب أن هذا الرجل خطير على مصالحه كان لابد من القضاء عليه.
هل رأيتم تضليلًا أكثر من ذلك؟
تجاهل كشك أن حسن البنا أسس عصابة تداخلت فى السياسة، واغتالت قضاة وسياسيين، تحالفت مع الملك ثم انقلبت عليه، تودد البنا نفسه إلى السياسيين، وأبدى استعداده الكامل للتعاون معهم، وفى كل مرة كان تتبدى نوايا الجماعة يتم لفظها على الفور، وحاول إيهام مستمعيه أن البنا قُتل فقط لأنه كان يريد نصرة الإسلام، وهو السبب الذى كان كشك ينتزع به آهات الإعجاب ليس له فقط، ولكن لشخصية البنا القاتل.
ستقول لى هل من المنطقى أن يفعل كشك كل ذلك للجماعة دون أن يكون عضوًا فيها؟ فلم نعرف أنه أقسم يمين الولاء للمرشد، ولم نعرف أنه كان أحد قياداتها؟
سأقول لك: كان كشك أهم لدى الجماعة من قياداتها الرسميين المعلنين المعروفين، لأنه كان المتحدث غير الرسمى باسمها، استغلوا شهرته واسمه وتأثيره حتى يحشد الناس فى اتجاههم، ودون أن يتم تجريح شهادته بشىء، فلو عرف الناس حقيقة علاقته بالجماعة لعزف كثيرون منهم عنه وعما يقوله، لكنهم جلسوا إليه وهو يدعو إلى الاسلام، رغم أنه كان فعليًا لم يكن يدعو إلا إلى الإخوان.
حادت الجماعة مرة واحدة عن منهج اخفائها لكشك كداعية لها، وعندما قررت دخول معركة انتخابات مجلس الشعب فى العام ١٩٨٤ عرضت عليه -وكان وقتها حبيس بيته - أن يرشح نفسه على قوائمها ليكون عضوًا فى البرلمان ممثلًا لها، لكنه رفض.
سُئل كشك عن موقفه فقال نصًا: لم أدخل هذه التجربة لأنى أعتبر نفسى جنديًا يعمل فى مجال الدعوة، وهو مجال يقتضى أن أكون متفرغًا للقراءة والكتابة والدعوة إلى الله.
كان كشك يعرف أهمية وقيمة ما يفعله للجماعة التى آمن بها وبأهدافها، وكان يساندها فى الانتشار والتمدد والسيطرة على عقول الناس، وليته كان يفعل ذلك بالحقائق، لكنه فعله بالأباطيل والأكاذيب والأراجيف التى سيحاسبه الله عليها حسابًا عسيرًا.
أتدرون ما هو الذنب الأعظم بالنسبة لى على الأقل، إنه أن يزكى أحدهم نفسه على الله، يمنح نفسه فى ساحة الإيمان ما ليس فيه ثم يتطاول على الناس بذلك، وهو ما كان يفعله كشك وباحترافية شديدة.
لا أستطيع أن أمنع عدوية من التعليق على هذا الموقف الهزلى، واعظ مضلل يدعو من على المنبر لرئيس عصابة ومؤسس «جماعة الإرهابية»، ولا تعليق مناسب على هذا الموقف العبثى إلا أغنية عدوية الشهيرة «اللى اختشوا ماتوا»، وهى الأغنية التى كتبها يحيى مرسى ولحنها مصطفى شكرى.
يغنى عدوية: الليل يقول للنهار ليه بالعجل طالع/ وشال الناس همومها قبل ما تطلع/ صحيح اللى اختشوا ماتوا من باع نص حياته/ يدى لغيره كتر خيره/ يبقى طبيعى يعيد حساباته/ وأنا حساباتى معاكو مفيهاش إلا أذاكوا/ أعاتب مين وأكلم مين دول ناس ضمايرهم ماتوا.
المضلل الكبيــر.. كشك يصنع بطولة زائفة للأب الروحى للتكفير
لم أفارق الواقع أبدًا عندما قلت إن كشك لم يكن إلا دجالًا دافع عن إرهابى هو حسن البنا.
ولن أفارق الواقع أيضًا عندما أقول هنا إن كشك مارس كل ألوان النصب الدينى والنفسى والسياسى أيضًا وهو يرسم صورة سيد قطب.
واقعيًا لا يمكن أن ننظر إلى سيد قطب على أنه مجرد كاتب أو أديب أو مفكر أو مفسر للقرآن أو صاحب دراسات يعتبرها البعض مهمة، لأنه ورغم إنجازه ذلك كان الأب الروحى لجماعات القتل والتكفير والتفجير، ما يجعل إنجازه الفكرى بالنسبة لى وبالنسبة لكثيرين غيرى بلا قيمة، إذ كيف يستقيم لإنسان أن يكون مبدعًا وقاتلًا فى وقت واحد.
كان سيد قطب شخصية بغيضة، جمع فى قلبه كل أشكال الدونية والأنانية والغيرة والحقد والحسد تجاه كل الناس، كان يعتقد أنه يستحق أن يكون قائدًا أو رئيسًا أو ملكًا أو خليفة، ولما لم يحصل على شىء من ذلك، تحول إلى قنبلة كراهية انفجرت فى وجه العالم كله، قرر أن يدفع الجميع ثمن فشله وإخفاقه.
كان إعدام سيد قطب خطأ، ما فى ذلك شك.
لا أقول ذلك لأنه كان مظلومًا، ولكن لأن إعدامه منحه شرعية البقاء، وعبر جماعات مهووسة بالكراهية هى الأخرى، أصبح نبيًا مرسلًا بالنسبة لهم، ليس مهمًا أنه نبى القسوة، والأنبياء ليسوا قساة أبدًا، لكنه أصبح نبيًا والسلام.
هل أنقل لكم صورة أتخيلها كثيرًا عن سيد قطب، رسخت فى ذهنى بعد أن قرأت كثيرًا مما كتبه وما كتب عنه.
أتخيل أن سيد قطب يطل على العالم الآن من الجحيم، ورغم العذاب الذى يلقاه، إلا أنه سعيد بما يحدث بسبب أفكاره، كل قطرة دم تسال بسبب كلمة كتبها تنعشه، كل روح تنزع من جسد صاحبها عنوة بسبب رأى دونه تمنحه فرحة خاصة، كل أرض يحيط بها الخراب تمنحه شهادة بأنه نجح؛ لذلك فهو دائم الابتسام، وربما يكون دائم السخرية أيضًا من هؤلاء الذين يعتقدون أنهم أحق بحكم العالم، رغم أنهم بلا مستقبل، فمصيرهم مثله، سيقتلون أيضًا، لكن الفارق أن دماءهم بلا ثمن، أما هو فقد أصبح خالدًا.
ما الذى أدخل سيد قطب على خط كشك وعدوية؟
لا أعرف على وجه الدقة أين كان أحمد عدوية عندما كان سيد قطب يخطط ويدبر لقلب نظام الحكم؟
ما الذى كان يفعله المغنى فى نفس الليالى الطويلة التى كان يجلس فيها الإرهابى الأعظم مع رفاق خطته وتدبيره يلقنهم أدوارهم التخريبية؟
أين كان عدوية فى الليلة التى اعتقل فيها سيد قطب؟
وقتها كنا فى العام ١٩٦٥، تحديدًا فى ٢٩ أغسطس.
لم يكن عدوية قد بلغ العشرين من عمره، ووقتها أيضًا كان لا يزال فى رحلة البحث عن نفسه، هناك من يقول إنه لم يأت من بلدته فى المنيا إلا وعمره عشرون عامًا، وبحسبة بسيطة يعنى ذلك أنه أتى فى العام ١٩٦٩، لكن مجريات حياته تقول إنه أتى إلى القاهرة قبل سنوات طويلة، عاش فى شارع محمد على، وجلس على مقاهيه، وعمل مع فرقه، فى انتظار الفرصة التى يحصل من خلالها على كل حقوقه فى الحياة.
قد لا يذكر عدوية ما الذى فعله بالضبط فى هذه الليلة، لكن حياته تقول لنا إنه كان هناك، واحد ضمن جلسة فى قهوة يغنى أو يستمع فيها إلى ما يحبه، أو يعزف فى فرح وراء راقصة ينتظر أن تنتهى الليلة حتى يحصل على أجره، أو كان ليلتها بالتحديد عاطلًا عن العمل، لا يجد ما يفعله، فتسكع هو وأصدقاؤه فى شوارع القاهرة الواسعة، الذى لم يكن يتخيل أنه يمكن أن يكون واحدًا من ملوكها بعد سنوات قليلة.
وقد تلومنى على هذه المقارنة، فكيف أقارن من كتب «فى ظلال القرآن»، بمن غنى «السح الدح أمبو»؟
من أرضية موضوعية بحتة ومجردة أقول لك، إن عدوية عندى أفضل وأكرم من سيد قطب، وهذا رأى لا يحكمه الهوى ولا المزاج، بقدر ما يحكمه ما قدمه كل منهما للبشرية، ما الذى استفدناه مما كتبه قطب غير القتل والدماء والخراب والنزاع والشقاق، لكن عدوية على الأقل يمكن أن يدخل الفرحة أو البهجة على قلب شخص واحد بعد أن يسمعه يغنى، وهذا يكفيه جدًا ويكفينا جدًا منه.
على عكس عدوية كان كشك متورطًا، صحيح أنه لم يكن قد وصل إلى قدر كبير من النجومية، مجرد واعظ فى مسجد «عين الحياة» الذى انتقل له منذ أقل من عامين، ميوله الإخوانية واضحة، لم تكن تخفى على أحد، وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية، التى أدركت أن هناك تنظيمات تحاول إحياء فكر «الإخوان» ودعوتها.
حاول كشك أن يوحى لمتابعيه بأنه اعتقل فى العام ١٩٦٦؛ لأنه رفض أن يحل دم سيد قطب، بعد أن طلب عبدالحكيم عامر منه ذلك عبر وسطاء.
روى كشك هذه الواقعة فى مذكراته، ورواها وهو فوق المنبر أكثر من مرة.
فى خطبته رقم ٣٩٣ التى ألقاها فى ٥ ديسمبر ١٩٨٠، قال: فوجئت باثنين يطرقان على بابى وقت الظهر، وفتحت الباب وجلست معهما وعرفانى بنفسيهما، إنهما يعملان فى مكتب المشير، أى أنهما من رجال المخابرات، وماذا يريدان منى؟ فقالا لى: إنا جئناك من قبل الزعيم والمشير وإنهما يطلبان منك كلمة واحدة تقولها يوم الجمعة للمصلين، وبعدها سترى المنح والدرجات والمكافآت والمنصب المرموق وجلست أستمع، وكان اليوم يوم خميس، وأنا أهيئ نفسى للوقوف بين يدى الله يوم الجمعة، وقلت: وما تكون تلك الكلمة؟ فقالا لى: أن تعلن على المصلين أن سيد قطب يستحق الإعدام والقتل.
سألهما كشك كما يدعى: وإذا لم أفعل ماذا تكون النتيجة؟
قالا له: أنت تعلم النتيجة، فاستسغفر منهما الشيخ: هل النتيجة أن أذهب إلى الجحيم؟
فقالا: نحن لا نملك جهنم إنما نملك السجون؟
لم يفعل كشك ما طلب منه، ويكمل روايته: مضى أسبوع ويوم الخميس الذى بعده، كان البيت يفتش فى الساعة الثانية ولم يجد المفتش إلا مصحفًا، ما رأى شيئًا يستطيع أن يحاكمنى به إنما وجد مصحفًا، فلما امتلأ غيظًا رمى المصحف فى الشارع، فقلت له: إنك لا ترمى كتابى، إنما ترمى كتاب من لا يغفل ولا ينام.
كان الشيخ كشك كاذبًا تمامًا فى روايته تلك، ليس لأنى سمعت الرواية الحقيقية من أحد، ولكن لأنه فى كل مرة كان يروى الحكاية، تأتى بطريقة مختلفة وبتفاصيل متناقضة، يضيف ويحذف، وكل ذلك بغرض تثمين ما لديه.

قبل ما يقرب من ٧ أشهر، وبعد أيام من اعتقال سيد قطب، تم القبض على كشك ولمدة لا تزيد على ساعات قليلة، لكن هذه المرة كان قطب حاضرًا، يقول كشك عن هذه الواقعة، ذات يوم من أيام شهر أغسطس عام ٦٥، فوجئت بالباب يطرق طرقات عنيفة، وبمجرد أن فتح الباب دخل جماعة غلاظ شداد وقاموا بعملية التفتيش، وكان جناية لا تغتفر إذا ضبط لدى أحد كتب شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب، وخاصة كتابه «معالم فى الطريق»، وكان هذا الكتاب بين يدى يقرأ لى فيه، لكن الله سلم فلم ينتبه أحد لهذا الكتاب.
قبض على كشك وسئل عن بعض الذين تم القبض عليهم فى قضية سيد قطب، لأنهم -كما قال هو- كانوا يصلون فى مسجده، وبعد أسئلة اعتيادية عن نشاطه فى المسجد، وما الذى يقوله، صرفوه، وهو الذى كان يعتقد أنه سيتم احتجازه، لكن بعد ما يقرب من سبعة أشهر وفى أعقاب ما ادعاه من رفضه لحل دم سيد قطب تم القبض عليه، ولم يخرج من السجن إلا فى مارس ١٩٦٨.
يصدق كثيرون أن كشك دخل السجن بسبب رفضه الحديث ضد سيد قطب، ولأنه لم يقل إن دمه حلال، معنى ذلك أن عبدالناصر ورجاله طلبوا من آخرين ذلك، ونفذوا، ومن لم ينفذ مثل كشك حبسوه، أو عذبوه.
هنا لدىّ واقعة تكذب ما قاله كشك، بل تجعل منه خيالًا وكلامًا، لا يمكن الوثوق فيه أبدًا.
تعرفون الكاتب الكبير خالد محمد خالد، واحد من الكتاب الأفذاذ، تخرج فى الأزهر لكنه لم يبق طويلًا عبدًا له ولأفكاره القديمة.
فى كتابه «قصتى مع الحياة» الذى سجل فيه مذكراته ذكر خالد ما ينسف رواية كشك.
يقول خالد فى الصفحة ٥١٦ تحديدًا: جاء الدور على الإخوان المسلمين، فبطشت بهم الثورة بطشتها الكبرى، فى الوجبة الأولى أعدمت مجموعة من زعمائهم على رأسها الأستاذ عبدالقادر عودة والشيخ محمد فرغلى، وفى الوجبة الثانية التهمت رأس الأستاذ سيد قطب ومن معه، وبين الوجبتين أصلت الإخوان سعيرًا.
يصل خالد إلى قلب ما أقصده، يقول: أذكر فى تلك الأيام أن الأستاذ على زين العابدين، رئيس الاستعلامات ترك لى بالمنزل رسالة تليفونية يرغب فى أن أزوره بمكتبه، وحين التقينا بدأ حديثه ناقلًا إلىّ تحية الصاغ صلاح سالم، وزير الإرشاد يومئذ، ثم رجاءه بأن أكتب ضد الإخوان كتابًا سيطبعون منه مئات الألوف ويوزعونه على الشعب، فوجمت وحزنت وسألته: هل هان شأنى عند الثوار إلى الحد الذى يظنون فيه أنى سأقبل هذا الرجاء؟
فرد علىّ زين العابدين: إنهم يعتقدون أنك وحدك القادر على مناقشتهم وإقناع الناس بأخطائهم، فقال له خالد: يا سيادة الأخ، لقد ناقشت الإخوان، ونقدت فكرهم وسلوكهم يوم كان بعض قادة الثورة من مجاذيبهم، ويوم كانوا من القوة بمكان، أما اليوم وهم فى المعتقلات والسجون، فقد أوصانا سيدنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- ألا نجهز على جريح، لذلك أرجو أن تبلغ صلاح سالم شكرى على تحيته، واعتذارى عن عدم تحقيق رجائه.
لم ييأس زين العابدين، قال لخالد: إذن تأذن لنا فى طبع فصل «قومية الحكم» من كتابك «من هنا نبدأ» وتوزيعه على نطاق واسع؟
لكن خالد قطع عليه الطريق بشكل كامل: ولا هذا أيضًا، لأننى فى هذا الفصل كنت أناقش الإخوان، وسميتهم باسمهم، فإذا أذنت بنشر هذا الفصل وحده كنت كأنى ألفت كتابًا ضدهم.
ما الذى حدث لخالد محمد خالد بعدها؟
لا شىء على الإطلاق، لم يتعرض له أحد، ولم يلحق به أى ضرر أو أذى، وهو ما يجعلنى أقول إن مجلس قيادة الثورة فى مواجهته الإخوان، وفى إطار حربه النفسية ضدهم، طلب من كثيرين أن يكتبوا رأيهم فى الجماعة الضالة، ولم يتعرض من رفض هذا الطلب إلى أى سوء.
رواية خالد محمد خالد كشفت الغطاء تمامًا عن كشك.
نحن أمام نمطين من أنماط الكتاب والدعاة، الأول هو خالد الذى يحترم نفسه وقلمه ولا يكتب شيئًا لا يقتنع به، لكنه فى نفس الوقت ليس من هواة البطولات الوهمية، فلا يضيف لنفسه شيئًا لم يحدث، والثانى خطيب مسجد صنع من موقف عابر مجدًا لنفسه، وأعتقد أن هذه الواقعة لم تحدث من الأساس، فكشك دخل السجن ليس لأنه رفض ما طلب منه، ولكن لأنه كان نصيرًا للإرهابيين، بل كان واحدًا منهم.
لسنوات بعد خروجه من السجن ظل كشك صامتًا على حكايته مع الإخوان، لكنه عندما أمسك بالضوء الأخضر الذى منحه السادات لأبناء التيارات المتطرفة، أجهز على عبدالناصر وبدأ فى بناء مجد سيد قطب، ولن أكون مغاليًا إذا قلت إن جزءًا كبيرًا من أسطورة الأب الروحى للتكفيريين فى العالم صنعها كشك بطريقته الدرامية التى كانت فيها الأكاذيب أكثر من الحقائق.
تعامل كشك مع سيد قطب وكأنه أحد المرسلين المكلفين بالدعوة، نسج حوله حكايات تهز قلب البسطاء وتنزع منهم آهات الإعجاب، وتقود الشباب إلى التهلكة، حيث يأخذ بأيديهم إلى نفس الطريق الذى سار فيه قطب.
أسمعه وهو يقول مثلًا فى خطبته رقم ٣٦٤ التى ألقاها فى ٢٥ أبريل ١٩٨٠: إن هذا الشهيد ما جزع من لقاء الله، إنه ليلة أن نام ليصبح مساقًا إلى حبل المشنقة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام، قبل أن يطلع فجر هذا اليوم، رآه وقد دخل عليه زنزانته فى السجن الحربى والرسول راكب فرسًا أبيض، ونزل الرسول عن فرسه وصافح الشهيد وشد على يده، وقال له: هنيئًا لك الشهادة يا سيد، وانقضت الرؤيا وإذا بباب الزنزانة يدق دقًا شديدًا، ويفتح الباب وإذا برئيس السجانين والجلادين يقول له: قم الآن واخرج من الزنزانة لأن هناك تسكينًا فى زنزانة أخرى، فقال له الشهيد: والله ما هى بزنزانة أخرى إنما أنا متوجه إلى الله، ما هو تسكين وما هى بزنزانة، وما هو بسجن، إنما سأخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، سأخرج من جوار الخلق إلى رحاب الحق، سأخرج من جوار الظلم إلى جوار العدل، وذهب إلى حبل المشنقة وجاءه الجلاد ليربط بيديه خلف ظهره كما يفعلون بمن حكم عليهم بالإعدام، فقال الشهيد للجلاد: لم تربطنى يا هذا؟ أتخاف أن أفر من لقاء الله، إن بينى وبين الجنة خطوات إن خطوتها رأيت رب العالمين.
أردت أن أثبت هذه الرواية كاملة كما قالها كشك، جاعلًا منها دليلًا على حالة العبث التى كان يمارسها فى تسويقه لسيد قطب، إذ إن النبى لا بد أن يزوره فى المنام، ويتحدث معه، يبشره بالشهادة، ولم أر فى حقيقة الأمر متاجرة بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم ولا بزياراته فى المنام، مثلما رأيت لدى جماعة الإخوان، ولدى كشك بالتحديد، فكل من يتحدث عنهم من الإرهابيين الذين هم بالنسبة له دعاة سلام، لا بد أن يزورهم النبى فى منامهم، ولا بد أن يكونوا شهداء.
ثم ما هذه الرواية الرديئة التى يحكيها كشك عن اللحظات الأخيرة فى حياة سيد قطب، جربوا أنتم وابحثوا عند آخرين عن لحظات تنفيذ حكم الإعدام ضد الإرهابى الأكبر، ستجدون روايات كثيرة، وستجدون كلمات مختلفة منسوبة لسيد قطب، وهو ما يعنى أن كل من حكى نسج حكاية من خياله، وكلها كانت تحاول صنع بطولة لقاتل، وتصنيع أسطورة لمن خالف شرع الله، لكن لأنه كان قائدهم ومنظرهم الذى حاول تنفيذ أهدافهم، فلا بد أن يكون إمامًا وشهيدًا، ولا بد أن يتم تسويقه للناس بهذه الطريقة.
يمكن أن أعدد هنا نماذج كثيرة لما قاله كشك عن سيد قطب، لكنى لست فى حاجة إلى التأكيد على كذب الواعظ بأمثلة جديدة، لكنى أثبت فقط آية دجله الكبرى، التى يتحدث بها عن سبب اغتيال سيد قطب، فهو يرى أنه وصل إلى حبل المشنقة؛ لأنه كان يدعو إلى رفعة الإسلام ونصره، وأن الأمريكان والسوفيت اجتمعوا على أن يعدم، وأن الشيوعية العالمية باركت دمه، والصهيونية العالمية أصدرت كلمتها ضده، والناس تصدق وتبكى وتلعن من قتل سيد قطب، وكله ببركة الشيخ المضلل.
أعترف لكم أننى كلما دخلت عالم كشك وعدوية أرى الواعظ عاريًا جدًا، ومزيفًا جدًا، بينما أرى المغنى متسقًا مع نفسه جدًا، وحقيقيًا جدًا، لم يدع علينا بشىء، ولم يكذب فى شىء، ولم يدلس على البسطاء الذين كانوا يذهبون إليه فى مسجده معتقدين أن لديه الحق، فيذيقهم الباطل كله، بعد أن يخدعهم ببكائه مرة وسخرياته مرة.
جوبلز الإخوان.. افتراءات كشك على عبدالناصر
من الظلم البيّن أن نحمّل الرئيس السادات وحده مسئولية صعود نجم كشك وعدوية، صحيح أنهما تألقا فى عهده وكانا انعكاسًا واضحًا له، إلا أن البذرة التى نمت لتخرج لنا منهما ثمرًا، شهيًا أو مرًا، وُضعت أيام جمال عبدالناصر، فلا أقل من أن يتحمل جزءًا من المسئولية، لأن سياساته وبعضًا من إخفاقاته كانا سببًا فى أن يحتل الواعظ والمغنى كل هذه المساحة من تاريخنا.
فى كتابها «الغناء والسياسة فى تاريخ مصر» تذهب ياسمين فراج إلى أن هناك تجربة أفرزتها هزيمة ٦٧، وكانت سببًا فى نجاحها، هى تجربة المغنى الشعبى أحمد عدوية، الذى بدأ مشواره الفنى بكلمات وألحان الريس بيرة، أحد رواد شارع محمد على، وهذه التجربة كانت تعبّر عن الجانب العبثى خلال تلك الفترة.
تدخل ياسمين إلى قلب تجربة عدوية، تقول عنها: اعتمدت تجربة عدوية على كلمات كان وقعها السمعى جديدًا وغريبًا وخفيفًا، يدعو للمرح، وإن كانت كلماتها غامضة المعانى على شريحة من الشعب مثل «السح الدح إمبو» و«كرشنجى دبح كبشه»، ولكن التوافق بين شكل وهيئة أحمد عدوية ومضمون ما يغنيه والفرقة الموسيقية التى تصاحب غناءه، أكسب تجربته الغنائية المصداقية.
الربط بين أحمد عدوية ونكسة ٦٧ قدر يطارد المغنى، تقول ياسمين عنه: لو لم يكن ظهور أحمد عدوية فى فترة الهزيمة النفسية للشعب المصرى لما نجحت تجربته الغنائية على الإطلاق، وذلك لأن الشعب بجميع طبقاته كان يبحث عن الخروج من الهزيمة النفسية التى نالت منه، وتحقق ذلك من خلال البحث عن كل ما هو جديد دون اعتبار لمعايير جودته الفنية أو ماهيته.
كانت الهزيمة التى لا يمكن أن نعفى عبدالناصر من المسئولية الكاملة عنها هى التى مهدت الأرض أمام عدوية وكشك إذن.
الزلزال الذى تعرض له المصريون فى يونيو كان مدمرًا بشكل كامل، خرج الشعب من الهزيمة مدفوعًا إلى حالة اغتراب كاملة، وهى الحالة التى حدثت فى اتجاهات ثلاثة.
الاتجاه الأول اغتراب ناحية المستقبل.
فقد قررت فئات عديدة أن تتجه إلى الغرب وتلقى بنفسها فى أحضانه، لم تترك هذه الفئة شيئًا فى الغرب إلا جلبته، أفكار وموسيقى وأزياء وخلافه، فقد أدركت أن ما جرى فى مصر كان بسبب تخلفنا الشديد وعدم مواكبة العالم فيما يفعله أو ينجزه.
الاتجاه الثانى اغتراب ناحية الماضى.
فقد رأت فئات كثيرة أن الهزيمة التى كسرت عظامنا لم تقع إلا بسبب بعدنا عن الله، وحتى نتخلص مما يحيط بنا فليس أمامنا إلا العودة إليه مرة أخرى، ولم يكن لهذه العودة معنى إلا الغرق التام فى كتب التراث وما فيها من أفكار تخاصم الواقع، وحكايات تضع الدين كله فى دائرة أسطورية تؤثر فى مصداقيته.
هذا الاتجاه وجد الشيخ كشك نفسه فيه تمامًا، ولذلك كثيرًا ما كنت تسمعه وهو يأخذ مستمعيه بما يشبه آلة الزمن، ويعود بهم إلى عهد النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، ليؤكد للناس أنه لا خلاص إلا بالعودة إلى الحياة كما كان يحياها النبى وأصحابه.
الاتجاه الثالث لم يكن ناحية المستقبل ولا الماضى، وربما لم يكن ناحية الحاضر أيضًا، ولكنه كان اتجاهًا عبثيًا بحتًا، أو هكذا بدا أمام الناس، وهنا يظهر أحمد عدوية فى الذهنية العامة، فلأن البلد ضاع تقريبًا بعد حرب ٦٧، فكان طبيعيًا أن يظهر فن يعكس هذا الضياع، أو بالأدق يصبح جزءًا منه.
الذين حملوا أحمد عدوية على أكتاف الرئيس السادات فعلوا ذلك لأسباب سياسية بحتة، أو لنكن أكثر صراحة، أقدموا على ذلك لأسباب تتعلق بكراهيتهم لكل ما يتعلق بالرئيس الذى راهنوا على فشله فى كل شىء، فنجح وخذلهم فى كل شىء.
الكاتب الكبير صلاح عيسى فى ملحمته «مثقفون وعسكر» طرح سؤالًا خبيثًا، وقدم بين يديه إجابة أكثر خبثًا.
قال: ما الذى جعل الرئيس جمال عبدالناصر يختار السادات نائبًا له؟، وما الذى جعل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ يغنى لعدوية ويتحدث عنه وكأنه يقدمه إلى جمهوره عن قناعة بموهبته؟
ويجيب صلاح، بخفة ظله ولماحيته وإحساسه الشعبى، بأن عبدالناصر كان يعرف ما الذى سيفعله السادات فى السياسة، ولذلك جعله خليفة له، ليترحم الناس عليه وعلى أيامه وعلى ما أنجزه، وهو نفس ما فعله حليم، فقد كان يعرف حقيقة ما يقدمه عدوية، فتركه يغنى، وبعد أن يسمعه الناس سيترحمون على عبدالحليم وعلى أيامه.
لا أخفى عليكم أننى انبهرت بهذا التحليل الألمعى الذى أثبته صلاح عيسى وقت أن قرأته لأول مرة منذ سنوات بعيدة، لكننى عندما تأملته بعد ذلك اكتشفت أن كاتبنا الكبير كان سطحيًا جدًا فى نظرته، وربما أعماه انحيازه السياسى واختلافه الجذرى مع تجربة الرئيس السادات، وحجبه عن الحق وقوله.
الهزيمة أحبطت عدوية ما فى ذلك شك، فهو مواطن مصرى كان ينتظر النصر الذى تحدثوا عنه، ولما لم يحدث انكمش على نفسه تمامًا، لكنه فى لحظة ألقى عن كتفيه حمولة الأيام، وقرر أن يكون صوت الناس الذين تاهوا، ولم يكن ذلك إلا لأن عدوية نفسه كان قد تاه تمامًا.
كشك لم يُحبط، ولكن جاءته الفرصة كى ينتقم، فى اليوم الذى وقعت فيه النكسة كان الواعظ فى السجن لا يزال.
ما كتبه كشك فى مذكراته عن أيام الهزيمة يدلنا على شيئين.
الأول أنه كان مبتهجًا بهزيمة الجيش، مثله مثل كل من لا يحملون ودًا ولا حبًا لهذا الوطن، وهم كثيرون ممن يعملون من أجل مصلحتهم الضيقة فقط.
والثانى أنه وجد ضالته وأدرك أن الزمن منحه فرصة الانتقام من عبدالناصر، ولم يكن فى حاجة إلا إلى لمن يمكّنه من هذا الانتقام، وهو ما جرى بعد ذلك عندما أصبح خطيب المساجد الأول فى عهد السادات.
بدأ كشك نسج أكاذيبه عما جرى وهو لا يزال سجينًا، ومن بين ما رواه ونرى فيه عجبًا قوله: لما أوشكت الحرب أن تقع بيننا وبين إسرائيل فى يونيو ٦٧، أذاعت القيادة علينا فى المعتقل، وأعنى بها الإذاعة المحلية، أنه من أراد أن يتطوع بالمال للقوات المسلحة فباب التطوع مفتوح، وظن الذين يقبعون وراء القضبان أنه بقدر ما يكون التطوع بقدر ما يقترب يوم الإفراج، فتقدم الأغنياء بمبالغ هائلة، والذى أحزننى أنه كان بجوارى أخ كريم كان يعمل بالبناء وكان يعول أسرة تتكون من زوجة وسبعة أبناء اضطروا أن يبيعوا أدوات العمل ليحصلوا على لقمة العيش بعد اعتقال عائلهم، فلما طُلب منا أن نتبرع لما سموه بالمجهود الحربى، سألنى ذلك الأخ عن رأيى، هل يتبرع وهو لا يملك فى الأمانات سوى خمسة وعشرين قرشًا أبقى عليها ليشرب منها قدحًا من الشاى بعد تناول طعام السجن الذى يغلى فى البطون كغلى الحميم؟ فقلت له يا عم حسن رأيى أن تكتب اسمك فى سجل المتبرعين ولو بخمسة قروش حتى لا يوضع اسمك فى القائمة السوداء.
القصة قد تكون مؤثرة جدًا، لكنها ليست منطقية على الإطلاق، فحتى لو تم التفكير فى الحصول على تبرعات من المساجين، فلن يصل الأمر إلى المتهمين فى قضية قلب نظام الحكم، لكن يحلو لكشك أن يلفق الأكاذيب ويرددها حتى تصبح واقعًا، فلا يجد الناس بعدها بدًا من تصديقها والتعامل معها على أنها حدثت بالفعل.
هل تعرفون الوجه الذى يحتله عندى الشيخ كشك؟
إنه تمامًا كما وصل لكم، إنه وجه جوبلز، وزير دعاية هتلر، الذى وضع قواعد شيطانية فى الدعاية لما يعتقد أنه صحيح، قال: اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، وقال: كلما كانت الكذبة كبيرة، كان سهلًا على الناس تصديقها.
قبل أن يخرج من السجن، كان كشك قد استقر بشكل نهائى على الطريقة التى سيتبعها لتشويه صورة عبدالناصر، وكل ما يمت له بصلة، قرر أن يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدقه الناس، وحتى يكون سهلًا عليه تمرير ما يقوله، ويكون سهلًا على الناس تصديقه، فقد قرر أن تكون الكذبة هى أكبر كذبة فى تاريخ مصر.
كشف كشك عن فلسفته التى نسج حولها أكاذيبه.
قال فى مذكراته: ما جاء جمال عبدالناصر إلا ليحقق ثلاثة أهداف: أولها القضاء على الإسلام، وثانيها تمزيق الصف العربى، والثالث تثبيت مكانة إسرائيل فى المنطقة.
يمكنك أن تستعيد هذا الهراء الذى تقيأه كشك فى مذكراته، وبعدها يمكن أن تسأل نفسك عن الإمعان فى الإفك الذى كان يمارسه الواعظ لمصلحة الإخوان المسلمين من ناحية ومصلحة الرئيس السادات من ناحية ثانية.
ظل كشك، ومنذ حصل على الضوء الأخضر لتحطيم صورة عبدالناصر، يؤلف الأكاذيب حول العصر الناصرى دون أن يهتز ضميره، والمؤسف أنه كان يمعن فى القسم بالله بأن ما يقوله هو الصدق، رغم أن ما بينه وبين الصدق هوة عميقة.
سأضع أمامكم بعضًا مما قاله الواعظ الكاذب.
فى الخطبة رقم ٢١٤، التى ألقاها فى ١ أبريل ١٩٧٧، يقول كشك: اسمعوا هذا التاريخ المشئوم التعس، صلاح الشاهد يجلس أمام سيادة الزعيم الخالد ويشكو له ما يحدث داخل السجن الحربى، لعل ما كان يحدث لم يكن بعلم الزعيم، ولكن هذا الشاهد كان شاهدًا على الزعيم أمام الله، قال له: إن أحد الجلادين دخل ليهتك عرض إحدى المسلمات التى بلغت من العمر ستين عامًا، ولما صمم على الإيقاع بها، قالت له يا بنى: أنا مثل أمك... أتزنى بى؟ فخشع الوحش، خشع الوحش وبكى، الجلاد بكى، وكفّ عن العمل وخرج من أمامها كأنه ذبابة تريد أن تحجب بجناحيها ضوء أو نور القمر، فماذا قال الزعيم للشاهد؟ سأله سؤالًا- واسمحوا لى أن أترجم الكلام إلى اللغة العامية كما نطق به- قال له: هى قريبتك؟ فرد الشاهد: لا، فقال الزعيم: إنت متضايق ليه... اتفضل اطلع بره.
ويعلّق كشك على هذه الواقعة بقوله: استهتار بالقيم والمسئولية، سيدة مسلمة يُعتدى على عرضها، والحادث مسجل فى الوثائق الرسمية، والذى دخل عليه هو صلاح الشاهد، وأبلغه بما جرى، وبما سيكون، وكانت الإجابة وعيدًا وتهديدًا وتوبيخًا وزجرًا ونهرًا.
لم يقل لنا كشك أين سمع هذا الكلام ولا ممن، لم يرشدنا إلى الكتاب الذى قرأوا له منه هذا الكلام؟ ما أعرفه أن لصلاح الشاهد كتابًا مهمًا هو «شاهد على عصرين»، ولم أجد فيه هذا الكلام الفارغ، لكن متى كان كشك حريصًا على أن يقول لنا المصادر التى يستند إليها؟ كان كغيره من أبواق الإخوان يلقّن ما يقوله، ثم يردده كالببغاء، دون منطق ولا عقل ولا ضمير، فقد استخدمت الجماعة كل الأسلحة القذرة للانتقام من عبدالناصر، وللأسف الشديد كان لهم بعض ما أرادوا.
مرة أخرى، وفى الخطبة رقم ٢٣٤ التى ألقاها كشك فى ٢٣ سبتمبر ١٩٧٧، يقول نصًا: كان الزعيم الخالد إذا أراد أن يلقى خطابًا ونحن فى السجون، فإن الإذاعة تعمل فى السجون بواسطة مكبرات الصوت، ويدخل الجواسيس من المعتقلين لينظروا مَن الذى يسمع خطاب الزعيم وهو نائم على ظهره، فيكتب فيه تقريرًا بأنه لا يحترم كلام الزعيم، ومن الذى إذا سمع كلام الزعيم وكان كلامه كله فارغًا، وكان كلامه كله أجوف، وكان كلامه يشخشخ فيه الهواء، كما يشخشخ فى رءوس التماثيل.
هذا بعض من إفك الشيخ كشك الذى مارسه ضد جمال عبدالناصر، وتخيلوا أن صاحب أكبر خطاب غوغائى شهدته مصر فى تاريخها، يصف خطاب عبدالناصر بهذا الوصف.
اختلف مع عبدالناصر كما شئت، قُل عنه ما تريد، احذف من تاريخه ما ترى، وأضف إليه ما ترغب، لكن فى النهاية يظل هو الزعيم جمال عبدالناصر، يظل خالدًا بأخطائه وإنجازاته، أما الذين عادوه فقد ذهبوا إلى مزبلة التاريخ تطاردهم اللعنات.
لفد افترى كشك على مصر وعلى التاريخ وعلى الله وعلى جمال عبدالناصر، عندما صوّر صراعه مع جماعة الإخوان على أنه حرب على الإسلام، ورغبة فى إزاحته من الساحة تمامًا، اسمعه مثلًا وهو يقول فى الخطبة رقم ٢٢، التى ألقاها فى ٧ يوليو ١٩٧٢: لقد جاء يوم على مصر سنة ١٩٦٥ كان الذى يقول فيه لا إله إلا الله جهرًا يصدر أمر باعتقاله، إذا قالها جهرًا، إذا أراد أن يقولها فليقلها سرًا بحيث لا يسمعه الناس، فإذا قالها جهرًا قامت حوله الشبهات، وتكون النهاية الزنزانة ١٩ فى سجن القلعة.
هل يمكن أن يقول هذا الكلام عاقل؟
لا يمكن أن يقوله عاقل بالطبع، لكن يمكن أن يقوله موتور، قرر أن يشوه كل ما يتصل باسم عبدالناصر، فلم يكن الخلاف بين عبدالناصر وجماعة الإخوان على الإسلام، ولكن لأنهم حاولوا الانقلاب على السلطة، أرادوا أن ينتزعوا الحكم انتزاعًا.
لكن ولأن الجماعة، قديمًا وحديثًا، تجيد فن التضليل، فقد جعلت الصراع بين خصومها وبين الإسلام، حتى تستعطف الناس إلى جانبها، لكن، ولأنه إذا كان يمكنك أن تخدع بعض الناس بعض الوقت فإنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، بارت تجارة الإخوان، وأدرك الشعب أنهم ليسوا إلا تجار دين، يتلاعبون باسم الله ليحققوا مكاسب ويحققوا مصالح.
لم تكن حيلة الحرب على الإسلام وحدها هى التى يستخدمها الشيخ كشك ليهدم صورة عبدالناصر عند البسطاء من المصريين، بل كان يستعدى عليه الناس باتهامه بتعذيب النساء دون وجه حق.
يقول فى الخطبة رقم ٢٣٠، التى ألقاها فى ٢٦ أغسطس ١٩٧٧: حضرت فى سنة ١٩٦٥، رأيت ما رأيت فى السجن الحربى من اعتقال النساء، وكان معهن أطفالهن، وكانت الطفلة الرضيع إذا بكت، تقول لها أمها: لا تبكى، لك الله يا هالة، لك الله يا هالة، ورأينا نساء يُجلدن فى سنة ٦٥، وفى باستيل مصر، يُجلدن ويُعلّقن من أرجلهن، ورءوسهن إلى تحت، إلى أسفل، ويهددن فى الأعراض، وتطفأ أعقاب السجائر فى مواضع العفة منهن.
كان يردد كشك هذا الإفك من على منبره دون أن يحاسبه أحد، وأعتقد أنه ما كان ليقوله بهذه الجرأة وبهذا الإصرار على التكرار، إلا لأنه كان محميًا، أو على الأقل كان يعرف أن هذا الكلام يروق لمن قرروا هدم شرعية عبدالناصر، من أجل بناء شرعية جديدة.
لقد ارتكب كشك جريمة لا تسقط بالتقادم، وهى جريمة اغتيال جمال عبدالناصر معنويًا، وأعتقد أنه من حق الشعب المصرى أن يعرف تاريخ الذين خدعوه ودمروا كل شىء له قيمة فى حياته، ولم تكن لدينا أكبر وأهم من قيمة جمال عبدالناصر.
لم يكن الشيخ كشك أبدًا داعية من أجل الإسلام، ولكنه كان فقط داعية لمصلحة جماعة، وتصادف أن مصلحة الجماعة تتفق مع مصلحة الرئيس، فأخذ كشك مساحته كاملة، وتركنا له أدمغة الناس ليعبث بها كيف يشاء.
ما أحتار فيه حتى الآن أن مفكرينا ومبدعينا وكتّابنا تركوا الساحة لكشك وحده، لم يقم أحد بتفكيك خطابه، ولا إظهار العوار الذى يعتريه، اكتفوا باعتباره خطيبًا غوغائيًا وانصرفوا عنه، حتى الذين كان يهاجمهم ويسىء إليهم لم يهتم أحد بالرد عليه منهم، قد لا يكون أحد منهم التفت إلى خطره، اعتبروه مجرد خطيب فى مسجد، دون أن يلتفتوا إلى أنه عبر ثورة الكاسيت كان أكثر تأثيرًا وخطرًا من أى جماعة منظمة ومسلحة.
لقد تضافرت الجهود كلها لتثبيت أقدام كشك.
خرج من السجن وهو يحمل فى قلبه كراهية الدنيا لجمال عبدالناصر، أعد العدة كى يجهز عليه، وتصادف أن الرئيس السادات كان يريد أن يبنى لنفسه شرعية بعيدة عن شرعية أنه خليفة عبدالناصر، وكل هدم فى صورة الزعيم الراحل مؤكد أنه يصب فى مصلحته، فترك كل الذين نالوا من عبدالناصر دون أن يعترض طريقهم، وحتى لو قلت إنه لم يعقد مع كشك صفقة مباشرة، فمؤكد أن كشك استفاد من رغبة السادات فى تحطيم سلفه، ثم كانت ثورة الكاسيت المهولة التى انفجرت فى السبعينيات، حيث تمكن الشيخ من الوصول إلى ملايين الناس فى بيوتهم دون أن يبذل مجهودًا كبيرًا.
أصدقاء الرئيس.. كشك وعدوية فى صحبة السادات الخاصة
لم أصدق أحمد عدوية عندما قال «إنه كان المطرب المفضل للرئيس السادات».
المغنى كان يدافع عن نفسه، يقول: كيف يقولون إننى صاحب ذوق هابط وأنا الذى غنيت فى عيد ميلاد الرئيس السادات، وكنت مطربه المفضل، فهل كان الرئيس الراحل صاحب ذوق هابط؟ أنا غنيت أكثر من مرة فى بيته بقرية ميت أبوالكوم، وأحييت فرح ابنة شقيقته، فكيف يقولون إن ذوقى هابط؟
الكلام كان انفعاليًا جدًا، وربما لهذا لم أصدقه، أن يغنى عدوية فى عيد ميلاد السادات، فليس معنى هذا أن يكون هو مطربه المفضل، خاصة أنه رغم حكايات السادات الكثيرة مع أهل الفن والغناء، فإننى لم أجد حكاية خاصة تربطه بعدوية.
كان معروفًا عن الرئيس السادات أنه طلب بليغ حمدى أكثر من مرة؛ لأن مزاجه رائق، ويريده أن يدندن له بالعود شوية تقاسيم كما قال هو.
وعندما ذهب إلى «كامب ديفيد» حمل معه أفلام فريد الأطرش، وكان يعجبه غناء فريد وأسمهان جدًا، بل كان فيلمهما «انتصار الشباب» فيلمه المفضل.
صافحته السيدة أم كلثوم فى واحدة من المناسبات العامة، وقالت له عاتبة: «بيقولوا يا ريس إننا زعلانين من بعض؟ فرد عليها بخفة ظله المعهودة: خلى اللى يقول يقول يا ست».
هذه حكايات أثبتها من الذاكرة الآن، وغيرها الكثير الذى يجمع بين السادات ونجوم الفن والطرب، ولا أتذكر أن عدوية كان طرفًا فى حكاية بطلها السادات أبدًا، لا أستبعد أن يكون الرئيس المثقف صاحب المزاج الفنى الرائق دائمًا قد أعجبه عدوية، استمع منه إلى أغنية أو أغنيتين فلفت انتباهه، لكنه أبدًا لم يكن من بين نجومه المفضلين.
لكن هذا لا يمنع أن السادات كان مهتمًا بظاهرة عدوية، كما كان مهتمًا بظاهرة كشك تمامًا.
فكما كان الواعظ خادمًا مطيعًا فى بلاط السادات، ومحققًا له أهدافه الكبرى، فإن عدوية بهذا المنطق أيضًا كان أحد مساعدى السادات فى إخضاع الناس، فقد شغلهم وملأ حياتهم، وكان مثار أحاديثهم، وبمثل هذه الأشياء يستطيع من يحكمون أن يُمسكوا بخيوط الرأى العام، بل ويمكنهم توجيه الناس إلى الوجهة التى يريدونها.
الفارق بين كشك وعدوية، أن الواعظ استفاد من استخدام السادات له وأفاد جماعة الإخوان، حيث أصبح بوقًا للترويج لها، أما عدوية فقد استفاد لنفسه فقط، حيث منحه المناخ الذى حرص السادات على ترسيخه فرصة للصعود، ناسبت ذوقه، وهو ما يجعلنى أقول إن اتهام عدوية بأنه صاحب ذوق هابط ظلم بيّن له، لأن السياق العام كان يسمح بحدوث هذا الهبوط سواء فى الغناء أو الدعوة.
قد يأخذك العجب من هذه المقارنة التى ترى أنها غير مناسبة، لكن لدىّ ما هو أكثر، وأعتقد أنه سيقودنا فى النهاية إلى الفكرة الأساسية التى أتبناها هنا، وهى أن كشك لم يكن واعظًا مستقلًا أبدًا، ولم يكن صاحب موقف خاص أبدًا، ولم يكن كل ما يقوله لوجه الله فقط، ولكنه كان أداة من أدوات السياسة، التى استخدمها السادات مرة واستخدمتها جماعة الإخوان المسلمين مرات.
كان كشك وحتى عام ١٩٨١ وهو العام الأخير فى حياة الرئيس السادات ضيفًا مرحبًا به فى المناسبات الرسمية، بل وكان يدعى إلى لقاءات الرئيس ولقاءات شيخ الأزهر، فلم يكن مبعدًا ولا مستبعدًا ولا مغضوبًا عليه، وحتى عندما غضب السادات منه، لم يكن الأمر بسبب ما قاله، ولكن بسبب أنه تخلف عن لقاء دعاه السادات إليه.
كان الرئيس السادات قد قرر حضور ندوة الفكر الإسلامى التى ستعقد بالإسماعيلية فى رمضان عام ١٩٧٩، وتم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من علماء الدين ورجال الدعوة وكان كشك من بينهم.
يقول هو فى مذكراته عن ذلك: فى يوم من أيام شهر رمضان حمل البريد إلىّ خطابًا كُتب عليه «عاجل ومهم» فوضعته فى مكتبى بالمسجد، وذلك لانشغالى بشئون المسلمين الذين جاءوا يستفتون فى مسائل تتعلق بالأحكام الشرعية، وأنسانى الله أن أفتح هذا الخطاب لأعرف ما فيه، وبعد أيام من تسلم الخطاب تذكرته، ولما قرئ علىّ عرفت أن فيه دعوة موجهة من وزير الإعلام إلى الدعاة الإسلاميين لحضور اجتماع مع رئيس الجمهورية فى استراحته بمدينة الإسماعيلية، وأراد الله أن أفتح الخطاب بعد فوات الموعد، وكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يكفينى مئونة التفكير فى قبول الذهاب أوالرفض.
لم تكن الندوة التى حضرها السادات ندوة عابرة، ولكن جرت فيها مواجهة حادة يمكن اعتبارها من المواجهات المهمة والدالة فى تاريخ مصر الحديث، كان عمر التلمسانى مرشد الإخوان حاضرًا، استمع بنفسه إلى انتقادات السادات العنيفة لجماعة الإخوان المسلمين، فهى تقف- كما قال- وراء كل عمليات التخريب والعمالة وإشعال الفتنة الطائفية والطلبة.
كان السادات يتحدث بمرارة، فهو الذى أخرج الإخوان من السجون، وأعادهم مرة أخرى إلى وظائفهم، بل وقام بتعويضهم عن سنوات سجنهم، وأصبحوا جلساءه بعد أن كانوا مبعدين، وبدلًا من أن يردوا له الجميل، وقفوا ضده بعد اتفاقية «كامب ديفيد»، ولم يكن موقفهم حقيقيًا، أخذوا من اعتراض فئات عديدة من الشعب على الاتفاقية والصلح مع إسرائيل حجة للانقلاب على السادات، وهو الانقلاب الذى كان سيحدث حتمًا.
على استحياء وقف عمر التلمسانى وقال للرئيس السادات: «لو أن أحدًا غيرك وجه إلىّ هذه الانتقادات لشكوته إليك، أما وأنت صاحبها فإننى ليس أمامى إلا أن أشكوك لله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لقد آذيتنى يا رجل».
كانت العلاقة بين السادات والإخوان معقدة ومتشابكة، ولا يمكن حسمها بكلمة، لذلك تعالوا مرة أخرى نقابل كشك الذى لم يذهب إلى لقاء السادات لا لشىء إلا لأنه لم يفتح الرسالة التى جاءته، فقد حاول بعد ذلك أن يصنع لنفسه أهمية لم تكن موجودة أيضًا.
ولأننا نتحدث عن صناعة البطولة والأهمية، فلا بد أن نفتح مذكراته مرة أخرى، يقول كشك: بعد أيام من هذا اللقاء وجه شيخ الأزهر- كان وقتها محمد عبدالرحمن بيصار- إلى رجال الدعوة الإسلامية للبحث فى طريق الدعوة ووضع منهج للدعاة، وكنت واحدًا من الذين وجهت إليهم الدعوة، وكان مكان اللقاء فى إدارة الأزهر، وبعد أن انتهى الاجتماع وهممت بالانصراف أخذ شيخ الأزهر بيدى إلى مكتبه، ليدور بينهما الحوار التالى:
بيصار: لماذا أغضبت الرئيس منك؟
كشك: لا أدرى وأريد أن توضح لى الأمر.
بيصار: لماذا لم تذهب إلى الاجتماع الذى دعاك إليه فى الإسماعيلية فى رمضان؟
كشك: لأن الله أراد ألا أحضر، فأنسانى أن أفتح الخطاب حتى فاتنى الموعد المضروب، لكن ما الذى أعلم فضيلتكم أنه غاضب منى؟
بيصار: لقد كنت أجلس عن يمينه، وقد سأل وزير الإعلام وقال له: ألم يحضر؟ فقال له الوزير: نعم لم يحضر فهز الرئيس رأسه غضبًا.
كشك: يا فضيلة الشيخ ولماذا لم تحاول أن تقول كلمة تطفئ بها غضب القلوب؟
بيصار: تستطيع أن تقدم الآن اعتذارًا عما حدث.
كشك: وهل أخطأت حتى أعتذر؟
بيصار: ألا تعلم أننا نعيش فى ظل الرئيس ورعايته؟
كشك: لا... إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
الكلام هنا على لسان الشيخ كشك فى مذكراته، والرواية على مسئوليته وحده، ولأننى أتشكك فى كل ما قاله، فإننى أضع هذه الرواية على محمل الشك الكامل، فحتى لو سأل الرئيس وزير الإعلام عن أحدهم، واستفسر منه هل حضر أم لم يحضر؟، فليس ضروريًا أن يكون هو الشيخ كشك نفسه.
سأضع شكى جانبًا، وسأتعامل مع الواقعة على أنها صحيحة، وهو ما لن يكون فى صالح الشيخ أيضًا، فمعنى أن الرئيس السادات يغضب منه لأنه لم يأت إلى اللقاء ولم يحضره، فمعنى ذلك أن هناك مساحة من الود، على قدرها كان الغضب والعتاب.
قلت لكم إن كشك ظل خادمًا فى بلاط الرئيس السادات حتى وقعت واقعة «كامب ديفيد»، فسار فى مسارات جماعة الإخوان فى تقليب الرأى العام على الرئيس، وتغذية نار الفتنة الطائفية، وشحن الشباب ضد النظام.
لن أبتعد كثيرًا عما يقوله الشيخ كشك نفسه.
كانت الدولة ترصد كل ما يقال ويكون من شأنه صب الزيت على نار الفتنة الطائفية، وكانت تغض الطرف عنه أحيانًا، لكن ليس معنى ذلك أنها لم تكن تراه.
يحكى الشيخ كشك ما يمكن أن يكون دليلنا على ما نقول.
يقول: «فى عام ١٩٨١ تلبدت السماء بالغيوم وغابت الشمس واكفهر الأفق، وذلك عندما وقع صدام بين المسلمين والنصارى على أرض مسجد النذير فى حى الزاوية الحمراء فى ١٧ يونيو ١٩٨١، وسالت دماء وتحركت عواصف الفتن وأنذر الجو بأوخم العواقب».
كان كشك وقتها فى إجازته السنوية، ولما سمع بما جرى وكما قال هو: قلت إن هذا لشىء يراد، وسألت ربى اللطف فيما جرت به المقادير، فقد كانت كل الأحداث تشير إلى أن هناك أمورًا ستقع، وتحركت الأحداث، وبعد أن انقضى رمضان- كان الشيخ قد صال وجال فيه ضد المسيحيين والبابا شنودة - فوجئت بتحقيقات موجهة إلىّ لم يسبق لها مثيل.
كان التحقيق مع كشك فى الغالب يدور حول خطبة واحدة، لكنه فى عام ١٩٨١ دار حول عشر خطب، كان قد صال وجال فيها فيما جرى فى الزاوية الحمراء، وكان خطابه تحريضيًا بشكل كامل، وبعد أن انتهت التحقيقات تم صرفه دون اتخاذ أى إجراء معه، وكأن التحقيق كان روتينيًا ولا شىء أكثر من ذلك.
بعد هذا التحقيق استدعاه وزير الداخلية النبوى إسماعيل، ودار بينهما هذا الحوار.
النبوى: هل ذهبت منذ أيام إلى أسوان.. وألقيت محاضرة دينية هناك؟
كشك: إن كان ذلك حدث فقد علمته، إننى لم أذهب إلى هناك، وبالتالى لم أحاضر؟
النبوى: ما هو المنهج الذى تسير عليه؟
كشك: أنا أستمد منهجى من كتاب الله وسنة رسوله.
كان حديثًا قصيرًا مقتضبًا، لكنه كان يشير إلى أن كشك لم يعد متعاونًا مع نظام السادات، وأن ولاءه لجماعته هو الذى يحركه، لذلك كان طبيعيًا أن يستدعيه النبوى إسماعيل مرة أخرى، ويسأله فى شكوى تقدم بها أحد الدعاة ضد كشك يتهمه فيها بأنه يحرض على المسيحيين فى خطبه المنبرية، ويسخر من دينهم فى دروسه.
كانت الشكوى تعبيرًا عن رفض لمنهج كشك وطريقته وتحديدًا فيما يتعلق بالمسيحيين، لكنه اعتبرها شكوى كيدية، وأن هناك من يحقد عليه ويريد له أن يصمت، رغم أنه وتطبيقًا لشرع الله كان من المفروض أن يصمت، فالله لا يحب من يشعلون نار الكراهية بين الناس، ولم يكن كشك يفعل أكثر من هذا.
المفارقة أن السادات لم يذكر اسم كشك إلا مرة واحدة، فى خطابه الشهير فى ٥ سبتمبر، قال نصًا: «الأخطر من كده إنهم استدعوا الشيخ كشك ولما لم يحضر قاموا بالمظاهرات، وأنتم عارفين الشيخ كشك بيعمل إيه».
كان الرئيس السادات يقصد ما جرى فى جامعة المنيا، فقد أراد مجموعة من الطلبة أن يقيموا حفلًا ساهرًا يشارك فيه عدد من المطربين، لكن الطلبة الذين ينتمون إلى الجماعات المتشددة ومن بينها الإخوان رفضوا إقامة الحفل، وقاموا بطبع إعلانات قالوا فيها إن الشيخ كشك سيحضر إلى الجامعة لإلقاء محاضرة دينية، توافد على الجامعة عدد كبير من الطلاب فى هذا اليوم، وقبل موعد لقاء الشيخ بالطلاب بقليل، وجدوا طالبًا من بينهم يقول إن رجال الأمن منعوا الشيخ وهو فى الطريق لإلقاء المحاضرة، فانفجرت المظاهرات.
الغريب أن وزير الداخلية عندما واجه الشيخ كشك بهذه الواقعة التى وصلت إلى الرئيس، قال له «إنه لم توجه له دعوة ولم يسافر ولم يمنع»، فكيف تكتب عنه هذه التقارير، فوعده النبوى إسماعيل أن يصحح الصورة بنفسه للرئيس حتى لا يبقى فى نفسه أثر تجاه الشيخ.
ما قاله الشيخ كشك يمثل إدانة وليس صك براءة، فوزير الداخلية شخصيًا يتحدث معه ويحاوره، بل ويعده أنه سيتحدث مع الرئيس مصححًا له موقفًا غضب بسببه من الشيخ، وهو يشير للمرة الثانية إلى أن كشك كان من أهل البيت السياسى فى هذه الفترة ولم يكن غريبًا عنه أبدًا.
الصفقة كانت واضحة، وأعتقد أن كل الأطراف حققت أهدافها كاملة منها.
الرئيس استخدم لسان كشك ليهدم الصورة الكبيرة التى رسمها الناس للرئيس جمال عبدالناصر فى قلوبهم، أطلقه على كل من كانوا يمثلون رموزًا فى فترة عبدالناصر، فشوه صورتهم بشكل كامل حتى لا تقوم لهم قائمة، وأطلقه أكثر على الفنانين والمثقفين والكتاب والمفكرين حتى يؤكد للجميع أنه حامى حمى الدين.
وربح الشيخ فى هذه الصفقة بنى مجده الذى لم يكن يحلم به، ثم إنه وهذا هو الأهم ربح مساحات كبيرة جدًا لجماعته، فلم يكن تشويه عبدالناصر يتم لصالح السادات فقط، ولكنه كان يتم أيضًا لصالح جماعة الإخوان، التى اجتهد الواعظ فى تصوير المظلمة التى تعرضت لها، ولأن الساحة كانت خالية أمام كشك، فقد استخدم خياله بشكل جامح، فألف الحكايات ولفق الأكاذيب، فربحت الجماعة تعاطفًا كبيرًا من جموع الشعب التى نجح كشك فى تصويرها على أنها جماعة الإسلام، وأن عبدالناصر كان يريد أن يقضى عليها، لأنه كان يريد أن يقضى على الإسلام.
بالقرب من هذه الصفقة التى ربح فيها الرئيس والواعظ، كان عدوية موجودًا فى مساحة أخرى، ربح هو أيضًا، لكن دون أن يكون فى حاجة إلى عقد صفقة مع الرئيس، فقد كان وجوده مهمًا فى سياسة الإلهاء الكبيرة التى كان يريدها السادات.
لم يشغل عدوية نفسه بالمهمة التى كانت مطلوبة منه، بل سأكون صادقًا معكم، عندما أقول لكم إنه لم يكن يعرف أن شيئًا مطلوبًا منه أساسًا، لذلك لم نجده يتحدث كثيرًا لا عن دور ولا قيمة خارج فنه وما قدمه.
استطاع كشك أن يفلت من المصيدة، فلم يحمله أحد على رجال السادات، وقد تكون هذه هى المرة الأولى التى يجد رجال كشك شيخهم فى هذه المساحة، لكن عدوية لم يستطع أن يفلت منها أبدًا، فقد دفع ثمن أنه ظهر فى عهد السادات، فلا تُهاجم سياسات الانفتاح إلا ويُذكر عدوية، ولا تأتى سيرة السفه الاستهلاكى إلا وكان عدوية علامة عليه، ولا يتحدث أحد عن الابتذال فى عهد السادات إلا ويكون عدوية هو الدليل الكامل على ذلك.
هل تذكرون فيلم «خرج ولم يعد»؟
الفيلم الذى أخرجه محمد خان ولعب بطولته يحيى الفخرانى عام ١٩٨٤، كانت تيمته الأساسية هى التدليل على الابتذال بعدوية وصوته وأغنياته، بل إن بطل الفيلم كان يعتبر عدوية رمزًا لتوحش المدينة وعشوائيتها، فعندما كان يغادر القرية بهدوئها وسلامها إلى المدينة كان يهتف: «جايلك يا مصر.. جايلك يا أحمد يا عدوية».
لم يلتزم عدوية بالصمت فى مواجهة منتقديه، فالضربة كانت عنيفة هذه المرة، لذلك رد بأغنية لحنها له فاروق سلامة وكتبها بهجت قمر، وغناها عدوية عام ١٩٨٦ بعد عامين تقريبًا من الفيلم.
تقول الأغنية: حبيبى من بعد الوفا/ القلب على سهوة اختفى/ ده تقل ده ولا جفا/ حلوها يا أهل الفلسفة/ يا أهل الهوى يا أهل البلد/ محسوبكم فى الحب اتحسد/ يا منادى نادى فى البلد/ خرج حبيبى ولم يعد/ أسمر وغاوى شكسبير/ وليه فى بيتهوفن كتير/ وعينوه من قسمتى/ فى الفن على درجة مدير/ من يومها على سهوة اختفى/ من بعد ما رسم الجفا/ خرج حبيبى يا خلق هو ولم يعد/ وفيه سؤال لماذا هذا ما الذى/ كنا سوا فى أحلى حال/ هل منه ده قلة وفا/ ولا محبة أو جفا.
لم يكن فى هذه الأغنية أى أثر لروح عدوية، لكنه غناها فيما يبدو حتى يرد حقه، وحتى يتخلص ولو قليلًا من تهمة لا تزال تلاحقه حتى الآن بأنه كان يترجم كل سوءات عصر السادات كلمات وألحان وغناء.. رغم أنه فعليًا لم يكن كذلك.