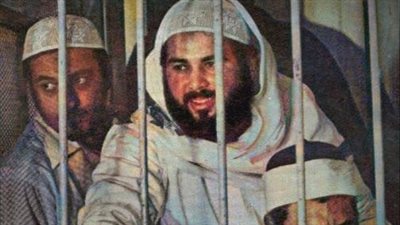لماذا يكتب الأطباء؟

- الأطباء يكتبون تقارير الحالات منذ القدم.. والكتابة الأدبية تطوُّر أكثر حداثةً
- تشيخوف وأوليفر وندل هولمز الأب طبيبان.. والنموذج تبلور أواخر القرن العشرين
- التدريب الطبى يدفع الناس العاديين إلى عالم استثنائى حيث لم تعد مخاطر الحياة أو الموت مجرد استعارات
هل ينبغى للأطباء الكتابة عن المرضى أصلًا؟ هل ينبغى أن تصبح المعلومات المحمية فى سياق المرض مادة للكتابة؟
أول مريض كتبت عنه لم يكن فى الواقع مريضى، فعندما كنت طالبًا فى السنة الأولى فى الطب، لم يكن ذلك المفهوم التملكى- «مريضى»- قد دخل إلى وعيى بعد، ناهيك عن قاموسى اللغوى.
على أى حال، عندما التقيت به، كان قد فارق الحياة. تبعت زملائى الطلاب إلى داخل مكتب الطبيب الشرعى، شمال مستشفى بيلفيو مباشرة، مارًا بأماكن تخزين الجثث الصامتة المجهولة، وإلى صخب غرفة التشريح. ها هو ذا- صبى، ربما فى الثانية عشرة من عمره، لا يشغل أى مساحة تقريبًا على الطاولة المعدنية.
كان قميصه مرفوعًا ليكشف عن صدر ناعم لم يتجاوز سن المراهقة. كان حذاؤه الرياضى ذا الألوان الزاهية غريبًا فى غرفة اندثرت فى ذاكرتى منذ ذلك الحين. بالكاد أدركت ضيق الفجوة بين عمرينا، فقد صدمت بصغر ثقب الرصاصة. لم أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن كيف يمكن لشىء صغير كهذا أن يُحدث كل هذا الدمار.

مر عقد من الزمن قبل أن أتمكن من كتابة تلك اللحظة. حينها، كنت قد أنهيت دراستى فى كلية الطب وفترة إقامتى، وقضيت سنوات متواصلة فى معاناة شديدة لدرجة أننى- على عكس نصيحة أساتذتى الأكاديميين- سافرت لمدة ثمانية عشر شهرًا للعمل مؤقتًا كطبيب متجول، لسد النقص فى الأطباء فى البلدات الصغيرة، ثم سافرت عبر أمريكا الوسطى لأجمع بعض الإسبانية التى كنت فى أمس الحاجة إليها.
فى مراكز التسوق النائية والأسواق المغبرة، بدأت أدون فى دفاتر. كان الصبى على الطاولة المعدنية أول من تقدم. لم أكن أعلم حينها أننى أنزلق إلى دور عريق، دور الطبيب الكاتب. مع ذلك، وبعد كل هذه السنوات، ما زلت أحاول تشخيص حالتى: لماذا يكتب الأطباء؟
نموذج حديث
بمعنى ما، لطالما كان الأطباء كتابًا، يكتبون تقارير الحالات منذ القدم. أما الكتابة الأدبية للأطباء فهى تطور أكثر حداثة. كان أنطون تشيخوف وأوليفر وندل هولمز الأب طبيبين، لكن كتابتهما تبدو مستقلة إلى حد كبير عن وظائفهما السريرية اليومية، فمصطلح «كاتب الطبيب» يخصص عادة للطبيب الممارس النشط الذى تنبع كتابته مباشرة من رعاية المرضى.
تبلور هذا النموذج فى أواخر القرن العشرين، مع طبيب الأعصاب أوليفر ساكس واثنين من جراحى جامعة ييل، شيروين ب. نولاند وريتشارد سيلزر. عندما كنت طالبًا فى كلية الطب، كانت قراءة كتاب ساكس «الرجل الذى ظن زوجته قبعة» كاشفة.
كتب ساكس: «من الناحيتين البيولوجية والفسيولوجية، لسنا مختلفين كثيرًا عن بعضنا بعضًا». «تاريخيًا، كسرود- كل منا فريد». وأوضح أن الطب يمكن أن يكون سبيلًا إلى تلك السرود، وبالتالى إلى هذا التفرد. لم يكن هناك نقص فى القراءة خلال كلية الطب، ولكن كل شىء بدا بحتًا- كنت أحفظ الحقائق من أجل التقدم فى تدريبى. جعلنى ساكس ونولاند وسيلزر أدرك أن هناك مكانًا أذهب إليه بكل هذه الحقائق.
لقد كتبوا مباشرة عن الطب، وشرحوا صدى المرض المتعدد الطبقات وتعقيدات كونك طبيبًا. لا شىء يمكن أن يعدنى بشكل أفضل لدورتى الجراحية من شرح سيلزر لكيفية استخدام المشرط، فى مذكراته، «النزول من طروادة»: كتب «المرء يمسك السكين كما يمسك قوس التشيلو». «السكين ليست للضغط. إنها للرسم عبر مجال الجلد».
فى هذه الكتابات، كان الطبيب شخصية فى القصة. تمكن القراء من الصعود إلى أحذية الطبيب- وهى تجربة يمكن أن تكون غير مريحة، ومثيرة للاشمئزاز فى بعض الأحيان، ولكنها بلا شك تفتح العيون.
لقد أنجب هؤلاء الكتاب جيلًا من الكتاب الأطباء. واليوم، قد يبدو وكأن كل طبيب يغادر فترة تدريبه وفى داخله ما يشبه كتابًا ينبض بالحياة. وهذا ليس مفاجئًا، فالتدريب الطبى يدفع الناس العاديين إلى عالم استثنائى، حيث لم تعد مخاطر الحياة أو الموت مجرد استعارات.
إن كان هناك تشابه ما فى العديد من المذكرات الطبية- أول ولادة، أول وفاة، أول إنعاش، أول إدراك بأن الطب لا يستطيع الشفاء دائمًا- فهذا لا ينتقص بالضرورة من شغف القراء.
تحمل كتب الكتاب الأطباء طابعًا خاصًا نظرًا لطبيعة دراماها الواقعية. لكن الأمر ليس كذلك ببساطة، أو على الأقل لا ينبغى أن يكون كذلك- وإلا فإن مثل هذه الكتابات تكاد تكون استغلالًا.
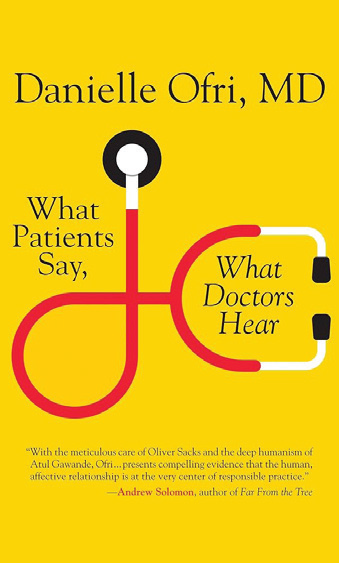
هشاشة الحاجز
أقرب ما يمكننى وصفه هو شعور بالرهبة، يتجدد يوميًا ونحن نعالج مرضانا، أمام الحالة الإنسانية وما يصاحبها من ألم لا ينقطع. أين يمكن للمرء أن يصارع شيئًا مذهلًا ووحشيًا فى آن واحد، إلا على الورق؟
خلال فترة تدريبى، التهمت كل ما استطاعت يدى من كتابات أدبية للأطباء، متلهفة لفهم «تشريح وفسيولوجيا المستشفى»، كما وصفتها طبيبة الأطفال بيرى كلاس فى مذكراتها «إجراء غير حميد تمامًا».
قدم لى الكتاب- وأعمدة مجلتها التى سبقته- دورة مكثفة فى «الدليل المروع على مدى هشاشة الحاجز بين الحياة الطبيعية والكارثة». ظهر أول كتاب لأبراهام فيرجيز، «بلدى»، خلال فترة إقامتى، ما جعلنى أقع فى هاوية ستيجيان التى تمثل نقطة المنتصف.
فيرجيز، وهو طبيب شغوف بالقراءة نشأ فى كنف عائلة هندية فى إثيوبيا قبل أن يتدرب فى الطب الباطنى والأمراض المعدية، وصل إلى بلدة ريفية بيضاء فى جبال الأبلاش بأمريكا الشمالية، فى الوقت الذى كان فيه فيروس نقص المناعة البشرية يمزق المجتمع.
تراكمت الصور النمطية والمخاوف ونقاط الضعف بينما كان المرضى- والأطباء الذين يعتنون بهم- يتعرضون لضربات لا يمكنهم السيطرة عليها أو التنبؤ بها.
عندما وصف فيرجيز الحياة «فى ثقافة المرض، كجزيرة صغيرة فى بحر من الخوف»، فقد عبر عن اضطراب لم أكن حتى أدرك أننى أعانى منه، وهو اضطراب لا يمكن مقارنته بما يعيشه مرضاى.
عندما تركت تدريبى الطبى، كانت لدىّ مجموعة من القصص على وشك الانفجار، مع أننى لا أعتقد أننى أدركت أنها قصص بحد ذاتها. كانت ببساطة معالم الإرهاق. كانت إحدى مهامى المؤقتة الأولى فى منطقة نائية من نيو مكسيكو.
فى مكتبة مجتمعية متواضعة، عثرت بالصدفة على رواية «دماء الغرباء» لطبيب طوارئ يدعى فرانك هويلر. معظم المذكرات الطبية لا تضفى أهمية كبيرة على المكان- فالمستشفى مستشفى- لكن مذكرات هويلر تدور أحداثها فى الجنوب الغربى، بنثر حاد وبسيط كالمنظر الطبيعى خارج نافذتى.
كانت القصص بطول قصيدة نثر، مقتضبة حتى النخاع. كانت الشخصيات مجرد خطوط عريضة. أُرسل هويلر خلال نوبة عمل مزدحمة لإعلان وفاة مريض، فتأمل عشوائية الحياة والموت فى غرفة الطوارئ.
«تهمس لنا الاحتمالات، وتدور العجلات، وتدور الجزيئات كالبكرات. ثم، ربما مرة أو مرتين فى حياتنا، تتآمر الأحداث، وتتوافق الإحصائيات مع قوة الألماس ضدنا، فتفقدنا الأمل، وتهب الرياح علينا، ونموت».
قسوة كتابات هويلر تدخلنا فى وحدة جوهرية فى الممارسة الطبية. فرغم كل الأجنحة والفرق والأقسام والزملاء، غالبًا ما يكون المريض أنت وحدك- والرهانات الخطيرة. لم أفهم هذه الوحدة المرعبة إلا عندما قرأت هويلر.
وأنا أبدأ مسيرتى كطبيب معالج قرأت مجموعة مقالات رافائيل كامبو «الرغبة فى الشفاء»، عندما وجد كامبو- وهو رجل لاتينى يدرس الطب فى جامعة هارفارد- نفسه غارقًا فى التوتر والوجبات السريعة والسجائر والحميات الغذائية المفرطة، انتهى به الأمر فى عيادة، يراقب ويتخيل بينما يفحصه الطبيب: «عندما تحدث، توقف الألم... شعرت به يستمع إلى قلبى ورئتى، ويفهم كل ما كنت أجده مستحيلا لفترة طويلة».
كتب «كامبو»: «مرر الطبيب يديه على جسدى، يستخرج كل سم رقيق كان ظلًا لجسدى، ويذيبه فى بركة من ضوء الشمس». أدركت أنه كان يعبر عما يتوق إليه الكثير من المرضى- شفاء تام لأمراضهم من طبيب يفهم احتياجاتهم الفردية بعمق.
لا يشعر المرء فى كثير من الأحيان بالنبض ينبض خارج الصفحة فى كتابات الأطباء، لكن كتاب كامبو أكد النقطة التى مفادها أن كل شخصية فى المعاملة الطبية- على الرغم من الذكاء الاصطناعى- هى بشرية، تنبض بالنبضات، وغالبًا ما تكون متناقضة.
المشروع الأدبى
لكن ماذا عن المرضى؟ ما حصتهم فى هذا المشروع الطبى- الأدبى، وما الذى يستحقونه؟ قد يُضفى الروائيون على كتبهم طابعًا عابرًا على أفراد عائلاتهم، لكن على الأطباء واجب ائتمانى تجاه مرضاهم، ناهيك عن واجب أخلاقى.
يلتقى المريض الطبيب فى لحظة فارقة، كاشفًا عن جراحه مفترضًا الرعاية والشفاء. ثمة تفاوت متأصل فى الضعف هنا، فالأطباء والمرضى ليسوا متساوين على مائدة عيد الشكر.
فى أوساط الطب، تختلف الآراء حول أخلاقيات الكتابة الطبية. يجادل البعض بضرورة حصول الطبيب على موافقة رسمية من المرضى قبل الكتابة عنهم، كما هو الحال فى أى إجراء طبى، بينما يرى آخرون أن وضع المريض الهش يجعل الحصول على موافقة مستنيرة حقيقية أمرًا مستحيلًا.
عندما سألت المرضى عن إمكانية الكتابة عنهم، كانوا عادة متعاونين، بل متحمسين فى كثير من الأحيان، فقد أمضى الكثير منهم سنوات فى محاولة إيصال قصصهم، ورحبوا بفرصة إثبات صحتها فى المجال العام.
مع ذلك، لا يزال هناك قدر من عدم الارتياح، ويستجيب معظم الكتاب الطبيين بتنازلات متنوعة: طلب موافقة كتابية أو شفهية، تغيير السمات المميزة، خلق شخصيات مركبة، استخدام خطوط عريضة فقط، الانتظار لسنوات، الانتظار حتى وفاة المرضى، الانتقال من الكتابة غير الروائية إلى الكتابة الروائية، أو التخلى عن السرد كليًا واللجوء إلى الشعر.
على الرغم من قلة الإرشادات الرسمية، فقد تشكل إجماع حول الموافقة عند الإمكان، وإخفاء الهوية عند عدم الإمكان، والالتزام بمبدأ أن سلامة المريض تأتى دائمًا فى المقام الأول.
لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل ينبغى للأطباء الكتابة عن المرضى أصلًا؟ هل ينبغى أن تصبح المعلومات المحمية، التى تشارك بسرية تامة، فى سياق المرض، مع وجود تفاوت كبير فى القوة، مادة للكتابة- مهما كانت مقنعة؟
على حد علمى، للأسف، لم يُجر أحد استطلاعًا لآراء المرضى، لذا لا نعرف آراءهم. «ما نعرفه، على قدر الأهمية، هو أن القراء- وجميعهم، فى مرحلة ما، مرضى- يبدو أنهم يستمتعون بالكتب، ويستمرون فى قراءتها».
لعدة سنوات، بما فيها تلك التى التحقت فيها بكلية الطب، كان كل طالب طب فى السنة الأولى يمنح مختارات، بفضل مؤسسة روبرت وود جونسون، بعنوان «عن الطب: قصص، قصائد، مقالات». تنوعت محتوياتها بين الكتاب المقدس وبورخيس ومارجريت آتوود وإيثان كانين.
كان من المفترض أن يلهمنا الكتاب، لكن بالنسبة للكثيرين، تلاشى، وتجاهلته قراءات أكثر إلحاحًا مثل «علم الأمراض الأساسى لروبنز» و«التشريح السريرى لسنيل».
قد يكون من الغطرسة أن يدرج محرر عمله الخاص فى نسخته من الأعمال الأدبية، لكن جون ستون، المحرر المشارك لكتاب «عن الطب»، فعل ذلك بالضبط.
ستون، الشاعر وطبيب القلب من ولاية ميسيسيبى، ألقى خطابًا شعريًا فى حفل تخرج بكلية إيمورى للطب. أدهشتنى القصيدة الناتجة، «Gaudeamus Igitur».
بدا أن طبيبًا جنوبيًا عشوائيًا قد أدرك تمامًا أعمق مخاوفى. كتب: «ستبدو ذكيًا وتشعر بالجهل، ولن يعرف المريض أى يوم هو لك». فى ضربتين شعريتين قصيرتين، لخص ستون فترة التدريب. قبل بضعة أسطر، عبر ببراعة عن رعب إمساك مصير شخص ما بين يديك: «لأن هذا هو اليوم الذى تعرف فيه القليل جدًا/ ضد اليوم الذى ستعرف فيه الكثير جدا».

العوالم الداخلية
لم يمض وقت طويل على عودتى إلى بيلفيو من إقامتى التى استمرت ثمانية عشر شهرًا، حتى التقطت كتيبًا من صندوق أخبار بلاستيكى أصفر فى شارع سكند أفينيو، والتحقت بورشة عمل للكتابة.
كانت تلك أول تجربة لى مع الكتابة كحرفة، ووجدت أن التنظيم الأدبى يثير نفس الشعور بالصواب الذى تثيره المسارات الكيميائية الحيوية. لكننى كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد أدوات، لذا استجمعت شجاعتى لأكتب إلى الدكتور ستون.
رد برسالة تشجيع سخية، ثم وقع نسختى من المختارات لاحقًا خلال حفل شاى بعد الظهر لا ينسى فى مطعم إليفانت آند كاسل فى قرية جرينتش.
عندما توفى ستون عام ٢٠٠٨، تبادرت إلى ذهنى على الفور أبيات قصيدته. «لأن هذه نهاية الامتحانات»، قال لأولئك الأطباء الناشئين. «لأن هذه بداية الاختبار». ثم أضاف المفاجأة: «لأن الموت سيجرى الامتحان النهائى، وسينجح الجميع».
يكتب الأطباء، بالطبع، طوال اليوم، كل يوم- ملاحظات عن التقدم، واستشارات، وتقييمات، وإحالات، ورسائل استئناف. هذا التدفق الهائل من الحبر غالبًا ما يكون هراء، لكن له أسلوبه المميز.
ننزل من بعيد، بعبارات مجهولة المصدر وسلبية مدروسة. «تم تقدير نفخة انبساطية» جملة شائعة بين الأطباء. بالكاد ستلاحظ أن شخصًا حقيقيًا يقف هناك، يضع سماعة طبية على قلب بشرى، يشد أذنيه ليسمع بوضوح أكبر، ويصنف الأصوات، ويقيم جغرافية القص. نكتب من بعيد، ونعزل عالمنا الداخلى خلف عين طبية هادئة ومصطلحات مهنية واقية.
إن التخلص من هذا الإهمال يسمح لتلك العوالم الداخلية بالظهور، مهما كان ذلك مؤلمًا. فى مذكراتها «الجمال فى الكسر»، تنضر ميشيل هاربر، طبيبة قسم الطوارئ، جروحها بنفس دءوبة التى تنضج به جروح مرضاها.
تكتشف، على سبيل المثال، أن إحدى مريضاتها الشابات فى مستشفى شئون المحاربين القدامى تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا أثناء خدمتها فى أفغانستان، لكنها لم تخبر أحدًا قط.
تكتب: «لقد تعلمت الفتاة التى كنتها هذا الدرس جيدًا فى منزلنا الزجاجى الصغير فى واشنطن العاصمة». «فقط عندما غادرت ذلك المنزل أدركت فى أعماقى أن خطر الصمت كان أعظم بكثير من العيش بصوت عال، بما يكفى لتحطيم تلك الجدران وهدم المنزل بأكمله».
تعمل هاربر فى أقسام الطوارئ الحضرية، وليس لديها خيار سوى الانغماس فى المزيج الشرير من الجينات والجغرافيا والظلم والحظ العشوائى- المسودة الأولى غير المحررة للمرض. وهى لا تتمتع برفاهية أن تكون مراقبة من خلف الكواليس. «كامرأة سوداء، أتنقل فى مشهد أمريكى يدعى أنه ما بعد العنصرية، فى حين أن كل لحظة يقظة تكشف العكس»، كما كتبت.
ليس من غير المألوف أن تتداخل المذكرات الطبية مع النشاط والمناصرة. فى كتاب «مواجهة الغيب»، يتساءل الطبيب النفسى دامون تويدى عن سبب إصرارنا على فصل المرض النفسى عن المرض الجسدى.
وفى كتاب «معالجة العنف»، يستعين روب جور بتجاربه كناشط مجتمعى، وطبيب طوارئ، وشاب أسود من بروكلين، ليصف العنف كقضية صحة عامة. يكتب: «عندما كنت طبيبا أصغر سنًا، كنت أنا ومرضاى فى كثير من الأحيان من نفس العمر، ونفس الأسلوب، وربما حتى من نفس المنطقة. الفكرة الرئيسية مشتركة: رجل أسود يفقد حياته، بينما أنا أكافح لإنقاذها».
تنبض هذه الكتب بالإلحاح؛ إنها بحاجة إلى أن تكتب. توفر القصص مساحة واسعة- زمنية، وعاطفية، وسياسية- لا يوفرها العمل السريرى المباشر.
السرد القصصى
قبل بضع سنوات، حضرت محاضرة لأبراهام فيرجيز حول ما يمكن أن يتعلمه الأطباء من الروائيين. وصف كيف أن حس الروائيين فى السرد القصصى يمكنهم من خلق الشخصيات والأصوات والاستعارات؛ وأشار إلى أن خبراء التشخيص يحتاجون إلى درجة مماثلة من الدقة فى ملاحظاتهم.
يهدف الطب السردى، وهو مجال أكاديمى متزايد الشعبية، طورته فى جامعة كولومبيا الطبيبة الباطنية والباحثة الأدبية ريتا شارون، إلى تحسين الرعاية الطبية من خلال مساعدة الأطباء فى فهم قصص مرضاهم ووجهات نظرهم بشكل أعمق.
الكتابة التأملية، وهى اتجاه حديث آخر، شائعة فى كليات الطب وبرامج الإقامة، وهناك بعض الأدلة على أن الكتابة قد تجعل الأطباء أكثر تعاطفًا ودقة ملاحظة.
فى عام ٢٠٠٠، خطرت لى ولبعض زملائى فكرة إطلاق مجلة أدبية فى مستشفانا. فى البداية، تصورنا إصدارًا مصورًا ومدبسًا لعرض كتابات طلاب الطب التأملية. فى النهاية، انطلقت مجلة بيلفيو الأدبية فى العام التالى كمجلة أدبية شاملة.
وبعد خمسة وعشرين عامًا، لا تزال تتلقى آلاف المشاركات من عامة الناس حول مواضيع الصحة والمرض. أقرأ هذه الكتابات كمحرر، لكننى غالبًا ما أعثر على رؤى قيمة تفيدنى كطبيب.
تضمن العدد الأول من مجلة B.L.R. قصة قصيرة بقلم دينيتزا بلاجيف، التى كانت آنذاك طالبة طب، عن طبيب قلب يواجه موته الوشيك بسبب السرطان. «ماذا لو لم تمت؟» يسأل البطل فجأة: «ماذا لو قضيت أسابيع فى المستشفى، وقتًا كنت تعتقد أنه آخر وقت لك بين الناس، وقتًا أخبرك فيه الجميع بأنهم يحبونك وسيفتقدونك؟ ثم اتضح بعد أشهر أنك لا تزال هنا بين الأحياء.. وليس لدى أحد الكثير ليقوله لك، ولا أنت لديك الكثير لتقوله».
لم يكن هذا ظرفًا تعلمنا التفكير فيه فى كلية الطب، ولكن مع علاجات فيروس نقص المناعة البشرية الفعالة بشكل مثير للإعجاب والتى انتشرت على نطاق واسع فى ذلك الوقت، كان موقفًا يوميًا فى العيادة. علمتنى القصة أن أكون منسجمًا مع هذا التوتر.
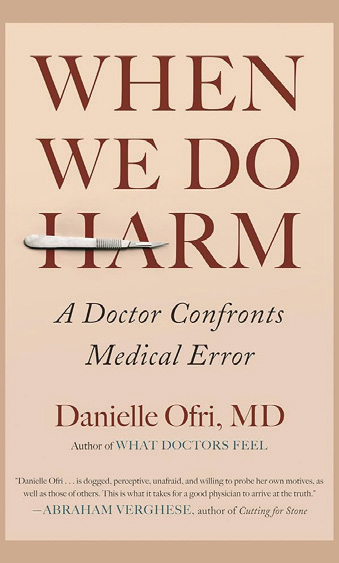
بداية الاختبارات
فى الشهر الأول من فترة تدريبى، وفى ساعات الليل الدامسة، أُرسلت إلى مريض مسن انخفض مستوى الهيماتوكريت «نسبة خلايا الدم الحمراء» لديه بشكل حاد، مع أوامر بتحديد مصدر النزيف.
قد تبدو نوبة العمل الليلية فى مستشفى أكاديمى مزدحم أشبه بحمل ثقيل، وكنت أتنقل بين الأجنحة لجمع المياه؛ كانت هذه المهمة مجرد مهمة أخرى فى قائمة مهامى. بدأت تقييم المريض، وأفكارى تتزاحم فى خوارزمية التشخيص «العثور على النزيف» التى تعلمتها فى كلية الطب.
ثم، بينما كنت أجرى فحصى البدنى- رأسى منخفض، منهمكا فى واجباتى الطبية- توفى المريض. ولأننى كنت مبتدئًا، لم أُدرك ما حدث حتى أشار إلى أحد أفراد عائلة المريض بلطف.
أمام جمهور من الأقارب المفجوعين حديثًا، وذكرياتى التى تتلاشى بسرعة عن كل معلومة تعلمتها فى كلية الطب، كان على إعلان وفاة المريض، وهو أمر اتضح أنه أصعب بكثير مما يبدو فى التليفزيون.
لم يمض على تخرجى فى كلية الطب سوى أسبوعين، وكنت بحاجة إلى حشد ما يكفى من النضج والحكمة لمساعدة عائلة على التأقلم مع فقدان أمهاتهم. لم يكن جون ستون يمزح عندما تحدث عن «بداية الاختبارات».
كما فى لقائى السابق مع الصبى فى غرفة التشريح، استغرق الأمر سنوات لأستوعب هذه التجربة. كان الإيقاع السريع للتدريب الطبى يعنى أننى، بمجرد انتهائى من التعامل مع وفاة هذا المريض، كنت أهرع إلى الأزمة التالية، التى تليها.
فعلت ذلك طوال الساعات المتبقية من نوبتى، والسنوات المتبقية من إقامتى. ومثل أى شخص يشق طريقه بصعوبة عبر القفاز الطبى، حشرت هذه التجربة المكثفة فى مؤخرة ذهنى، ثم حشرت التالية فوقها، وظللت أحشر وأحشر، كجراح يحشو جرحًا مفتوحًا بالشاش، حتى نهضت لأتنفس وأنا فى الثلاثين من عمرى تقريبًا.
كشف الخيوط
عندما بدأت الكتابة، خلال تلك السنة والنصف من السفر بعد فترة الإقامة، كانت تلك أول مرة أحاول فيها كشف خيوط هذه القصص المتشابكة. تبين أن سرد ما حدث مع الصبى فى غرفة التشريح مختلف تمامًا عن معايشته؛ فقد تباطأت صدمة تلك اللحظة العارمة إلى حد كبير من التنقيب المؤلم.
استطعت سبر أغوار حياته القصيرة وما تبقى منها. استطعت نسج الكوابيس التى رافقتنى لشهور، والصور اللاحقة التى لم تتلاش أبدًا. فى كتابة القصة، شعرت برغبة فى التواصل، وشعرت أن الصبى «مريضى».
المراجعات، لعنة حياة العديد من الكتاب، تحولت إلى إشراقة لى. العودة مرارًا وتكرارًا إلى تلك المناوبة الليلية المذعورة حين مات المريض النازف بين يدى كانت بمثابة بلسم غير متوقعٍ لنهاية الأحداث الحقيقية القاسية.
لم يكن هناك إحياء للموتى بالطبع؛ لم أستطع تصحيح أخطائى أو محو معاناة المرضى وعائلاتهم. لكننى استطعت قلب التجارب بواقعية لا يسمح بها الهوس العادى. لاحقًا فقط فهمت هذا على أنه صراع مع مواقف غامضة لا تقدم الحياة المدنية نموذجًا لها.
ومع ذلك، فإن معالجة تجربتنا ليست سوى جزء من سبب كتابتنا. عندما أدرس طلاب الطب الجدد أساسيات تخطيط كهربية القلب، أطلب منهم أن يتخيلوا القلب محاطًا بدائرة من المصورين؛ الأشكال الموجية الاثنتى عشرة التى تتكشف على ورقة الرسم البيانى الوردية هى القلب المصور من اثنتى عشرة زاوية مختلفة.
وبالمثل، يلتقط الأطباء صورًا لمرضانا من وجهات نظر متعددة. نجمع هذه الزوايا من الرؤية- الفحوصات المخبرية، والأشعة السينية، والاستشارات- لرؤية الواقع متعدد الأبعاد المتمثل فى المريض ومرضه.
قد يكون هدف الأطباء الذين يكتبون هو وضع الكاميرات على هذا النحو- معايرة العدسات ضمن إحداثياتنا الشخصية والسريرية حتى نتمكن من إلقاء الضوء على تجارب الطب لعالم القراء الأوسع، الذين لم يسبق لمعظمهم، ولن يعلنوا أبدًا، عن وفاة إنسان آخر.
قد يكون دافع الأطباء للكتابة، إذًا، امتدادًا لسبب دخول الكثير منا إلى مجال الطب- فضول لا يلين لمعرفة كيف يتصرف الناس.
تتيح مهنة الطب أدوات فعالة للتعمق فى أعماق النفس البشرية، لكن الكتابة تتيح أدوات تغوص فى الفراغات التى تتعثر فيها أدواتنا الأكثر نفعا.
وقد يكشف هذا عن جانب أعمق للكتابة- عنصر من عناصر الإنسانية البحتة. لم أعرف قط ما حدث للصبى على طاولة التشريح. لم أعرف قط اسمه، أو لاعب كرة السلة المفضل لديه، أو ما إذا كان لا يزال يستمتع بمعانقة والدته. لم أكن طبيبه، ومع ذلك فهو المريض الذى مكث معى أطول فترة. ربما كانت الكتابة عنه هى الطريقة الوحيدة التى أتيحت لى لرعايته.