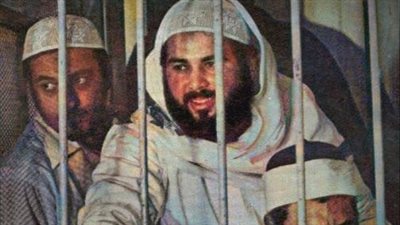أسئلة المستقبل.. النقد
متى تخرج الحركة النقدية من مرحلة الكسل العقلى؟

ليس ثمة دلالة تشير إلى المستقبل أكثر من الاحتفاء بقيمة العقل النقدى، القادر على التأسيس، والتطوير، والمجاوزة، والتخطى، وهو ما يتجاوز النقد بوصفه عملًا تقنيًا إجرائيًا، لأن العقل النقدى يعنى تفعيل إمكانات المساءلة، والمراجعة المستمرة، والنظر الأعمق للعالم، والواقع، والنص، والأشياء.
ولكن هل ينفصل النقد فى صيغته الجديدة عن سؤال المعرفة، وهل ينسلخ عن الواقع الموّار على مسارات مختلفة، هل يتجاوز كونه جملة من الإجراءات التقنية، والتصورات النظرية ذات الطابع النوعى فى سياق الممارسة النقدية المختصة بمعاينة النصوص الأدبية وتجلياتها، أم أنه يتجاوز حد النص إلى حيز الخطاب، والوعى بخصائص النوع إلى استشراف تحولات الكتابة، والتعبيد لمساراتها اللا نهائية.
ربما تقودنا هذه الأسئلة، وغيرها كثير، إلى ضرورة الوعى بأن ثمة مستويات مختلفة يحملها الخطاب النقدى على تنوعه، وتعدده، فالخطاب النقدى ليس كتلة واحدة، وإنما يحمل بداخله تنويعات متعددة، ونحن نسعى هنا إلى رصد مسارات الخطاب النقدى وتمثيلاته النوعية، والوقوف أمام إشكالياته التى تعد جزءًا أصيلًا من إشكاليات الثقافة العربية، بل والذهنية العربية ذاتها، ثم الوصول إلى جملة من الاقتراحات النقدية التى تخص واقعنا الثقافى الراهن، أملًا فى واقع ومستقبل نقدى أكثر وهجًا، وفاعلية.
تتنوع مسارات الخطاب النقدى، وتتعدد مستوياته، بوصفه خطابًا حرًا بالأساس، فمن كونه تمييزا ما بين الجيد والردىء، إلى كونه استجلاءً لجماليات النص وكشفًا عن جوهره الثرى، وصولًا إلى محاولة تلمس العصب العارى داخله، بحيث يصبح الخطاب النقدى ذاته إبداعًا موازيًا من جهة، ورؤية للعالم من جهة ثانية، وربما شهدت النظرية النقدية تحولات كثيرة، ليس عبر المناهج النقدية الراسخة، أو مداخلات النقد الجديدة فحسب، ولكن أيضًا عبر إجراءات التحليل السردى الجديد، وما تحمله من نزوع علمى واضح، فالتحولات التى صاحبت النظرية النقدية فى العالم، والانفتاح الذى شهدته الثقافة العربية على مثيلتها الأوروبية ربما ستدفع بأفق التلقى للنظرية النقدية إلى مناحٍ أخرى أكثر رحابة، كما أن الأنواع الأدبية المختلفة قد شكلت سياقاتها النقدية المستقرة، من اصطلاحاتها إلى مناهجها إلى أدواتها الإجرائية.

ففى نقد الرواية على سبيل المثال كنا أمام سيل من النظريات الحديثة، التى منحت هذا المفهوم المستقر معانى مختلفة، وأشكالًا متعددة، فمن تطوير خطابات الماركسية والاستفادة من الاتجاه الاجتماعى فى نقد الرواية إلى البنيوية بتنويعاتها، والتفكيك بتجلياته، والنقد الثقافى بالتماعاته، وصولًا إلى آليات التحليل السردى الجديد.
ثمة إشكاليات عديدة تواجه النقد العربى، تبدو فى تجلّ منها نابعة من إشكاليات الثقافة العربية ذاتها، فالثقافة العربية ثقافة ماضوية، وسؤال الزمن فيها مشغول بالماضى أكثر من أى شىء آخر، بينما كان رهان النقد فى الغرب متغيرًا باستمرار، حيث ترى الذهنية الغربية العالم فى إطاره النسبى والمتحول، فالزمان والمكان فى جدلهما الخلاق يتغيران باستمرار، ويطرحان قيمًا جديدة وتصورات جمالية ومعرفية جديدة أيضًا، بينما كان سؤال الماضى سؤالًا للثقافة العربية بامتياز، فنحن مشغولون بالماضى، وكل شىء خاضع لما كان.
إن سؤال الماضى، وليس مساءلته، أعاقنا كثيرًا، وكان الانشغال بالزمن الماضى منطويًا على هاجس وجودى فى غياب الوجودية نفسها لأننا لا نحتفى بالفلسفة، وننطلق من تراث راكد مفاده «من تمنطق تزندق»، والماضى دائمًا مقدم على ما عداه، حيث خير القرون هى القرون الغابرة.
أما الثقافة الغربية فكانت تتغير بتغير الزمان والمكان، ومعهما تتغير الأفكار والطروحات ولذلك كل المدارس والمناهج النقدية عاشت جنبًا إلى جنب، وتجاورت فيما بينها ولم تحيا صراعًا يفنى أحدها الآخر، فالوعى النسبى يحمل رهانات متعددة، وبدأت فكرة الفرد تحضر مقرونة بالتفكير، وكان الشك الديكارتى ملهمًا فى هذا السياق، حيث أنا أفكر إذن أنا موجود.
ثمة استنامة ذهنية لدينا، وارتماء فى أحضان الكسل العقلى، واتجاه دائم صوب التكريس للجاهز، وانحياز إلى السائد والمألوف، وهذه الاستنامة الذهنية هى آفة العقل الراكد، فالخروج إلى النور لا يقتضى أن يفكر الإنسان دائمًا فحسب، ولكن أن يطور من نفسه، ومن أفكاره أيضًا. ويتجلى هذا جميعه فى كل شىء، فى الفن والفكر، فى النقد، والمعرفة، فى السرد والشعر، فى الموسيقى والحياة، فى الواقع، والفضاء الافتراضى، حالة تذكرك بنمط الكلمات الجاهزة التى يكتبها الناس فى الأعياد والمناسبات، وإذا كان ذلك يحمل مبررًا إنسانيًا مهمًا، فإن هذا المبرر ينتفى فى حال تلقف فكرة جاهزة، وتداولها دون أى تفكير، أو الحرص الشديد على كتابة أى شىء، وبث أى شىء، لمجرد إثبات الحضور. يمكن لنا أن نتفهم ذلك فى سياق مجتمعى ضاغط، يحتاج فيه البشر إلى مساحة من البوح الشخصى، وهذا عظيم فى جوهره، لكن انسحابه على الكتابة الإبداعية التى تحتاج كعناية حقيقية بالقيم الجمالية فيحول النصوص إلى بوح مجانى ساذج.
إن الجمود حينما يسيطر على المناخ العام لأى جماعة بشرية فإنه لا يجعلها ترتمى فى حضن الماضى فحسب، ولكنه يحول دون امتلاكها وعيًا ممكنًا قادرًا على الاستشراف، فتبدو مفصولة الرأس عن الجسد، واقعها يشير إلى زمن، ووعيها يشير إلى زمن آخر.
الخيال الإبداعى وحده القادر على تحويل الواقع الحى إلى فن، إلى رفد البشر باقتراحات جديدة، إلى تخليصهم من التنميط الجاهز، ويتجلى هذا كله فى المغامرة الجمالية فى الفن، والسلوك اليومى حين يصير جميلًا وإنسانيًا بحق.
على الرغم من أن نظرية المعرفة قد قطعت أشواطًا هائلة فى التفكير والبحث، والتحديث المستمر للأنساق الفكرية الحاكمة، فإن ثمة إصرارًا لدينا فى الثقافة العربية على أبدية كل شىء، وتثبيته، سواء بتقديس التراث، أو تقديس الأطروحات النظرية الأوروبية، وفى الحالين نضع كل شىء موضع الجاهز والمألوف، وبما يعنى أن الرغبة العارمة التى تنشأ فى الذهنية العربية لتنميط الأشياء هى أكثر من حاجة نفسية واجتماعية، وكأنها إشكالية بنيوية فى التفكير، وفى طبيعة النظرة إلى العالم، والواقع، والأشياء.
إن العالم الذى لم يعد يعرف الثبات، والذى ينطلق من تصورات نسبية دائمًا، سيبدو هنا فى الذهنية العربية مستقرًا، مألوفًا ونمطيًا، يعتمد على اليقين بوصفه أصل الأشياء؛ ولذا فالمفاهيم لدينا لا تحتمل سوى وجه واحد، والحياة تدور بين شقى رحى، ورؤية العالم تنحصر فى فسطاطين كبيرين، دون أى تعقيدات يحملها واقع مسكون بالتحول والاختلاف، وينهض على التعقد والتشابك، فهناك تأويلات مختلفة للواقع، وصور متعددة له، والتصورات الرومانتيكية التى ترى العالم إما خيرًا محضًا، وإما شرًا مطلقًا، تعد نتاجًا لنظرة أحادية لم توسع من مداها فترى على نحو أعمق.
وعندما بدأت بعض الأفكار ذات النزعة الحداثية تخترق القشرة الصلدة للثقافة العربية، على غرار المنهج البنيوى على سبيل المثال، كان التلقى البائس لأفق النظرية البنيوية، وحصرها فى الإجراء النقدى المعتمد على فكرة الثنائيات الضدية أو المتعارضة، فى حين أن البنيوية نفسها طورت من أدواتها كثيرًا فيما بعد، وبدت المناهج والنظريات النقدية والفلسفية بعدها حاملة هذا القدر من الوعى بقيم التعدد الخلاق، التى تحكم المفاهيم والتصورات بإزاء العالم، فليس ثمة مركز بعينه، ولكن هناك مراكز معرفية متعددة، وليس ثمة هامش، وإنما قد يوجد الهامش الذى يُشكل المتن، وليست ثمة ثنائيات يقوم عليها العالم، وإنما تجاور بين صيغ ثقافية مختلفة.
لقد ألقى السياسى بظله على المعرفى فى عالمنا المعاصر، ومع سقوط الاتحاد السوفيتى، وبداية عصر الهيمنة للقطب الأمريكى الأوحد، أصبح المركز الأوروأمريكى الفاعل الوحيد فى إنتاج المعرفة، وأداة السيطرة على حركة الأفكار وتشكلها فى العالم، غير أن طبيعة نظرية المعرفة ذاتها وقيامها على آليات التنوع والتعدد والتجاور، جعلنا أمام مراكز ثقافية مختلفة، وإسهامات فكرية متعددة، لا تتوقف عند ثقافة بعينها باعتبارها الرافد والمصدر الرئيسى، ومن ثم كان الوعى بمغالبة احتكار المعرفة وعيًا بالمعرفة ذاتها، وبقدرتها على ترسيخ كل ما هو حر، وعقلانى، ومنهجى.
وفى ظل هذه التحولات المعرفية والجدل الفكرى الصاخب فى العالم، لم تزل الذهنية العربية تحيا فى الماضى، تحاول تثبيت اللحظة دائمًا عند نقطة بعينها، ترى فيها المخرج والملاذ، وهذه النقطة تنتمى إلى قرون غابرة، حيث يعتقد الكثيرون أن العودة بالزمن إلى الوراء ولمئات السنين تحمل المجد والنجاة،
إن الذهنية الجامدة ذهنية ماضوية بالأساس، تحمل تصورات محددة سلفًا، وتنطلق من يقين دامغ، وترى ما كان، خيرًا مما هو آتٍ، وتجعل من القديم معيارًا للجديد، وحكمًا دائمًا عليه.
ثمة حالة من التخندق النظرى- لو جاز التعبير- تمثل مجلى للحال الأكاديمى العربى المنفصل فى متنه المركزى عن واقع النصوص الأدبية وتحولاتها المستمرة. وعلى ضفة أخرى ثمة ارتحال جاهز صوب المركز الأوروأمريكى فى إنتاج الأفكار دونما إعمال للمساءلة المعرفية المتواترة، والمراجعة النقدية المستمرة، بحيث يصبح النقد العربى فى طيف منه مشغولًا بسؤال الماضى، وأحلام/ أوهام نظرية نقدية عربية، وفى جانب منه يحيا حالًا من التبعية الذهنية لكل الأطروحات الغربية، وهذان الملمحان لا يصبان فى خانة التنامى للوعى النظرى، أو التطبيق النقدى على حد سواء.
وللخروج من فخاخ هذه الإشكالية المهيمنة على المشهد النقدى العربى لا بد من الاستفادة من ماهية النقد ذاته عبر تفعيل إمكانات العقل النقدى المنتج، والخيال الإبداعى الحر.
ينسى أنصار الماضى أنه لا يوجد ما يسمى بالنظرية النقية، مثلما لا يوجد الآن فى ظل التراسل بين الفنون الأدبية والجدل الخلاق فيما بينها ما يسمى بنقاء النوع. فالنظرية النقدية ليست كتلة واحدة وإنما توجد بداخلها تنويعات مختلفة، وهى نتاج لإسهامات تتجاوز الأبعاد المحلية وإن انطلقت منها، وهذا يعنى أن الوصول لخصوصية جمالية وفكرية فى النقد العربى لا بد أن ينطلق من واقع النصوص ذاتها وليس من خارجها.
صَاحَبَ النقد الغربى سؤال الفلسفة دائمًا، إلى الحد الذى صارت معه النظرية النقدية جزءًا لا يتجزأ من سؤال المعرفة من جهة، وسؤالًا فلسفيًا بامتياز من جهة ثانية، ويمكن بغير عناء تتبع ذلك فى صنيع جاك دريدا حول المنهج التفكيكى، ومفاهيم مثل الأثر والاختلاف التى تجاوزت مقاربة النوع الأدبى لمعاينة العالم ذاته عبر النظر الحر لعلاقة الدال والمدلول، والتصور المغاير عن تمثلاتهما وعلاقتهما الرحبة أيضًا.

لقد غابت الفلسفة لدينا، ومحصولنا من علم الجمال كان فقيرًا، ما مثل أزمة حقيقية للنقد العربى.
ثمة مشكلات إجرائية تتصل بأدوات تشكل الناقد ذاته، وهى ليست بعيدة عن ماهية النقد، فالناقد يجب أن يضرب بسهم وافر فى حقول معرفية ودلالية متعددة، من التاريخ إلى الفلسفة إلى الوعى بالتحولات الاجتماعية وعلم النفس، ومعاينة كل الفنون، وصولًا إلى المعنى العام لنظرية المعرفة ذاتها، مع تطوير الأداة النقدية والوعى بتحولات النوع الأدبى وتبايناته المختلفة، ومسارات النظرية النقدية وتنويعاتها.
ثمة هاجس سيكولوجى يتصل بفكرة الشغف، حيث معاينة الجديد، والخروج من أفق الممكن إلى براح المستحيل، والولع بالفن الذى يفتح الأبواب المغلقة وليس الذى يدخل الأبواب المفتوحة على حد تعبير فيشر.
وبعد.. تنفتح الكتابة على جملة من الاقتراحات السردية المختلفة، التى لا تبقيها فى خانة واحدة، ولا تطرح صيغة أحادية لها، بل إنها تبرز بوصفها مجلى لعشرات التصورات عن العالم، والصيغ الجمالية، والبنائية المتعددة، فالكتابة ابنة التنوع والاختلاف، وترميز دال على ذلك المنطق الديمقراطى للنص. وربما يشكل انفتاح النص الأدبى على مجمل الخبرات الحياتية، والأحلام، والانكسارات، والهواجس، والإخفاقات هاجسًا للكتابة، وملمحًا من ملامحها الحاضرة.
وعلى الخطاب النقدى الجديد أن يقدم للنص الأدبى إمكانية نظرية لانفتاح مذهل على كل الفنون والعلوم الإنسانية، وهذا الانفتاح بدا جزءًا من الممارسة الإبداعية ذاتها، غير أن التقنين العلمى للظواهر، والرصد الدال لتجلياتها يستلزم وعيًا بالمنهج والنظرية النقدية ذاتها وتحولاتها، فضلًا عن خبرة جمالية تستكشف ما وراء النص، وتعيد الاعتبار للعناصر الأكثر فنية داخله.
إن ثمة دورًا مسئولًا وتاريخيًا يجب على النقد أن يمارسه الآن، بوصفه عطاءً من عطاءات الواقع الرحبة، وخطابًا علميًا، معرفيًا، جماليًا يمثل رؤية للعالم، والنص، والواقع، والأشياء.