الرّوائى التونسى محمد عيسى المؤدب: كل أوراق الإسلام السّياسى احترقت

- لا أعتقدُ الآن، فى تونس، أنّ خطر الإسلام السّياسى ما زال قائمًا، ببساطةٍ لأنّ الشّعب استفاق من غيبوبته حين اعتقد مُتوهّمًا أنّ من يعرف الله سيصلح البلاد ويُسعدُ العباد
- سلوكيات الإسلاميين فى البلدان العربية تشبه سلوكيات الاستعمار
- موجة الوهابيّة حاولت اجتياح تونس فى عشرينيات القرن الماضى
- الدواعش التوانسة الأكثر وحشيّة ودمويّة لأنّ الكثير منهم عاش العنف والقمع قبل 2011
- حركة النّهضة جزءٌ من التّنظيم الدّولى للإخوان، لذلك هى تحمل إرثًا فكريًا لا يقوم على فكرة الدّولة الوطنيّة بقدر ما يقوم على أولويّة الأمة الإسلاميّة.
- «داعش» استغلّ شعور الإحباط والخيبة ليمنح الشّباب المندفعين والعاطفيّين الإحساس بالقوّة
- بعد 2011 انقلب الكثير من خيرة شبابنا إلى متطرّفين
- النّهج السياسى لحركة النّهضة استهدف فرض المشروع الإسلامى عبر سياسة التّمكين
- سياسة «النهضة» قائمة على تعيين أنصارها فى مناصب حكوميّة بعد وصولها إلى السّلطة
فى روايته الأحدث «الجندى المجهول»، يواصل الروائى التونسى الكبير محمد عيسى المؤدب رحلة بحثه المضنية فى سؤال الهوية، ذلك السؤال الذى يشكّل العمود الفقرى لمشروعه السردى منذ بداياته.
«المؤدب»، الذى عرفه القراء بروايته الأولى «فى المعتقل» بعد انقطاع دام أربعة عشر عامًا عن الكتابة، يعود اليوم ليضع القارئ أمام مرآة التاريخ والذاكرة، محاورًا الماضى بقدر ما يواجه الحاضر.
فى حواره مع «حرف»، يكشف المؤدب عن الأسباب التى دفعته إلى الابتعاد عن الكتابة لأكثر من عقد، وعن القصة القاسية لبطلة روايته الأولى التى وقعت ضحية اغتصاب على أيدى متشددين سلفيين، وكيف تحوّلت تلك التجربة إلى مادة روائية تفضح العنف باسم الدين.
كما يتحدث عن رؤيته للرواية التاريخية، وعن الطقوس التى تحيط بعملية الكتابة لديه، وعن ذلك القارئ الذى كفّره دون أن يقرأ له سطرًا واحدًا، فى دلالة على حجم التحديات التى يواجهها الكاتب فى مجتمعات مأزومة بالتصنيفات والأحكام المسبقة.
ولا يتوقف «المؤدب» عند حدود الأدب، بل يفتح النقاش على مشروع حركة النهضة التونسية الذى يراه مناهضًا لفكرة الدولة الوطنية، رابطًا بين أحوال السياسة ودور السرد فى توثيقها، فى محاولة لتفكيك الأسئلة الكبرى التى لا تزال تؤرق الوجدان التونسى والعربى، وإلى نص الحوار..

■ لماذا اعتبرت الإرهاب والتطرّف من الحركات الاستعماريّة رغم أنّ تلك التّنظيمات أفرادها من البلد نفسه؟
- ما حدث بعد الثّورات العربيّة أنّ المجتمعات عاشت أزمات حادّة، فيما يتعلّقُ بالهويّة بشكلٍ خاصٍّ، هذه الظّرفيّة الحرجة استغلّتها الجماعات المتطرّفة لتقديم بدائل عنيفة تدّعى استرجاع الأصالة المفقودة، وهذه البدائل مُختلفة تمامًا عن هُويّة المجتمعيات وقضاياها المصيريّة المُتعلّقة أساسًا بالشّغل والكرامة والحريّة.
فما فعلته هذه الجماعات فعلته الحركات الاستعماريّة فى القرن التّاسع عشر ميلاديًّا بشكل خاصّ فى تونس ومصر الجزائر وغيرها من البلدان العربيّة، فقد فرضت بقوّة السّلاح نماذج ثقافيّة غربيّة على المجتمعات العربيّة، ما خلق صراعًا داخليًّا حول الهويّة، بين الحداثة والتّراث، وبين الأصالة والمعاصرة.
إذن، أليست هذه التّنظيمات شبيهة بالحركات الاستعماريّة التى تسعى إلى طمسِ معالم الهويّة الحقيقيّة لأىّ بلد؟ حدث ذلك فى تونس بعد ثورة ٢٠١١، فقد انقضّ الإسلام السّياسى على تونس كعُقَابٍ جارحٍ، فلم يرأف الإخوان بحال البلد ولا باستحقاقاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة مقابل تعميق الانقسامات داخل المجتمع، بين يمينى مؤمن ويسارى كافر، لكنّ الأخطر من ذلك أنّ عامّة النّاس كانوا على قناعة بعد الثّورة مباشرة أنّ جماعة الإخوان جماعة تقوى وإيمان وإصلاح، لكنّ الواقع طيلة عشريّة كاملة كشف عن حقيقتهم، فلم يتقدّموا بالبلد بقدر ما تدحرجوا به إلى الخلف، وفى جميع المجالات.
أعتقدُ أنّ روايتى «جهاد ناعم» التى صدرت عام ٢٠١٧ عن دار زينب قدّمت سرديّة التطرّف والإرهاب فى تونس بعد الثّورة.
■ مشروعك الرّوائى يطرح قضيّة الهويّة فى المجتمع التّونسى من خلال سؤال: «من نحن؟» وهو نفس تساؤل المئات من المثقّفين فى المنطقة العربيّة. فى رأيك لماذا سؤال الهويّة يمثّل هاجسًا للمثقّف العربى؟
- من نحن؟ هو السّؤال الأهمّ والأخطر، فإذا لم نعثر على إجابة حاسمة فإنّ أزماتنا ستزدادُ حدّةً مع مرور الأيّام، وتلك الفجوات سيعشّشُ فيها الفكر المُتحجّر والمُنغلق.
فى سنوات ٢٠١١ وما بعدها، إلى حدودِ سنة ٢٠١٩ انقلب الكثير من خيرة شبابنا إلى متطرّفين، لم تكن المشكلة اجتماعيّة واقتصاديّة فقط، فالكثير من هؤلاء خرّيجو الجامعة وفى حالة استقرار اجتماعى.
المشكلة الأعمقُ إذن تمسّ الهويّة التى اضطُهدتْ أو هى طُمست من قبل فيروس فتك بالشخصيّة التّونسيّة، فى المستويين الفردى والجماعى، ما جعلها أيضًا عرضةً للتّشويه والمحوِ.
لذلك ظلّ سؤال الهويّة السؤال الأخطر، وهاجسًا مُلحًا لدى المُثقّف العربى، لأنّ الهويّة هى بوّابة كلّ شىء، إمّا التّدهور والاضمحلال، وإمّا الثّبات والمضى نحو التقدّم والرقىّ.
هناك الكثير من الرّوايات العربيّة التى طرحتْ هذا السّؤال، فقد تناولت رواية «ميرامار» لنجيب محفوظ سؤال الهويّة فى سياق التحوّلات الاجتماعية والسياسيّة لمصر ما بعد ثورة ١٩٥٢. وواجهت رواية «موسم الهجرة إلى الشّمال» للطيّب صالح إشكاليّات الهويّة الثقافيّة، خاصة فى ظلّ الصّراع بين الشّرق والغرب، من خلال شخصيّة مصطفى سعيد يُسائل «الطيب» صالح العلاقة بين المستعمَر والمستعمِر. لكنّنا اليوم إزاء مستعمرين أكثر فتكًا بالهويّة، فهم يوظّفون الدّين لغسل الأدمغة وزرع الفتنة فى المجتمعات العربيّة.

■ إلى أى مدى تتحمّل الرّواية مسئوليّة تمثيل الهويّة؟ أم أنّ الهويّة عبءٌ يجب تطهير الرّواية منه؟
- لنتّفق أوّلًا أنّ الهويّة هى كلّ شىء فى حياة الإنسان، هى الماء والهواء، اللّغة والذّاكرة، التّاريخ والرّاهن، الجغرافيا، والدّين، والواقع، والحلم. لا وجود للحظةٍ واحدةٍ بلا هويّة لذلك فإنّ الرّواية من أخطر مسئوليّاتها الرّاهنة تمثيل الهويّة وفق جماليّات سرديّة توثّق صلة المرء بثوابته وعاداته وتقاليده.
نجح نجيب محفوظ مثلًا فى تأصيل الهويّة المصريّة فى أغلبِ أعماله، ففى رواياته نتجوّل فى القاهرة المعتزّة بتراثها والمحتضنة لذاكرتها والمصغية أيضًا لثوابت حاضرها فى مستويات المعمار والدّين واللّغة والمشاغل والحلم، إنّه لممتع أن نرى الشّخصيّة المصريّة بكلّ هذه الثّقة والاعتدادِ بالهويّة.
هل الهويّة عبءٌ؟ لن تكون كذلك بطبيعة الحال، ومن لا يحمل هويّته فوق ظهره، هكذا نقول بشكلٍ رمزى، لا مُستقبل له. وإن حذفنا الهويّة من الرّواية فماذا سيبقى منها؟ لن يبقى غير روبوت يتحرّك فى عالم بارد، ويصنع أحداثًا لا لون ولا طعم لها، هذا كلُّ شىءٍ.
■ ذكرت أنّ هجمة الفكر الإخوانى ظهرت فى تونس منذ عام ١٩٢٠ رغم أنّ جماعة الإخوان أسّسها حسن البنّا سنة ١٩٢٨، فما قصّة الإخوان فى تونس؟
- أبدًا، لا أتحدّث هنا عن «إخوان البنّا»، بل يتعلّق الأمر بمحاولة زرع الفكر الوهّابى ونشره بتونس منذ القرن التّاسع عشر وتواصل إلى حدود سنة ١٩٢٠، ويكفى الاطّلاع على كتاب «المنح الإلهيّة فى طمس الضّلالة الوهابيّة» لمعرفة هذه القصّة بتفاصيلها. فقد ألّف الكتاب القاضى العلّامة إسماعيل التميمى، وهو من كبار علماء الزّيتونة بتونس، بأمر من الباى حمّودة باشا «تولّى الحكم بين سنتْى ١٧٨٢ و١٨١٤» عندما بعث الشّيخ محمد بن عبدالوهاب برسالة إلى الباى المذكور.
هذا الكتاب من ردود علماء الزّيتونة القويّة على رسالة محمد بن عبدالوهاب فى الدّعوة إلى تكفير المسلمين بزيارة مقامات الأنبياء والأولياء الصّالحين والتوسّل بهم، والدّعوة إلى هدم المشاهد والقباب والبنيان على القبور، والنّهى عن زيارتها ومنع النّذور.
عندما وفدت رسالة ابن عبدالوهاب إلى تونس هبّ علماء جامع الزّيتونة للردّ عليها، ونقضِها وبيانِ تهافتها بالحجج والأدلّة الفقهيّة المستمدّة من القرآن والسنّة وخاصّة من المدرسة الفقهيّة المالكيّة التونسيّة.
فى سنة ١٩٢٠ تجدّدت موجة الوهابيّة التى كان يُغذّيها الاستعمار. استخدم بعض الجماعات الأصوليّة كأداة تخريب هوياتى ضدّ الحركات الوطنيّة أو القوميّة، لكنّ شيوخ الزّيتونة وعلماءها تصدّوا مجدّدًا لهذه الموجة الفكريّة المتطرّفة.
■ على ذكر الاعتدال فى المجتمع التونسى.. بمَ تفسّر كثرة عدد أفراد داعش التونسيّين، بل ووصفوا بأنّهم الأكثر وحشيّة؟
- هذا صحيح، كانوا الأكثر وحشيّة ودمويّة، ويمكن تفسير ذلك بأنّ الكثير منهم عاش سنوات من العنف والقمع قبل ثورة ٢٠١١، ما ولّد مشاعر الغضب والرّغبة فى الانتقام. الوضع لم يتغيّر أيضًا بعد الثّورة، فلم تتحقّق تطلّعات الشّباب، وخاصّة الشّغل، مع تواصل التّهميش الاجتماعى والاقتصادى وهو ما دفع بالكثير من الشّباب إلى البحث عن بدائل راديكاليّة. لا يخفى أيضًا أنّ تونس عرفتْ انفلاتًا دينيًّا مُخيفًا سمح لخطاب التّكفير المتطرّف بالانتشار، وهو ما عزّز الفكر الجهادى. نحن نعرف أنّ تنظيم داعش كان يستغلّ شعور الإحباط والخيبة ليمنح الشّباب المندفعين والعاطفيّين الإحساس بالقوّة، وبالفعل استهدف هذا التّنظيم التّونسيّين بشكل مُخطّط له عبر شبكاتِ التّواصل الاجتماعى وتنظيمات التّهريب، مع التّركيز على الشّباب الذين يقطنون أحياء فقيرة ومحرومة فى تونس العاصمة والكثير من المدن الدّاخليّة.
لا يمكن أن يكون الشّباب التّونسى المُعتدل والمتسامح والمُتعلّم والحالم بمثل ذلك التوحّش، كلّ ما فى الأمر أنّ من انضمّوا إلى داعش من التّونسيّين تمرّدوا على واقع سياسى واجتماعى خانق، أكثر من كونهم كانوا ملتزمين دينيًّا.

■ ما المؤشّرات التى استنتجت من خلالها أنّ حركة النّهضة تشكّل خطرًا على الهويّة التونسيّة؟ وهل ما زال هذا الخطر قائمًا؟
- النّهج السياسى لحركة النّهضة كان يهدف إلى فرض المشروع الإسلامى على المجتمع، عبر سياسة التّمكين، وتعنى السياسة تعيين أنصارها فى مناصب حكوميّة بعد وصولها إلى السّلطة.
التّونسيّون لا ينسون أيضًا أنّ الإخوان مُتورّطون فى أحداث عنف فى الماضى بالمنستير وجهة باب سويقة، كذلك هناك شبهات حول علاقاتها بالإرهاب وبشبكات تسفير الشّباب إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى داعش، وهو ما أثار مخاوف حقيقيّة داخل المجتمع بشأن مستقبل الهويّة الوطنيّة التونسيّة.
لم يكن ليخفى أنّ حركة النهضة كانت تسعى لفرض هويّة إسلامويّة على المجتمع التونسى، وهو ما يُمثل تحدّيًا لقيم الدولة الوطنيّة. المسألةُ الأخطرُ أن حركة النّهضة كانت تعمل على تجميد مسار التّحديث والتطوّر فى تونس فى كلّ المجالات وخاصّة فى مجالى التّعليم والثّقافة، وذلك من خلال نهجها السّياسى والأيديولوجى الذى يمثل عائقًا أمام التقدّم، وبالفعل فى فترة حكم الإخوان بتونس تجمّدت مشاريع الدّولة، إنّهم ببساطةٍ لا يُؤمنون بمفهوم الدّولة، وما حدث أنّهم تعاملوا مع البلد كغنيمة بعد غزوة، هذا ما حدث بالفعل.
لا أعتقدُ الآن، فى تونس، أنّ خطر الإسلام السّياسى ما زال قائمًا، ببساطةٍ لأنّ الشّعب استفاق من غيبوبته حين اعتقد مُتوهّمًا أنّ من يعرف الله سيصلح البلاد ويُسعدُ العباد، فإذا بهم يزيدون الوضع تعكّرًا، وإذا بالبلاد تتدهور فى كلّ المجلات تقريبًا وخاصّة اقتصاديّا واجتماعيًّا. الإسلام السّياسى احترقت كلّ أوراقه فى تونس ولن يعود فى المُستقبل إلى الحكم، لا يعود الأمر إلى تنافس على السّلطة وإنّما يعود إلى شعب استفاق واستعاد وعيه وحسم أمرهم. هناك شىء اسمه بيئة تونسيّة وشخصيّة تونسيّة، جعلت تونس، على مدى تاريخها، وسطيّة فى معتقدها، سواء تعلّق الأمر بالإسلام، أو حتّى بالأقليّات الدّينيّة التى عاشت بتونس وتعيش إلى حدّ الآن.
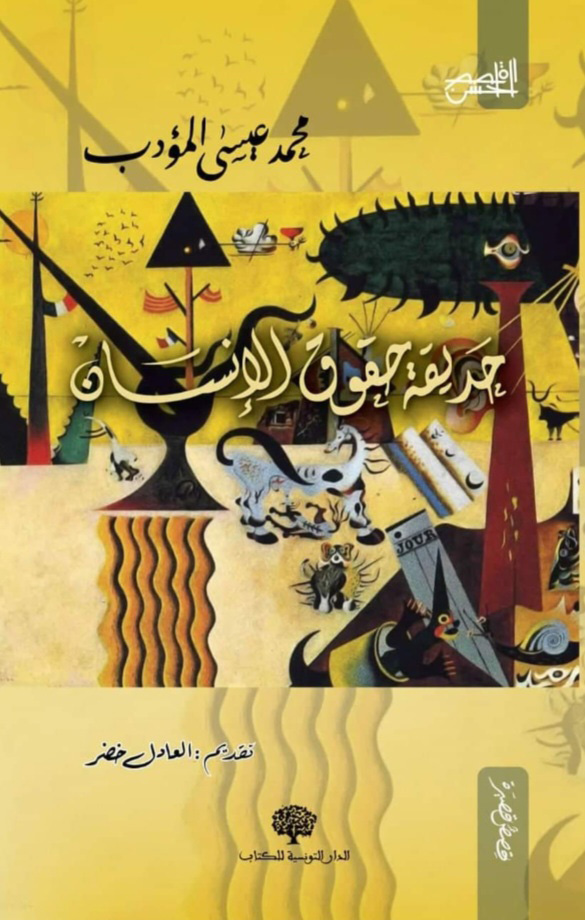
■ لماذا اعتبرت الفكر الإسلامى دخيلًا على الهويّة والثّقافة التونسيّة؟
- لا أبدًا، أعتقدُ أنّ المسألة فيها خلط وسوء فهم. ما أعنيه أنّ الإسلام السّياسى دخيل فعلًا على الهويّة والثّقافة التّونسيّة، وبطبيعة الحال هناك فرق واضح وجلى بين الدّين الإسلامى والإسلام السّياسى.
الفكر الإسلامى والهويّة التونسيّة عنصران مترابطان ومتجذّران فى تاريخ تونس الثقافى والحضارى. فى الحقيقة، دخل الإسلام إلى تونس فى القرن السّابع الميلادى، وصار جزءًا من نسيجها الاجتماعى، فقد اندمج مع الثّقافات الأمازيغيّة والعربيّة والمتوسطيّة التى شكّلت شخصيّة تونس. هذا التّفاعل أنتج إسلامًا تونسيًّا معتدلًا ومنفتحًا، يقوم على الوسطيّة واحترام التنوّع. ولا ننسى أنّ تونس شهدت عبر التّاريخ حركة إصلاحيّة دينيّة مهمّة، تأثّر بها روّاد الفكر مثل خير الدين التونسى، والطاهر الحدّاد، والشيخ محمد الفاضل بن عاشور.
الفكر الإسلامى فى تونس ليس مجرد تطبيق لنصوص دينيّة، بل هو نتاج مخاض اجتماعى طويل، لذلك يتميّز بالوسطيّة والمرونة والتّفاعل مع العصر، ثمّ إنّ الهويّة التونسيّة بدورها هوية مركّبة، فهى عربية، إسلاميّة، أمازيغيّة، ومتوسطيّة، ومتجذّرة فى قيم التّعايش والانفتاح، وهو ما يجعل التّجربة التونسيّة تجربة مخصوصة.
■ ما الظواهر التى رصدتها كأكاديمى ومبدع تونسى وجعلتك تقول باستحالة إيمان الإخوان/ النّهضة بالعقل وتداول السّلطة؟
- خطاب «النّهضة» لمن يُدقّقُ فيه خطابٌ مزدوج، فهو مرنٌ وحداثى فى الظّاهر، لكنّه مُتشدّد وأصولى عند مخاطبة قواعدها، هذا ما تجلّى مثلًا، فى تصريحات بعض قادتها حول تحكيم الشّريعة، ثم تراجعهم عن تلك التّصريحات عند التّفاوض السياسى مع الأحزاب الحداثيّة، وهو ما أثار الشّكوك حول صدق التوجّه السياسى للإخوان فى تونس.
بعد حدوث اغتيالات سياسيّة عام ٢٠١٣ ظهرت ضغوط شعبيّة وأزمات سياسية لتتنحّى النّهضة عن الحكم، لكنّها رفضت التنحّى فى البداية، ثمّ استجابت لضغط الشّارع.
ظاهرة أخرى مارستها النّهضة وهى محاولة أخونة مؤسّسات الدّولة، مثل التّعيينات فى القضاء والإعلام وحتّى التّعليم والثّقافة والإدارة تحت غطاء التّطهير، هذه السّياسة اعتمدت على الولاء الحزبى لا الكفاءة، وهو ما يُعدُّ طرحًا بعيدًا عن قيم الدّولة المدنيّة.
لا ننسى أنّ حركة النّهضة جزءٌ من التّنظيم الدّولى للإخوان، لذلك هى تحمل إرثًا فكريًا لا يقوم على فكرة الدّولة الوطنيّة بقدر ما يقوم على أولويّة الأمة الإسلاميّة. هذا الإرث يجعل التّسليم بالتّداول على السّلطة أمرًا مشكوكًا فيه. مسألة أخرى ظهرتْ فى بدايات مرحلة ما بعد الثّورة، وهى روابط حماية الثّورة من قبل تيّارات متشدّدة، جعل البعض يربط النهضة بعقلية إقصائيّة.
عمومًا، فإنّ تجربة النهضة فى تونس كشفت عن تناقضات عميقة وحادّة بين أيديولوجيا إخوانيّة وتحديّات الحداثة والديمقراطيّة. كما بدا واضحًا انعدام الثّقة الشعبيّة فى الإخوان، وفى نواياهم السياسيّة والفكريّة وحتّى الاجتماعيّة.

■ روايتك «فى المعتقل» رصدت تجربة شخصيّة لك. ما كواليس هذه التّجربة؟ ولماذا اعتبرت أنّ ظهور الفكر السّلفى والإخوانى جاء نتيجة للدّيكتاتورية؟
- شخصيّة أمانى السّحبانى فى رواية «فى المُعتقل» التى صدرت عام ٢٠١٣ ليست محض خيال، بل هى شخصيّة مرجعيّة، تربطنى بها صلة خاصّة بالجامعة، وقد تعرّضت فعلًا إلى الاغتصاب من جماعة دينيّة مُتشدّدة.
ولم تبقَ فى الرّواية مجرّد ضحيّة، بل ارتقتْ إلى ذاتٍ فاعلةٍ تعيش التحوّل من السّذاجة إلى الوعى، ومن القهر إلى المقاومة.
صار حضورها يرمز إلى الأنوثة الثّائرة على جماعة تُكرّسُ القمع الدّينى، وإلى المرأة التّونسيّة فى تصدّيها للفكر السّلفى المتشدّد الذى كان يسعى إلى إحداث انقلاب فى الشّخصيّة التّونسيّة.
فعلًا، ظهور الفكر السّلفى وتغلغله فى عقول الشّباب وعواطفهم الجيّاشة جاء نتيجة الدّيكتاتوريّة وغباء النّظام الذى مارس القمع السّياسى والرّقابة المتشدّدة على المساجد والجوامع، حتّى على شباب عاديّين، فحوّل من يمارسون شعائرهم الدّينيّة إلى ضحايا تعاطف معهم المجتمع، فتكاثروا وكسبوا أنصارًا.
الإسلام السّياسى فى تونس لم يكن له مشروع إصلاح سياسى واجتماعى واقتصادى، مشروعه الوحيد أنّه كان ضحيّة الديكتاتوريّة، لذلك فإنّ أغلب من ذهبوا إلى مكاتب الاقتراع فى أوّل انتخابات تشريعيّة بعد ثورة ٢٠١١ كانوا مُتعاطفين مع الضحيّة، لا أكثر ولا أقل، بل إنّ الكثيرين كانوا يقولون: «سأنتخب من يعرفُ الله».

■ ما وقع حادثة الاغتصاب على المجتمع حينها خاصّة أنّ المرأة فى تونس تتمتّع بحقوق أكثر من قريناتها فى المنطقة؟
- ترتبطُ وقائع رواية «فى المعتقل» بفترة التّسعينيات وما بعدها، أى فترة تغلغل الفكر الإخوانى فى الجامعة التّونسيّة. كان هناك صراع حادّ بين اليمين واليسار، وفى تلك الظّروف تعرّضت إحدى الطّالبات إلى حادثة اغتصاب من جماعة سلفيّة كانت تنشطُ تحت غطاء دينى يدافع عن حقوق الطّلبة فى تلك الفترة، هناك من قال إنّ الحادثة معزولة، ولا تُمثّل الاتّجاه الإسلامى، والإسلام السّياسى كان يُسمّى «الاتّجاه الإسلامى» أيّامها، لكن ما حدث كان خطيرًا من متشدّدين دينيّين يرون فى المرأة عورة وغزوة يجوز انتهاك حرمتها وجسدها.
وطبعًا خلّفت الحادثة صدمة للطّلبة وخاصّة الطّالبات، إضافة إلى تأثيرات نفسيّة واجتماعيّة حادّة. بطبيعة الحال الرّواية لا تكتفى بتلك الحادثة لتحوّل هذه الطالبة، أمانى السّحبانى اسمها فى الرّواية، إلى رمزٍ لشخصيّة المرأة التّونسيّة الحداثيّة، الواعية، والمُتمتّعة بحقوق ناضلت من أجلها المرأة التّونسيّة لعقود.
تحضرُ الطّالبة بذلك رمزًا لتتشابه مع صورة البلد الذى انتهك هو الآخر من الفكر الإخوانى المتشدّد، وتستطيع بعد رحلة مقاومة ومواجهة أن تنتقم من جلّاديها أو مُغتصبيها تمامًا كما استطاعت تونس التّخلّص من الدّيكتاتوريّة فى ثورة ٢٠١١.
الحقيقة أنّ المرأة بوعيها ونضالاتها كانت صمّام الأمان للهويّة التّونسيّة بشكل خاصّ بعد الثّورة التّونسيّة، فقد واجهت هذا الفكر الإخوانى بشجاعة وجرأة برفقةِ المجتمع المدنى، هناك حادثة رمزيّة حدثت فى كليّة الآداب بمنّوبة، وهى محاولة أحد المتشدّدين إنزال العلم التّونسى من أحد مبانى الكليّة، لكنّ إحدى الطّالبات تصدّت له بشجاعة وجرأة، هذه المواجهة وغيرها من الأحداث دفعت المجتمع التّونسى إلى الاستفاقة ومواجهة الأخطار المُحدقة به، وبفضل ذلك الوعى المجتمعى لم ينجح الإخوان فيما كانوا يُخطّطون له فى تونس.
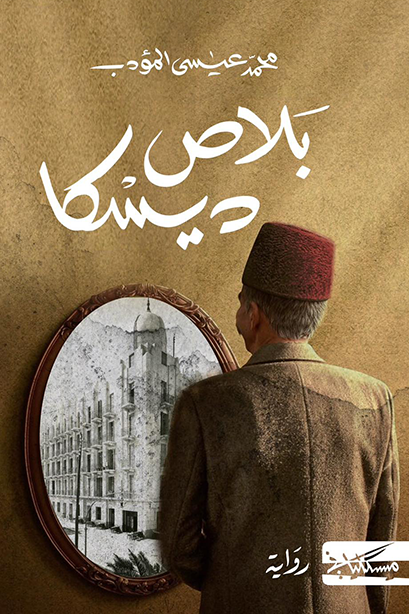
■ كيف ترى الرّواية التاريخيّة؟ وما أسباب اتّجاه العديد من الرّوائيّين لكتابتها خلال العقدين الماضيين؟ وهل للجوائز دور فى هذا الأمر؟
- عرفت الرّواية التّاريخيّة العربيّة تطوّرًا ملحوظًا مع تصاعد الاهتمام بالهويّة والتاريخ فى العالم العربى. والحقيقة أنّ أغلب التّجارب لم تعد للتّاريخ لتسرد التّاريخ فى شكل حكايات ممتعة ومُسلّية فقط، وإنّما كان الهدف إعادة النّظر فى الرّواية الرّسميّة للتّاريخ فيما يتعلّق بالأحداث الكبرى، ومنها الحروب والحركات الاستعماريّة، وكذلك معالجة مواضيع مهمّة مثل الاستبداد والهويّة، والمقاومة.
لكنّ الهدف الأهمّ باعتقادى هو تقديم قراءات نقديّة للماضى بشكل يخدم قضايا الحاضر ويُضىء الكثير من النّقاط الغامضة والسّوداء، أنا أكتبُ الرّواية التّاريخيّة من هذه الزّاوية، لأطرح السّؤال: كيف يمكن للماضى أن يفسّر تحوّلات الحاضر وتقلّباته الحضاريّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
لا أنكر أنّ للجوائز دورًا كبيرًا فى ميل الكثيرين إلى كتابة الرّواية التّاريخيّة بأشكال مختلفة، لكن باعتقادى أنّ هذا النّوع من الرّوايات إن اكتفى بمجرّد الحكى وسرد الأحداث فإنّه سيكون بلا معنى، فلم يعد العصر عصر جرجى زيدان. لا بدّ للرّواية التّاريخيّة اليوم أن تحفر بعمقٍ فى التّاريخ حتّى تنقده، وتُصحّح الرّوايات الرّسميّة المغلوطة، وتنتصر للمهمّشين والمنسيّين وتعيد النّظر فى العديد من الأحداثِ المرويّةِ.
لا أنكر أيضًا أنّ الكاتب العربى كثيرًا ما يهرب إلى ذاكرته، إلى التّاريخ، ويتجنّب الكتابة عن الواقع أو الحاضر، وذلك لأسباب نفسيّة وسياسيّة وحتّى جماليّة. الكاتب العربى مُحاصر بحالات قمعٍ مُتعدّدة، منها السياسيّة والاجتماعيّة، لكنّ أخطرها القمع النّفسى الذى يواجهه بسبب ظروفه الاجتماعيّة والمهنيّة، فهو غير مُتفرّغ للكتابة التى لا يمكن أن توفّر له احتياجاته الحياتيّة. إذن كلّ ذلك يجعل الكتابة عن الحاضر، أو الواقع، محفوفة بالمخاطر، ما يُحمّل الكاتب أعباء ثقيلة، حينئذٍ تكون الذّاكرة مجالًا آمنًا ومرنًا للتعبير والانتقاد غير المباشر.

■ قلت إنّ الرّواية تتطلّب سعة البحث والمعرفة والدّأب على القراءة وتطوير آليات الكتابة. بين أوّل رواية كتبتها وصولًا إلى «الجندى المجهول»، إلى أى مدى طوّرت آلياتك؟ وما التصوّر الذى وصلت إليه عن فنّ الرواية؟
- تجربة الكتابة شاقّة فعلًا، إذا أخذنا العمليّة الإبداعيّة بجديّة وحرفيّة، وقناعتى أّنّى كلّما أشرعُ فى كتابة رواية جديدة أخوضُ المغامرة كأنّى أكتب روايتى الأولى، بشغفٍ، ودقّةٍ، انطلاقًا من الاقتناع بالفكرة الرّوائيّة، والبحث الدّقيق عن مادّة العالم السّردى، ثمّ الحرص على تطوير آليات الكتابة، وبشكلٍ خاصٍّ المعمار الرّوائى واللّغة والأسلوب وإيقاعه.
فنّ الرّواية كما أفهمه فن التعدّد والتّجريب، ولم تعد قيمته تقتصرُ على الحكاية، بل على إنتاج المعرفة. الرّواية الحديثة اليوم بإمكانها أن تهدم التّابو وتتجاوز المكرّس لتُعيد تنظيم العالم.
■ ما المنطقة التى تتجنّبها عمدًا فى الكتابة رغم مغرياتها الفنية؟ ولماذا؟
- هى دون شكٍّ منطقة الجنس الفاضح، أو الإثارة الجنسيّة المجانيّة، أعتقدُ أنّ تلك المنطقة لا تُضيف شيئًا لجماليّات الكتابة الرّوائيّة إلّا إذا كانت وظيفيّة خادمة للشخصيّات وللعمق الفكرى والإنسانى. أحبّ أن تكون الرّواية مثل حياتنا، بكلّ تفاصيلها، والتزامها، بلا ندوب، ولا رقصات بهلوانيّة زائدة عن النّصاب.
■ هل تشعر بأنّ الأدب التّونسى ما زال محاصرًا بين صورتين: التّراث المغاربى والتّجربة الحداثيّة ؟ أين تضع نفسك؟
- أعتقدُ أنّ الأدب التّونسى يتحرّك بين قطبى التّراث والتّجريب، الذّاكرة تمتدّ آلاف السنين، بقضاياها وتجاربها ومحنها، والتّجريب بأسئلته المثيرة والمشاغبة والمغامرة، وهذا القلق فى الواقع هو ما يمنح هذا الأدب نبرته المميّزة. أنا أيضًا أحمل هذا القلق، لا بمعناه السّلبى، ولكن بمعناه الإيجابى الذى يدفعنى إلى مزيد الكتابة والخلق والاختلاف عن المُكرّس.
■ كيف ترى دور الأسطورة فى عالم اليوم؟ هل ما زالت قادرة على تفسير الواقع؟
- باعتقادى أنّ الأسطورة لا تزال قادرة على تفسير الواقع اليوم، ليس بمعناه الحرفى القديم، بل عبر قدرتها على التّعبير الرّمزى، الذى يمكّنها من قراءة العمق النفسى والاجتماعى والسّياسى للمجتمعات المعاصرة. فى عالم يشهد توتّرات هوياتيّة متزايدة، تحافظ الأسطورة على قدرتها فى صياغة سرديّات الجماعة، وهى تُستخدم أحيانًا لإعادة إحياء الشّعور بالانتماء أو لإعادة بناء هويّة ثقافيّة. روايتى الأخيرة «الجندى المجهول» تتحرّك فى هذا المعنى، إذ تروى أسطورة هذا الجندى المجهول سيرة هويّة منسيّة وتعيدُ للواقع هويّته التى حاصرها الظّلاميّون.

■ هل تشعر بأنّ النّقد العربى قادر على قراءة مشروعك كما ينبغى، أم أنّ هناك فجوة بين النّصوص وطرائق قراءتها؟
- يعانى النقد العربى من نقص الاستمرارية، إذ تغيب مشاريع نقديّة شاملة ومتتابعة، مقابل انتشار مقالات متناثرة أو قراءات مناسبتيّة مرتبطة بجوائز أو ندوات. تُنشرُ روايات كثيرة فى مختلف البلدان العربيّة، لكن غياب النّقد الأدبى جعل الكثير من الأعمال تمرّ دون تقييم جدّى، بينما قد تتضخّم أعمال أخرى لمجرّد أنّها حازت جائزة أو لاقت صدى إعلاميًّا.
وفى الواقع حظيت رواياتى بمتابعات نقديّة مهمّة فى العديد من الدّراسات والكتب من نقّاد مهمّين ليس فى تونس فحسب، بل فى مصر، والجزائر بالإضافة إلى كون بعض رواياتى مثل «حمّام الذّهب، وجهاد ناعم، وحذاء إسبانى، وفى المعتقل، وبلاص ديسكا»، تدرّس فى العديد من المؤسّسات الجامعية بتونس والجزائر.
■ مَن هو القارئ الذى تكتب له؟ وهل تغيّر هذا القارئ بعد انتشار القراءة الرقميّة؟
- لا أكتب لقارئ بعينه، وبمواصفات محدّدة، القارئ المُفترض عندى يمكن أن يكون من يقرأ أوّل كتابٍ فى حياته ومن يقرأ آخر كتابٍ فى حياته كذلك. أشتغلُ على خلفيّة فكريّة وعمق إنسانى، وأحرصُ دومًا على عدم الإخلالِ بهما. قارئ اليوم ليس قارئ الستّينيات أو السّبعينيات. صار قارئًا صعبًا، ومزاجيًّا، تحكمه وضعيّة معقّدة نفسيًا واجتماعيّا، وتحاصره الوسائط الحديثة السّهلة والسّريعة، وفى خضمّ كلّ ذلك ينبغى للكاتب أن يعرف كيف يثير انتباهه ويشدّه بعمل محترم وذى قيمة.
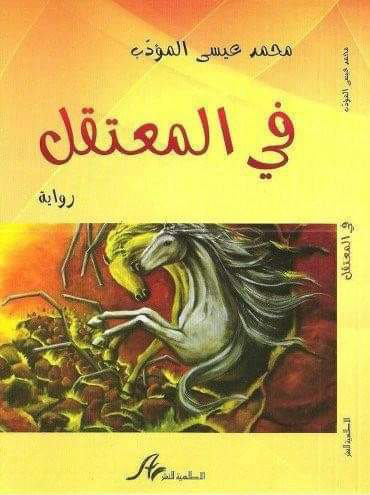
■ هل سبق أن صدمك قارئ بتأويل لم يخطر لك؟ وكيف تتعامل مع القراءات غير المتوقعة؟
- حدث ذلك فى خيمة أدبيّة تحتضن معرض كتاب بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة عندما كنت بصدد تقديم رواية «حمّام الذّهب». فقد كفّرنى أحدهم أمام الحاضرين لمجرّد أنّى كتبتُ عن يهود القرانة، وهم أقليّة من الأقليّات التّونسيّة. كان الأمر مُربكًا وصادمًا، وكان علىّ أن أحافظ على هدوئى وتوازنى وأنا أسأله: هل قرأت الرّواية؟ لكنّه فاجأنى أنّه لم يقرأ الرّواية ولن يقرأها حسب تعبيره لأنّها تتحدّثُ عن الكفّار. تلك الحادثة جعلتنى لا أستغربُ أى ردّ فعلٍ من أىّ قارئ، وتهيّأتُ فعلًا فى لقاءات أدبية أخرى لأتجنّب أى شكل من أشكال التوتّر. وفى الواقع ما دام الكتاب خرج إلى القارئ فليس من حقّى أن أرفض أو أصادر أى رأى حوله، حتّى لو كان خاطئًا، وحاقدًا، ومُجانبًا للصّواب تمامًا.
■ ما العادة التى تحافظ عليها قبل الكتابة؟ وهل لديك طقوس تخجل من الاعتراف بها؟
- قبل الكتابة أقرأ كثيرًا، ولا أقرأ الرّوايات فقط، أقرأ كلّ شىء يُتاح لى، فما أحرصُ على كتابته ليس حكاية مسلّية تُروى، بل هو حامل لرؤية وخلفيّة فكريّة، وهو منتج لمعرفة، لذلك لا بدّ من حُسن الاستعداد بالقراءة المُتبصّرة والمتأنّية. أحرصُ كذلك قبل الكتابة على زيارة الأماكن التى يُفترضُ أن تكون فضاءات الرّواية، أُصغى إلى الأصوات، وأشتمّ الرّوائح، وأدقّق فى المعمار. أبحثُ كذلك عن الأسماء، أسماء الشخصيّات تحتاج أيضًا إلى تدقيق، فليس أى اسم قادرًا على أن يكون اسمًا روائيًّا، كما أسعى إلى عدم تكرار أسماء كنتُ قد استعملتها فى روايات سابقة.
نعم، لدىّ طقوس فى الكتابة، خاصّة جدًّا، صحيح أنّى أخجل من الاعتراف بها، لكنّها تخصّنى أنا وحدى، فى عالمى الحميمى، ولا حاجة لأحدٍ بأن يعرفها، هكذا أعتقدُ.
■ ماذا خسرت بسبب الكتابة؟ وماذا كسبت منها ولم يستطع أحد غيرها منحه لك؟
- خسرتُ الكثير، منها أن أكون صاحب مالٍ وفيرٍ. خسرتُ أيضًا الكثير من الأصدقاء، لا أدرى ماذا يحدث معهم عندما أصدرُ كتابًا جديدًا؟ فأنا أتفطّن إلى أنّ بعض الأصدقاء قد انسحبوا من حياتى، ولستُ حزينًا بسببِ ذلك، على كلِّ حالٍ. كلّ شىءٍ صار عاديًّا ولا يستحقُّ الانشغال.
كسبتُ من الكتابة ما لم أتعلّمه فى المعاهد والجامعة، الدّراسة فى الواقع كان هدفها فى نهاية الأمر إحراز الشّهادة التى ستمكّننى من أن أكون مواطنا مُفيدًا وصالحًا، أمّا الكتابة فهى تدرّبنى كلّ يومٍ على أن أكون إنسانًا وأبقى كذلك.
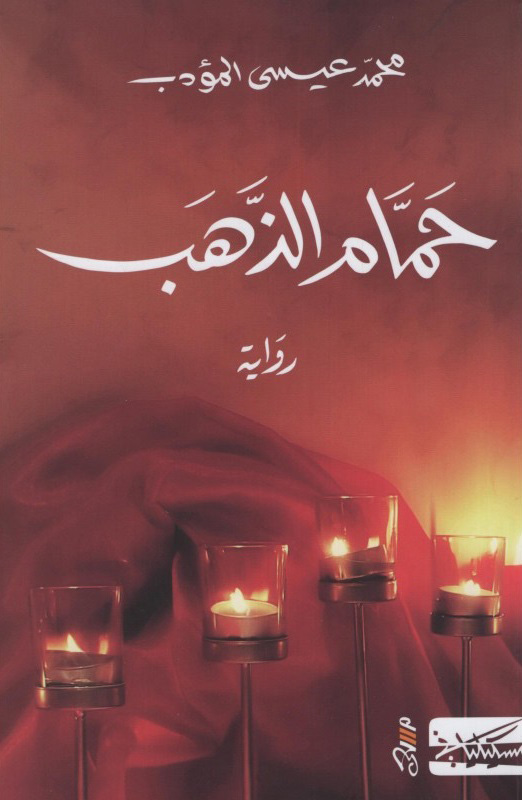
■ ما الفكرة الروائية التى تخشى الاقتراب منها رغم أنّها ترافقك منذ سنوات؟
- هناك فكرة روائيّة أخشى الاقتراب منها منذ نحو سبع سنوات، تعيش معى كلّ يوم، وكلّما أنهيتُ رواية جديدة يهزّنى الحماس لكتابتها، لكن سرعان ما أقرّرُ تأجيلها من جديد. صحيح أنّ الفكرة سياسيّة، وعلى غاية من الدقّة والأهميّة عندى، لكن أعتقدُ أنّ دماغى الرّوائى لم يمنحها بعد الضّوء الأخضر حتّى تكتب وتصل إلى القارئ الذى يُقبلُ بشدّة على مثل هذه الأفكار.
■ ما رأيك فى موجة الكتابة السّريعة والنجوميّة الافتراضية التى باتت تنتج كتّابًا بلا نصوص؟
- اسمها موجة، وصفتها أنّها سريعة، غير قادرة على نحت تجربة أو شخصيّة أدبيّة بعمقٍ فكرى، كلّ ما هنالك عبور فيسبوكى يُثير ضجّة، وتبادل الصّور وأجمل التّهانى، ثمّ يسدل السّتار. النّجوميّة الافتراضيّة لا تُثيرُ قلقى، باعتبارها ظاهرة عابرة، ما يقلقنى فعلًا اقتناء أشخاص لروايات أو مجموعات قصصيّة وشعريّة من أصحابها، ثمّ التّباهى بها فى المنصّات ووسائل الإعلام بكلّ نخوة واعتزاز. هذا الأمر السّخيف للأسف صار منتشرًا بكثرة فى السّنوات الأخيرة، وهو بمثابة عمليّات تحايل وغسيل أموالٍ.
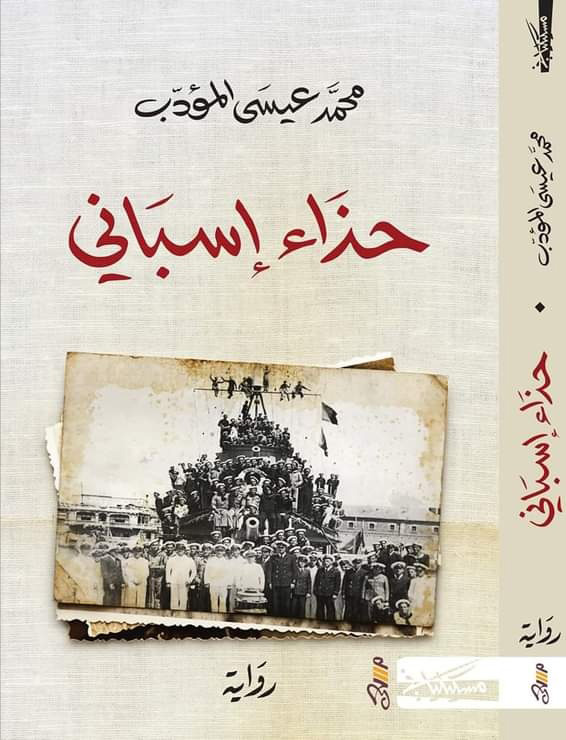
■ لماذا انقطعت عن الكتابة أربعة عشر عامًا، من 1999 إلى 2013؟
- كنتُ فعلًا قد توقّفتُ عن الكتابةِ بعد أن أصدرت مجموعتين قصصيّتين، الأولى عنوانها «عرس النّار» وحازت على جائزة الدّولة لأدب الشّباب فى صنفِ القصّة القصيرة، والثّانية بعنوان «أيّة امرأةٍ أكون؟». فى الحقيقة ابتعدتُ تمامًا عن الكتابة بعد محاولة مصادرة مجموعتى القصصيّة الثّالثة «هيلينا». وبعد ثورة 2011، حاولت إعادة كتابة هذه المجموعة القصصيّة، غير أنّى، ويا للغرابة، كتبتُ روايتى الأولى وعنوانها «فى المعتقل».








