«من دفع للزمار؟!».. آخر كتاب قرأه هيكل
الحرب الباردة الثقافية.. تمويل وتطبيع وجوائز برعاية الـ«CIA»

- هيكل تعليقًا على الكتاب: هل يكفى نزع اللافتات لنزع التهمة عن طرف وإلصاقها بطرف آخر؟!
- فرانسيس سوندرز: كيف يمكن للفن أن يكون مستقلًا فى الظاهر وملوثًا بأغراض سياسية من جهة خفية؟!
- د. عاصم الدسوقى: كانت الخطة تتلخص فى أن يقوم شيوعيون بنقد الشيوعية بمقال أو مسرحية أو رواية.. تبدأ بما جعلهم يعتنقونها وتنتهى بما يجعلهم يتوبون عنه
على كثرة الكتب التى تتناول العلاقة بين أجهزة الاستخبارات العالمية، والأمريكية على وجه الخصوص، وبين تسييس الثقافة والفنون والآداب، وتوظيفها لأهداف سياسية ربما لا يعرف بها أو ينتبه إليها المتورطون فى الترويج لها من كتاب ومفكرين وفنانين من مختلف دول العالم، فيما يتم التخطيط لها وتمويلها بسخاء من قبل هذه الأجهزة، يبقى كتاب «من دفع للزمار؟.. الحرب الباردة الثقافية.. المخابرات المركزية الأمريكية وعالم الفنون والآداب» لمؤلفته الإنجليزية فرانسيس ستونر سوندرز، وترجمة الراحل الدكتور طلعت الشايب، حالة فريدة وشديدة الأهمية، تجعلنى شخصيًا أعيد شراءه والبحث عنه إن اختفت نسخته من مكتبتى أو لم أعثر عليها لسبب أو لآخر، بل وأوصى أى مقبل على التفاعل مع الأوساط الثقافية والفنية بضرورة قراءته واقتناء نسخة منه للعودة إليها كلما التبست عليه الأحداث والظروف والمواقف.. وخصوصًا فى ظل ما يحدث فى مصر والعالم العربى من جهل بقواعد اللعبة الأمريكية المتكررة والدائمة، واستسهال فى التعامل مع كثير من قضايانا الخلافية، وسوءٍ فى عاداتنا القرائية، واعتماد عدد لا بأس به من الكتاب والمحررين الثقافيين على ثقافة التلقين الشفاهية، دون قراءة حقيقية متمعنة فيما بين أيديهم من كتب ووثائق ومعلومات، وكلها متاحة، يسهل الحصول عليها والوصول لها فى زمنٍ لم يعد البحث فيه عن معلومات بحاجة إلى أكثر من كتابة عدد من الكلمات على مواقع البحث الكثيرة، متخصصة وغير متخصصة، وفى ظل تزامن تلك الحالة التى لا أريد الذهاب بها إلى نظرية «المؤامرة»، مع محاولات مستميتة لاختراق الأوساط الثقافية المصرية والعربية، وتمرير التطبيع الثقافى مع الكيان المحتل للأراضى الفلسطينية تحت ستار البحث عن السلام واستقرار المنطقة، وشعارات الحرية والعدالة والتفريق بين الديانة اليهودية والانتماء السياسى لدولة الاحتلال، وغيرها من المسميات البراقة والمغرية لمن يجهلون حقيقة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والدعم الأمريكى الدائم وغير المشروط لسلطات الاحتلال، أو يحاولون القفز عليها، وهى المحاولات التى لا تتوقف منذ منتصف القرن الماضى، ويتم الإنفاق عليها بسخاء، والترويج لها فى مختلف دول العالم، بمختلف الطرق والحيل والأساليب الملتوية، وبدعم غير مفهوم من شخصيات وجهات ودول عربية، بداية من ذلك العدد الكبير من الجوائز المالية الضخمة، والندوات المدفوعة، والاستضافات الكاملة، والترجمات المشوهة باسم «التحرير الأدبى»، وغيرها من الطرق والأساليب التى تحدث عنها الكتاب باستفاضة كاملة، مستعينًا بما أتيح لمؤلفته من وثائق، واعترافات شخصية، خصوصًا مع تورط بعض فصائل اليسار التروتسكى فيها برغم تعارضها مع ما يروجونه من مبادئ وشعارات لا ظل لها على الأرض، وهى ذات الفصائل السياسية التى يكشف الكتاب كيف تم استخدامها من قبل المخابرات المركزية الأمريكية، المعروفة اختصارًا بالـ«سى آى إيه»، طوال سنوات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى «سابقًا» وما بعدها، وتوظيفها لتمرير ما كانت تهدف إليه من توجيه للأفكار، وتغيير للمواقف، وتأثير فى الأجيال الجديدة من الكتَّاب الشبان الطامحين فى الجوائز باعتبارها بوابة التحقق والترجمة والانتشار.
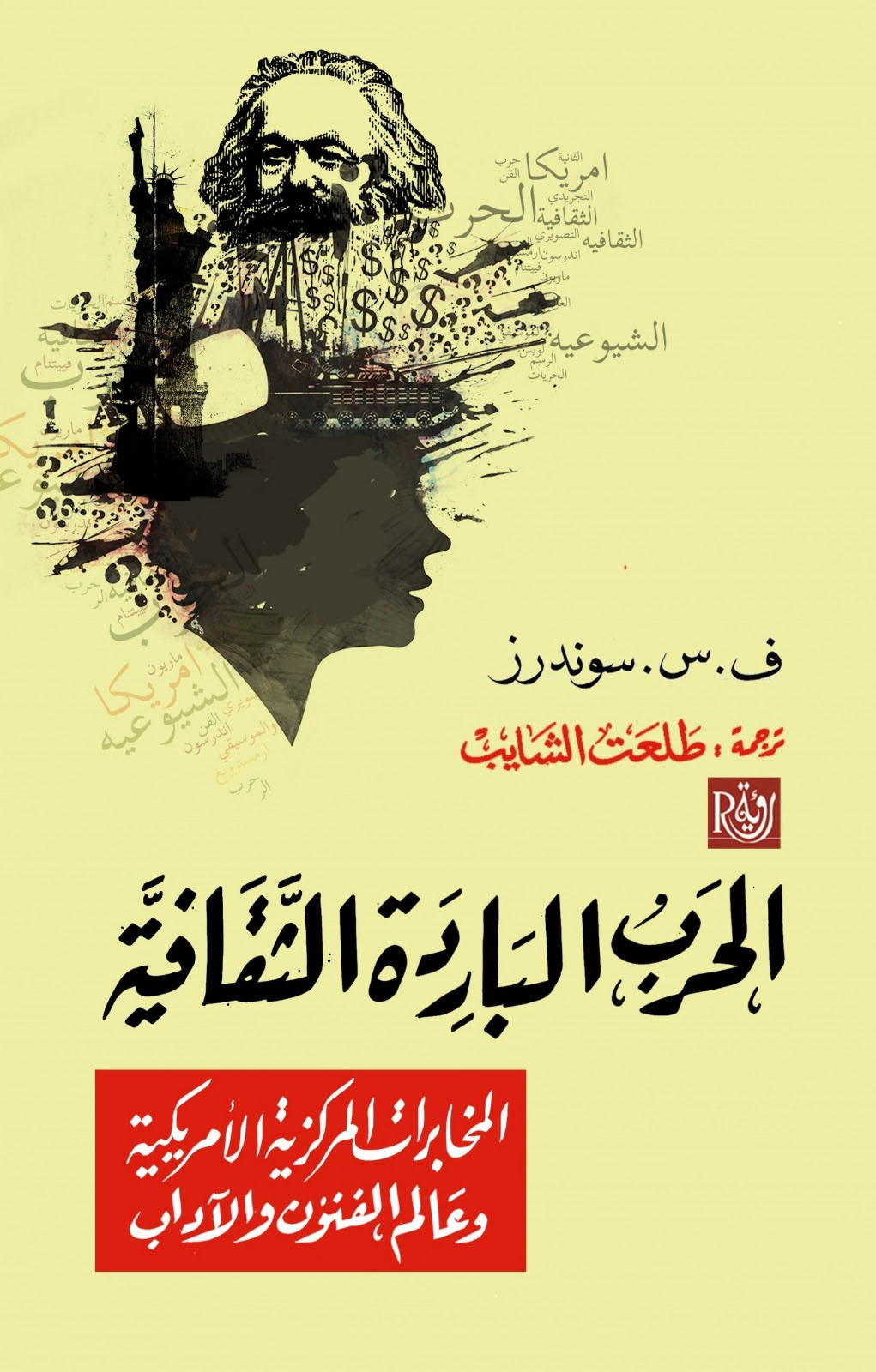
ملاحظات هيكل و«بوتقة» ميللر
لعله من المناسب أن أذكر هنا ما قاله الكاتب الصحفى أنور عبداللطيف فى مقال بالأهرام فى فبراير ٢٠٢٤، حول هذا الكتاب المهم باعتباره «آخر كتاب قرأه الأستاذ محمد حسنين هيكل، وتركه على مكتبه وبداخله كتب آخر الملاحظات فى حياته بخط يده»، وهو الكتاب الذى قدم له المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، وصدرت طبعته الإنجليزية الأولى عام ١٩٩٩ بعنوان «من الذى دفع للزمار؟»، وصدرت طبعته الثانية فى نيويورك عام ٢٠٠٠، فيما صدرت طبعته المصرية الأولى عن المشروع القومى للترجمة فى عام ٢٠٠٣، ويذكر عبداللطيف أنه حصل على صورة من تعليق هيكل على الكتاب، وأنه لم يزد على عبارتين موجزتين، إحداهما «مسرحية أرثر ميللر»، والثانية «هل نزع اللافتات يكفى لنزع التهمة عن طرف وإلصاقها بطرف آخر؟!»، ويقول إنه عندما بحث عن مسرحية ميللر المقصودة وجد أن هيكل ربما كان يقصد مسرحية «البوتقة» التى فضح فيها ميللر «الحقبة المكارثية فى أمريكا والعالم الرأسمالى حين كانت ترفع لافتة مكافحة الشيوعية لأخذ الناس واحتلال الدول بالباطل باسم الحريات والحقوق المدنية»، وهى ذات الفكرة التى ينطلق منها الكتاب، والتى بدأت بحسب عبداللطيف حين لاحظت مؤلفته سلسلة مقالات تشيد بدور المخابرات الأمريكية بما تقدمه من دعم لمدرسة نيويورك فى الفن، فقضت عامًا كاملًا للتنقيب عن السر حتى أسفر بحثها عن فيلم وثائقى من أربع حلقات بعنوان «أيادٍ خفية، تاريخ مختلف للحداثة»، تم بثه عام ١٩٩٥، وحملت الحلقة الأولى منه عنوان «الفن ووكالة المخابرات المركزية»، وكان هذا العمل هو النواة الأولى لكتاب «من دفع للزمار؟»، الذى كشفت فيه العالم الخفى لتسييس الثقافة والفن والأدب، واستخدام المخابرات المركزية الأمريكية التمويل المشبوه للمؤسسات الثقافية والصحف والمطبوعات والسينمات والإذاعات والمؤتمرات ومعارض الفن والمهرجانات والمنح والجوائز لتوجيه ضرباتها إلى جبهة الثقافة العريضة، ما دفع مؤلفته للتساؤل: كيف يمكن للفن أن يكون فى الظاهر مستقلًا، وملوثًا بأغراض سياسية من جهة خفية؟».

وتتجلى أهميته فى الجانب التوثيقى للوقائع والأحداث التى اعتمدتها المؤلفة، وما صاحبها من حوارات أجرتها مع عدد من الشخصيات المتورطة بصورة أو بأخرى بمراحل تلك الحرب، ويتساءل الباحث العراقى الدكتور عبدالخالق كاظم إبراهيم، فى عرضه للكتاب بموقع مركز «البيدر للدراسات والتخطيط» عن كيفية حصول الباحثة على هذا الكم والحشد الرهيب من الأسرار والحقائق والأرقام والوقائع والصفقات والمؤامرات وعمليات التلاعب والخداع؟ وما هى الوثائق والمقابلات والأصول والأساليب التى أتاحت لها أن تخرج على العالم بكتاب على هذا القدر من الجرأة والجسارة؟ وهو ما تجيب هى عنه فى مقدمة الكتاب بقولها إنها «كانت فى جوهرها رحلة تشرد هائلة، انطلقت فيها ومعها ملفاتها وصناديقها الحافلة بالوثائق من مكان إلى آخر»، وتوضح أنها «كانت تعلق آمالًا كبيرة على الاستفادة من قانون حرية المعلومات الأمريكى فى الكشف عن العديد من الوثائق الحكومية التى كانت محظورة فى السابق، وتم كشف النقاب عنها، إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة عندما تقدمت بطلب رسمى للحصول على وثائق ينطبق عليها القانون، ولم تتمكن من الحصول عليها، إذ أوضح لها منسق المعلومات والخصوصية فى الجهاز الأمريكى أن فرص التعامل الناجح مع الطلب الذى تقدمت به للحصول على الوثائق من الـ«سى آى إيه» وفقًا للقانون الأمريكى تؤول إلى الصفر بصورة فعلية، فلم يكن أمامها من بديل إلا اللجوء إلى الوثائق الموجودة فى المجموعات الخاصة، حيث مدت إدارات أمريكية متتابعة تعاونها إلى القطاع الخاص، فشاركت مجموعات من المؤسسات والشخصيات غير الحكومية، ما أدى إلى توافر إمكانية التدقيق فى العديد من العمليات، بما فى ذلك العمليات السرية. وساعد فى ذلك وجود أرشيفات ومكتبات تقدم ثروة حقيقية للباحثين.

يد تحمل الخبز وفى الأخر ثقافة الدولة المانحة
عبر ستة وعشرين فصلًا وخاتمة، تستعرض الكاتبة مراحل تطور ثقافة الحرب الباردة للولايات المتحدة خلال عقدين من الزمن وفق استراتيجية ملتفّة بعباءة «الحرية الثَّقافية» و«الدفاع عن الإيمان»، وتقدم بانوراما هائلة للحملة السرية التى شنتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتحويل عدد من أبرز أنصار حرية الثَّقافة والفكر إلى أدوات يجرى التلاعب بها من جانب الوكالة، وتوضح كيف تسلل الجهاز إلى كل ركن فى المعمار الثَّقافى العالمى، وكيف قامت المنظمات والمؤسسات «الخيرية» التى تتخذها واجهة لنشاطها فى هذا المجال بعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض والإشراف على الحفلات الفنية ونقل فرق الأوركسترا فى مختلف أرجاء العالم، وتصدت لرعاية الفن التجريدى كرد على الواقعية الاشتراكية، ودعمت مشروعات باهظة التكلفة للنشر والترجمة، ودفعت بعناصر تابعة لها إلى دعم صحف ومجلات فى أوروبا وغيرها من أرجاء العالم وإلى تغطية خسائرها.
ويقول الدكتور عاصم الدسوقى فى مقدمته الوافية للكتاب إنه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت الحكومتان السوفيتية والأمريكية تعيدان النظر فى ترتيب أوراق الصراع، والبحث فى كيفية الهيمنة على العالم عن طريق زيادة مساحة الأنظمة التابعة أو المؤيدة أو المتعاطفة، فأسرع «الاتحاد السوفيتى» بضم دول شرق أوروبا التى حررها من الاحتلال النازى، وشرع فى دعم الأحزاب الشيوعية، أما الولايات المتحدة فعملت على استعادة الحالة الطبيعية بينها وبين أوروبا، ولكنها أدركت أنه ليس مضمونًا أن الدول التى تتلقى مـسـاعـداتها الاقـتـصـاديـة يمكن أن تتخلى تلقائيًا عن الاشتراكية، ومن هنا اتجهت إلى تصويب ضرباتها على جبهة الثقافة العريضة، بما تشمله من أفكار وفنون وآداب وعلوم وكل ما يتعلق بالكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية، فى محاولة متواصلة لتغيير أذهان الشعوب على كراهية الشيوعى بتقديم النموذج الرأسمالى الأمريكى ثقافيًا بأبعاده فى الحرية الفردية، والعمل على استزراعه فى مختلف البيئات، وبمعنى آخر «يد تقدم الخبز ويد تقدم ثقافة دولة الخبز فيحدث التحول التدريجى من الثقافة الشيوعية إلى الثقافة الرأسمالية».
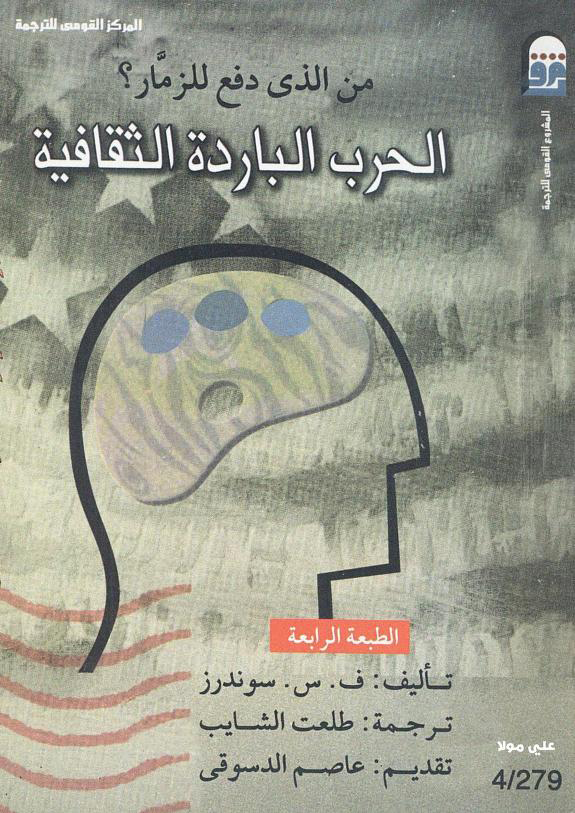
ويوضح المؤرخ الكبير أنه: فى يوليـو ١٩٤٧، أنشـأت الحكومـة الأمـريـكيـة جـهـاز المخابرات المركزية ليتولى الجانب الثقافى فى الحرب الباردة، وتكوَّن فى الأساس من بعض أعضاء مكتب الخدمات الاستراتيجية الذى كان الرئيس هارى ترومان قد حله قبلها بعامين، وأبرزهم آلان دالاس الذى كان قد كون فى نيويورك، بعد تصفية المكتب، مركزًا للخدمات الخاصة، ومعه كیرمیت روزفلت، وهما من أبرز أسماء الجهاز الذى كانت أول أعماله تكوين واجهة ثقافية يعمل من خلالها فى الخارج، فكان التجمع الذى يضم مـجـمـوعـة من الراديكاليين ممن تحطم إيمانهم بالشيوعية، وأصابهم الإحباط بسبب سياسات ستالین القمعية، وكانت الخطة تتلخص فى أن يقوم هؤلاء أنفسهم بنقد الشيوعية من خلال مختلف الوسائط، كتابة مقال، أو إلقاء محاضرة عامة، أو كتابة رواية أدبية، أو عمل مسرحى، على أن يدور خطابهم حول ما الذى جعلهم يعتنقون الشيوعية؟ وما الذى جعلهم يتوبون عنها؟. والمعنى من وراء ذلك باختصار شديد هو أن تتم مـحـاربة الشيوعية بواسطة شيوعيين انشقوا على الشيوعية حتى يكون خطابهم أكثر إقناعًا من خطاب عناصر رأسمالية عادية.
وعندما افتتح السوفييت بيتًا للثقافة فى برلين لبناء ثقافة شيوعية، أسرع الأمريكيون بافتتاح المراكز الثقافية فى مختلف بلاد العالم لتقديم الثقافة الأمريكية من خلال عروض السينما وحفلات الموسيقى والمعارض الفنية والمحاضرات العامة وإرسال فرق موسيقية من زنوج أمريكا لتغيير المفهوم الشائع عن العنصرية الأمريكية. وأعطيت للجهاز صلاحيات هائلة ومطلقة ليفعل ما يشاء من أجل حماية الصورة الأمريكية التى ترسمها وسائل الدعاية والإعلام فى خيال الآخرين، ومنها استخدام الأنشطة النفسية السرية لدعم السياسة الأمريكية، والحق فى إنفاق الأموال اللازمة لتمويل نشاطه دون تقديم بيانات عن أوجه الصرف حتى لا يترك مستندًا يدل على دور للحكومة.
ويوضح الدكتور عاصم الدسوقى أنه «كانت باكورة الأعمال الثقافية المنظمة للجهاز كشف الشيوعيين الأمريكيين أولًا وتعريتهم أمام مجتمعهم». وجاءت الفرصة عندما قرر مكتب الإعلام الشيوعى «الكومينفورم» فى مارس ١٩٤٩، السوفييتى تنظيم مؤتمر فى فندق «والدورف أستوريا» بنيويورك بجهود الشيوعيين الأمريكيين بغية التلاعب بالرأى العام الأمريكى فى عقر داره، والتقطت المخابرات الأمريكية الفرصة، وتغلغلت فى المؤتمر، ولعبت به بمشاركة الشيوعيين التائبين، ومن ثم تمكنت من رصد الشيوعيين الأمريكيين بسهولة، وأكثرهم شهرة آنذاك النجمان شارلى شابلن ومارلون براندو.
وفى الوقت نفسه أعدت المخابرات الأمريكية قوافل من الموسيقيين فى جولة حول العالم لتقديم الذوق الأمريكى، وإعادة عرض التراث الموسيقى العالمى بوجهة نظر أمريكية، فمثلًا أوبرا «ريجوليتو» يعاد إعدادها بصياغة معادية للفاشية على المسرح الألمانى، ويمنع عرض مسرحية «يوليوس قيصر» لأنها تمجد الديكتاتورية، وكذا مسرحية تولستوى «الجثة الحية» لأنها نقد اجتماعى يخدم أهدافًا غير رأسمالية، ويتكون أوركسترا برلين الفلهارمونى ليكون حصنًا واقيًا ضد الشمولية السوفيتية بما يقدمه من معزوفات خارج القوالب الموسيقية الشائعة.
وفى مايو ١٩٤٩ شكلت المخابرات اللجنة القـومـيـة من أجل أوروبا الحـرة لاستخدام المهارات المتنوعة لليهود الشرقيين فى المنفى من أجل تطوير برامج تتصدى بنشاط للسيطرة السوفيتية، وكان من أعضائها شخصيات بارزة فى مجلات متنوعة منها على سبيل المثال المخرج السينمائی سیسیل دی میل وداريل زانوك، والممثل رونالد ريجان.

ولإحكام الحصار على الشيوعية والشيوعيين فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى العالم قامت المخابرات الأمريكية عام ١٩٥٠ بتأسيس منظمة ثقافية جديدة باسم «منظمة الحرية الثقافية»، تحولت فى عام ١٩٦٧ إلى «الاتحاد الدولى للحرية الثقافية»، وقامت هذه المنظمة بإنشاء فروع لها فى خمس وثلاثين دولة تم اختيارها بعناية، وأصدرت أكثر من عشرين مجلة ذات تأثير كبير، وقامت بتنظيم المعارض الفنية والحفلات الموسيقية، فتعددت أنشطة جهاز المخابرات الأمريكية، ونجح فى إقامة مختلف الواجهات الفكرية والإعلامية والفنية والتجارية لخدمة أغراضه، وفى هذا الإطار صدرت فى ١٩٥٢، مجلات «کومنتری»، و«نيـوليـدر»، و«پارتیزان ريفيو»، وبعدها بعام واحد صدرت مجلتا «العلم والحرية» و«إنكاونتر»، واستكتبتا أسماء لامعة، ومشهورة مثل المؤرخ أرنولد توينبى، والفيلسوف برتراند راسل، وهربرت سپنسر، وكلها مجلات ضد الشيوعية.
وخارج أمريكا كانت المخابرات وراء إصدار عدة مجلات ثقافية ترمى جميعها بأسلوب غير مباشر لتشويه الشيوعية، وشهد عام ١٩٥٥ إصدار مجلات «سوفیت سیرقى» يرأسها وولتر لاكير، و«تيمپو برزنت» بإيطاليا، و«كوادرات» فى أستراليا، و«كويست» فى الهند، و«جيو» فى اليابان، وتمت الاستعانة بمؤسسة «فورد» لتنفيذ مشروعات مشتركة بواسطة الجامعيين، وكذا مؤسسة «روكفلر» التى كان هنرى كيسنجر أحد خبرائها، والمعروف أن «منظمة الحرية الثقافية» كانت وراء عدم فوز شاعر شيلى الشهير بابلو نيرودا بجائزة نوبل عام ١٩٦٤، ولم يفز بها إلا فى عام ١٩٧١ حين كان سفيرًا فى فرنسا لحكومة سلفادور الليندى الموالية للديمقراطية، ومع هذا قتلته المخابرات الأمريكية بعدها بعامين، وفى منتصف ستينيات القرن العشرين، والحرب الباردة فى عنفوانها كان لـ«نادى القلم الدولى»، الذى أسسته منظمة «الحرية الثقافية»، ٧٦ فرعًا فى ٥٥ دولة، وبذلت المخابرات الأمريكية كل ما تستطيع من جهد لتحويله إلى منبر لخدمة المصالح الأمريكية.









