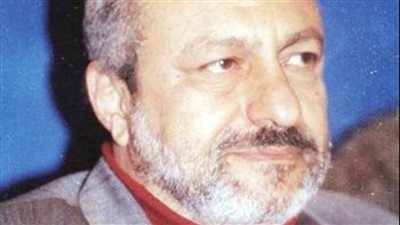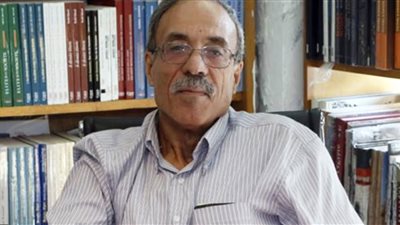آدم هنية: نعيش لحظة خطرة فى تاريخ العالم

- كثير من الجامعات العربية يُعيد إنتاج المقاربات المعرفية الاستشراقية دون مساءلة
- نحتاج إلى إعادة التفكير فى المنظومات المعرفية السائدة وإنتاج أشكال جديدة من النقد للنظام العالمى
- تحولات الطاقة فى النظام الرأسمالى لا تعنى استبدال مصدر بآخر بل ضمّ مصادر جديدة إلى المنظومة القديمة
- إنتاج المعرفة يتشابك دومًا مع بُنى السلطة الاقتصادية والسياسية ويهدف إلى تمكين القوى الإمبريالية من الشعوب الواقعة تحت سيطرتها
- التحولات التكنولوجية تحمل خطر تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية عالميًا وتكريس التفاوتات القائمة
- يمكن فهم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فى سياق التراجع النسبى للهيمنة الأمريكية فى المنطقة خلال العقدين الأخيرين
- المشروع السياسى لترامب محاولة لمواجهة أزمات الرأسمالية الأمريكية والعالمية بنقل كُلفتها إلى أطراف أخرى
من منظور تحليلى يستند إلى الماركسية وأدواتها النقدية، يقدّم الباحث فى الاقتصاد السياسى آدم هنيّة مقاربة جديرة بالاهتمام لفهم تعقيدات عالمنا المعاصر، لا سيّما ما يتصل بالبنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تنتجها الرأسمالية فى طورها النيوليبرالى. ينهض تصوره فى أعماله المتعددة على تفكيك النظام الرأسمالى بوصفه منظومة تاريخية شاملة تتشكّل باستمرار عبر أنماط التراكم والهيمنة وإعادة إنتاج التفاوتات على الصعيدين المحلى والعالمى. ومن خلال هذه الرؤية، يقرأ هنيّة الأزمات المحتدمة فى منطقة الشرق الأوسط، واضعًا إياها فى سياقها التاريخى والجيوسياسى الأوسع، بما يكشف الارتباط الوثيق بين تحولات المنطقة وبنية النظام الرأسمالى العالمى، من الحروب والتدخلات الأجنبية، إلى إعادة تشكيل الطبقات، وصولًا إلى الدور المتصاعد لرأس المال الخليجى فى صوغ ملامح النظام الإقليمى.
ويعد آدم هنية من الأسماء اللامعة فى دراسات الاقتصاد السياسى والتنمية فى العالم العربى، إذ يشغل حاليًا منصب أستاذ الاقتصاد السياسى والتنمية العالمية فى جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وقد عمل أستاذًا فى دائرة دراسات التنمية فى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية فى جامعة لندن. وقبل الالتحاق بجامعة لندن، درّس فى جامعة زايد فى الإمارات العربية المتحدة، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة يورك فى كندا فى 2009. وقد حظيت أعمال هنية باهتمام عالمى ونال بعضها جوائز بارزة، وتُرجم له إلى العربية عملان، هما: «جذور الغضب.. حاضر الرأسمالية فى الشرق الأوسط»، و«الرأسمالية والطبقية فى دول الخليج العربية».
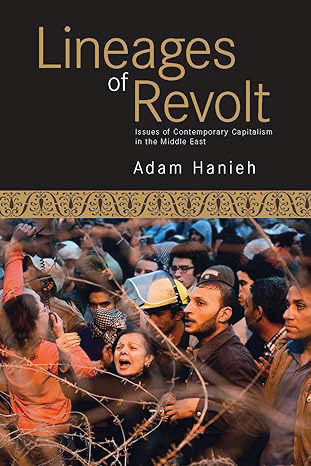
فى كتابه الأحدث، «Crude Capitalism»، يقدّم آدم هنية قراءة جذرية لتاريخ النفط فى علاقته بالنظام الرأسمالى العالمى، مؤكدًا أن فهم دور النفط لا يكتمل دون إدراك كيف شكّلت الرأسمالية هذا المورد وجعلته محورًا حيويًا لبقائها وتوسّعها.
يوضح هنية فى كتابه أنه منذ منتصف القرن العشرين، كان النفط نقطة انعطاف فى البنية الاقتصادية والسياسية للعالم، إذ منح النفط النظام الرأسمالى القدرة على إعادة تشكيل الإنتاج والاستهلاك بشكل لم يكن ممكنًا فى ظل الاعتماد على الفحم مصدرًا للطاقة، فتسارعت وتيرة الاستهلاك والتوسع الصناعى، ونشأت أنماط جديدة من الحياة، كانت كلها مشروطة بالنفط.
يبين الكتاب كيف جرى تنظيم صناعة النفط بطريقة تخدم مصالح الشركات الكبرى والدول الإمبريالية، وكيف أن السيطرة على النفط كانت صراعًا استراتيجيًا تحكمه التحالفات الدولية، خاصة مع بروز الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، كما يناقش كيف صار الشرق الأوسط مسرحًا لصراعات النفوذ والتدخلات الغربية جراء ذلك.
وفى كتابه الأسبق المترجم إلى العربية بعنوان «جذور الغضب» تتبع هنية الكيفية التى تداخلت بها المصالح الاقتصادية والسياسات النيوليبرالية مع تشكّل الدولة والسلطة والطبقات الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط، رابطًا قضايا تلك المنطقة بالبنى العالمية للرأسمالية، فأشار إلى أن فهم ما جرى فى السنوات الأخيرة، من ثورات وانتفاضات، لا يمكن أن يتم دون الرجوع إلى ديناميات الاقتصاد السياسى، وارتباط الاقتصادات المحلية بمنظومة رأس المال العالمى.
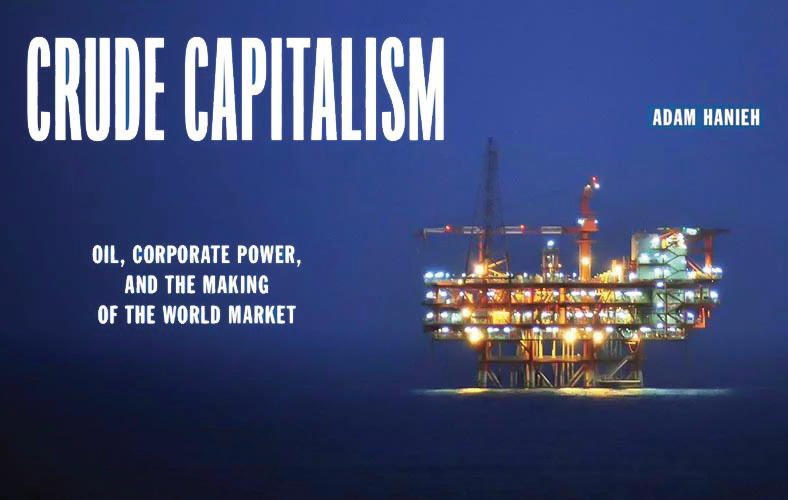
أشار هنية فى كتابه إلى أن التحولات التى شهدتها المنطقة، برعاية المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد، كانت أدوات لإعادة تشكيل السلطة والثروة على أسس تخدم التراكم الرأسمالى وتربط مصالح الطبقات الحاكمة المحلية بمراكز القوة العالمية، كما أولى هنية اهتمامًا خاصًا لدور دول الخليج، بوصفها قوى مالية ضخمة أسهمت فى إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة من خلال الاستثمارات والسيطرة على قطاعات واسعة من اقتصادات الدول المجاورة.
يعيد هنية فى أعماله الاعتبار إلى الاقتصاد السياسى بوصفه مدخلًا لفهم ما يجرى فى المنطقة، ويقدّم أدوات نظرية لفهم العلاقة بين رأس المال والدولة، وبين ما هو محلى وما هو عالمى، رافضًا التحليلات التى تختزل كل شىء فى نظرة أحادية. وفى هذا الحوار مع «حرف» نناقش مع الباحث الأردنى المولد، والمقيم حاليًا فى بريطانيا؛ آدم هنية رؤيته النقدية وأفكاره حول بنية الرأسمالية العالمية، وعلاقتها بالتحولات فى الشرق الأوسط، كما نطرح عليه أسئلة حول دور التكنولوجيا، ومكانة النفط، والعلاقات غير المتكافئة بين المركز والأطراف، فى تشكيل ملامح النظام الاقتصادى والسياسى المعاصر.

■ تعتمد فى كثير من تحليلاتك على مقاربة ماركسية للاقتصاد السياسى.. ما الإمكانيات التى يتيحها هذا المنهج لفهم التطورات العالمية الراهنة برأيك؟
- نحن نعيش لحظة يُنتج فيها النظام الرأسمالى ليس فقط مستويات غير مسبوقة من اللامساواة، بل يدفع أيضًا نحو انهيار بيئى وخلل اجتماعى واسع النطاق. يُجبر ملايين البشر على النزوح بسبب الحروب، وتغير المناخ، واستفحال الاستقطاب الاقتصادى.
فى هذا السياق، أرى أن الماركسية لا تزال تمثل أداة تحليلية ضرورية وقوية لفهم هذه التحولات فى عالمنا. فهى لا تكتفى بوصف الأعراض، بل تمكّننا من إدراك المنطق الكامن وراء نظامٍ يقوم على التراكم اللامتناهى والسعى المحموم وراء الربح. ومن هذا المنطلق، فإن ما تقوم به الدول والشركات والأثرياء لا يُفسَّر ببساطة باعتباره سلوك «فاعلين سيئين»، بل بوصفه تعبيرًا عن الضرورات البنيوية التى يفرضها النظام ذاته. وبدون هذا المنظور البنيوى، يصعب فهم الأزمات المتعددة التى نشهدها اليوم.
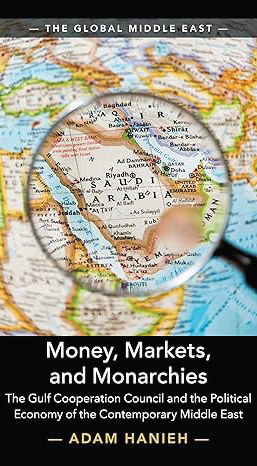
مع ذلك، ثمّة نقاشات متعددة ومواقف متباينة داخل التقليد الماركسى ذاته. وأعتقد أنه من المهم جدًا التعامل مع الماركسية لا بوصفها عقيدة جامدة، بل باعتبارها أسلوب تفكير حيًا ومتطورًا. من وجهة نظرى، تميل كثير من الكتابات عن ماركس، سواء من منتقديه أو حتى من بعض المنتمين للماركسية، إلى رسم صورة أحادية ومبسّطة لأعماله، ما يؤدى إلى تصور كاريكاتورى مضلل ونقاشات تقوم على مغالطات «رجل القش» المنطقية. فمثلًا، الادعاءات بأن ماركس كان خاضعًا فى فكره للحتمية التكنولوجية على نحو ساذج، أو أنه اختزل كل شىء فى الصراع الطبقى، لا تعكس بدقة ما كتبه ماركس فعلًا، ولا الطريقة التى اتبعها فى دراسة التاريخ والمجتمع. صحيح أن بعض من يُحسبون على الماركسية وقعوا فى هذه المشكلات، لكن علينا أن نبتعد عن التعامل مع كتابات ماركس كأنها نصوص مقدسة. لقد كان ماركس مفكرًا مرنًا، مستعدًا لتعديل آرائه فى ضوء المعطيات الجديدة، وكانت طريقته فى التفكير بعيدة كل البعد عن التفكير النمطى والصيغ الجاهزة.
■ فى كتابك الأحدث؛ «الرأسمالية الخام»، تجادل بأن النفط لعب دورًا محوريًا فى تشكيل طريقة عمل النظام الرأسمالى العالمى. برأيك، كيف يُسهم تاريخ النفط فى كشف طبيعة توازنات القوى بين الحكومات، والشركات العملاقة ومناطق العالم المختلفة؟ وما الذى تعتقد أنه ضرورى للخروج من هذا النظام القائم على النفط؟
- فى كتابى، أحاول أن أوضح كيف ولماذا أصبح النفط، فى منتصف القرن العشرين، الوقود الأحفورى الأساسى، فيما يُعرف بالتحول من الفحم إلى النفط. وباختصار، أرى أن ذلك يعود إلى ما قدّمه النفط للرأسمالية، إذ أتاح تسارعًا غير مسبوق فى معدلات الإنتاج والاستهلاك. غيّرت منتجات النفط، مثل البتروكيماويات والبلاستيك، جذريًا الطريقة التى كانت تعمل بها الرأسمالية فى منتصف القرن العشرين. كما أن الثروة النفطية كانت ضرورية لنشوء النظام المالى العالمى كما نعرفه اليوم، خاصة خلال سبعينيات القرن الماضى، وأسهمت فى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة بوصفها قوة اقتصادية وسياسية كبرى. كذلك غيّر النفط بشكل جذرى أساليب خوض الحروب، والتقنيات العسكرية المرتبطة بها. لفهم قوة النفط، علينا أن نعى كيف أنه متغلغل فى تفاصيل حياتنا اليومية، وفى بنية اقتصاداتنا وأنظمتنا السياسية.
يساعدنا هذا المنظور أيضًا على إدراك أن مواجهة هذا العالم المرتكز على النفط تتطلب قطيعة حقيقية مع الرأسمالية ذاتها. الأمر يتعلّق بإعادة توجيه أولويات النظامين السياسى والاقتصادى، من منطق السعى اللامحدود إلى الربح، نحو تلبية حاجات الناس والكوكب. ولا يمكننا الاعتماد فى ذلك على الحكومات أو الشركات، ولا على شركات النفط نفسها بطبيعة الحال.

■ برأيك.. كيف تسهم دول الخليج حاليًا فى دعم البنية الرأسمالية العالمية القائمة على النفط؟
- كانت دول الخليج مركزية فى صعود النفط باعتباره مصدر الطاقة الأحفورى المهيمن عالميًا طوال القرن العشرين، ليس فقط من خلال الإنتاج الفعلى وتصدير النفط، «والغاز الطبيعى الآن أيضًا»، بل كذلك من خلال دمج ثرواتها النفطية فى النظام المالى العالمى.
واليوم، بات هذا الدور أكثر أهمية من أى وقت مضى. إذ تُعدّ منطقة الخليج أكبر مُصدِّر للنفط والغاز الطبيعى المُسال فى العالم، ويأتى نحو ثلث واردات النفط العالمية من هذه المنطقة، لا سيما من السعودية. وعلى خلاف الماضى، فإن الجزء الأكبر من هذه الصادرات يتجه الآن شرقًا، وتحديدًا إلى الصين وشرق آسيا، ما يعنى أن الصعود الاقتصادى الصينى كان مرتبطًا بشكل وثيق بصادرات الطاقة الخليجية. وقد أدى ذلك إلى توسع سريع فى قطاع النفط فى المنطقة؛ فشركة «أرامكو» السعودية، على سبيل المثال، تُعد اليوم أكثر شركات النفط ربحًا فى العالم، وقد تجاوزت أرباحها فى العام الماضى أرباح شركات كبرى مثل «إكسون موبيل»، و«شل»، و«بى بى BP»، و«شيفرون»، و«توتال إنرجيز» مجتمعة.
أما على الصعيد المالى، فلا تقلّ أهمية الخليج. فبحسب بيانات ٢٠٢٤، هناك أربعة من أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية فى العالم متمركزة فى الخليج، وتدير مجتمعة أكثر من ٣.٥ تريليون دولار من الأصول. وإذا أضفنا إلى ذلك الصناديق الحكومية الأخرى، والإنفاق العام، والثروات الخاصة الضخمة فى الخليج، فإننا نتحدث عن فائض مالى هائل يتدفق إلى الأسواق الغربية عبر صفقات التسلح، والاستثمار فى الأسهم والسندات، ومشاريع البنية التحتية. تسهم هذه التدفقات فى تمويل العجز الأمريكى وتعزيز مكانة الدولار، ولهذا تعمل الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ على تحالفها مع الخليج. وليس من قبيل المصادفة أن أولى زيارات ترامب الخارجية فى كل من ٢٠١٦ و٢٠٢٤ كانت إلى السعودية.

■ هل تعتقد أن المشاريع الجديدة فى الخليج مثل «نيوم» والتحول نحو الطاقة الخضراء تمثل تغييرًا حقيقيًا فى هذا النظام أم أنها مجرد محاولات شكلية؟
- قد يبدو المشهد متناقضًا للوهلة الأولى. من جهة، تخطط دول الخليج مجتمعة لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير فى السنوات المقبلة. كما قال وزير النفط السعودى قبل عدة أعوام: «كل جزىء من الهيدروكربون سيُستخرج». ومن جهة أخرى، تسعى هذه الدول فى الوقت نفسه إلى تصدُّر مشهد «التحول الأخضر». ففى عام ٢٠١٨، كانت حصة الخليج من طاقة الرياح فى الشرق الأوسط لا تتجاوز ٦٪، ومن الطاقة الشمسية ٢١٪. أما اليوم، فقد ارتفعت هذه الأرقام إلى ٣٠٪ و٥٥٪ على التوالى. وتحتضن الإمارات أكبر محطة طاقة شمسية فى موقع واحد على مستوى العالم، وقد وضعت كل دولة خليجية أهدافًا طموحة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.

■ كيف نُفسّر هذا التناقض الظاهرى؟
- هنا أود التأكيد على نقطة أتناولها فى كتابى، وهى أن تحولات الطاقة فى ظل النظام الرأسمالى لا تعنى استبدال مصدر طاقة بآخر، بل إضافة مصادر جديدة إلى المنظومة القائمة، ما يؤدى إلى توسّع شامل فى إجمالى إنتاج الطاقة. وهذا ما نشهده تحديدًا فى الخليج، إذ يُضاف نمو الطاقة المتجددة إلى طبقة من التوسع المستمر فى الوقود الأحفورى. وتزداد أهمية ذلك فى ظل مستويات الاستهلاك الكهربائى المرتفعة جدًا فى المنطقة، والذى لا يزال يعتمد بالكامل تقريبًا على النفط والغاز. الهدف من إدخال مصادر متجددة هو تقليل الاعتماد المحلى على النفط والغاز فى إنتاج الكهرباء، بما يسمح بتصدير كميات أكبر من هذه الموارد إلى الخارج.

■ فى ضوء التحولات الجيوسياسية الأخيرة، كيف تقيّم الدور المتغير لإسرائيل ضمن النظام الإقليمى، خصوصًا فى سياق اتساع اتفاقيات التطبيع وتعزيز علاقاتها بعدد من الأنظمة العربية؟ وإلى أى مدى يُستَخدم ما يُعرف بـ«التهديد الإيرانى» لإعادة تشكيل التحالفات فى المنطقة؟
- منذ حرب عام ١٩٦٧، شكّلت إسرائيل ركيزة أساسية لقوة الولايات المتحدة فى المنطقة. وقد عبّر ألكسندر هيج، وزير الخارجية الأمريكى فى عهد رونالد ريجان، عن هذا الدور بقوله: «إسرائيل هى أكبر حاملة طائرات أمريكية فى العالم، لا يمكن إغراقها، ولا تحمل جنديًا أمريكيًا واحدًا، وتقع فى منطقة حيوية للأمن القومى الأمريكي». وقد أكد العامان الأخيران هذا الدور بشكل قاطع؛ من تدمير غزة، مرورًا بالحروب ضد لبنان واليمن، وصولًا إلى المواجهات الحالية مع إيران.
من هذا المنطلق، أعتقد أننا بحاجة إلى فهم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فى سياق التراجع النسبى للهيمنة الأمريكية فى المنطقة خلال العقدين الأخيرين. يتجلى هذا التراجع فى تصاعد أدوار قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا، إلى جانب تنافس قوى إقليمية على توسيع نفوذها، مثل إيران وتركيا والسعودية والإمارات. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى التحول فى وجهة صادرات النفط والغاز الخليجية، التى باتت تتجه بشكل متزايد نحو الصين وشرق آسيا بدلًا من الدول الغربية.
أمام هذا التراجع النسبى، أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول اليوم إعادة ترسيخ هيمنتها عبر الدفع بمسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى، لا سيما دول الخليج، تحت المظلة الأمريكية. وفى هذا السياق، يلعب ما يُعرف بـ«التهديد الإيرانى» دورًا كبيرًا. وليس لدىّ شك فى أننا سنشهد اندفاعًا نحو موجة جديدة من التطبيع الإقليمى كجزء من أى تسوية قادمة تتعلق بغزة.

■ فى ظل التحالفات الجديدة والتقارب العربى - الإسرائيلى، كيف ترى مستقبل القضية الفلسطينية؟ هل ستهمش تدريجيًا من الأجندات الإقليمية والدولية، أم أن هناك أشكالًا جديدة من المقاومة قد تعيد رسم مسارها؟
- أعتقد أن العامين الماضيين أظهرا مدى أهمية التضامن الدولى فى دعم القضية الفلسطينية، وفى دعم مقاومة الشعب الفلسطينى. شهدنا موجات هائلة من التظاهرات فى مختلف أنحاء العالم، وشاهدنا الاعتصامات التى أقامها الطلبة فى الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرها، كما رأينا حركات شجاعة حاصرت الموانئ والبنى التحتية فى محاولة لوقف إمدادات الطاقة والسلاح لإسرائيل. وتكمن أهمية هذه التعبئة الجماهيرية فى أنها قوبلت بهجمة شرسة من حكومات يمينية تسعى لإسكات كل أشكال التعبير والدعم لفلسطين، وهو ما يعكس مدى تأثير هذه التحركات.
أما فى المرحلة المقبلة، فأرى أنه من الضرورى، على الصعيدين الإقليمى والدولى، مواجهة أى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل والدول العربية. لا شك أنه ستكون هناك محاولات لفرض مثل هذه الاتفاقات رغمًا عن إرادة الشعب الفلسطينى. وستلعب جهود «إعادة الإعمار» بعد الحرب دورًا كبيرًا فى ذلك. فمن الواضح أن كثيرًا من النقاشات الجارية حاليًا تنظر إلى الإعمار لا بوصفه حقًا إنسانيًا، بل باعتباره وسيلة لتعزيز التطبيع بين الفاعلين الاقتصاديين العرب والإسرائيليين، وبالطبع تحت إشراف أمريكى مباشر.

■ كيف تفسّر المسارات المحتملة للمشروع السياسى الذى يمثله دونالد ترامب، لا سيما فى ظل محاولاته لإعادة تأكيد موقع الولايات المتحدة داخل النظام الرأسمالى العالمى؟ وما الذى تكشفه هذه التوجهات عن مستقبل الهيمنة الأمريكية، وعن التحولات الأوسع التى يشهدها النظام العالمى؟
- منذ أوائل الألفية، بدأنا نشهد بروز مراكز جديدة لتراكم رأس المال خارج نطاق السيطرة الأمريكية التقليدية، وكانت الصين فى طليعة هذا التحول. وقد تزامن صعود الصين مع تراجع نسبى فى هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تجلّى فى تراجع سيطرتها على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والصناعة، وسلاسل الإمداد، والبنى التحتية العالمية. توازى هذا التراجع الخارجى داخليًا مع أزمات هيكلية عميقة داخل المجتمع الأمريكى؛ استقطاب سياسى حاد، وتصاعد العنف، وانخفاض متوسط العمر، وارتفاع معدلات السجن والتشرّد، وأزمات فى الصحة النفسية، وانهيار متزايد فى البنية التحتية الأساسية.
ورغم هذه التغيرات، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بموقع الهيمنة العالمية، فلا تزال قدراتها العسكرية لا تُضاهى، كما تمكنها هيمنتها المالية، القائمة على مركزية الدولار، من استغلال أدوات مثل العقوبات والتحكّم فى الوصول إلى الأسواق والنظام المصرفى العالمى بوصفهم وسائل ضغط فعّالة. تظل هذه القدرة المالية ركيزة مركزية فى بقاء الهيمنة الأمريكية.
ومن ثمّ، يمكن فهم المشروع السياسى لترامب فى هذا السياق؛ إنه محاولة لمواجهة أزمات الرأسمالية الأمريكية والعالمية، ليس عبر حل التناقضات البنيوية، بل من خلال نقل كلفتها إلى أطراف أخرى؛ سواء خصوم جيوسياسيين، أو فئات مهمّشة، أو حتى حلفاء تقليديين. كانت إدارة جو بايدن قد اقترحت حلولًا مختلفة، لكنها واجهت الأزمات ذاتها، وتحدّثت صراحة عن ضرورة تعزيز «المنافسة الاستراتيجية»، والبحث عن سبل للحفاظ على «المزايا الأساسية» للولايات المتحدة فى الصراع الجيوسياسى.
لهذا السبب، من الخطأ اختزال ترامب فى صورة الفوضى أو اللاعقلانية. فالفوضى هنا ليست عرضًا جانبيًا، بل أسلوب حكم. تمتلك إدارته رؤية متماسكة لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية، تستند إلى الحمائية الاقتصادية، والتشدّد العسكرى، واستثمار النفوذ المالى. صحيح أن هذا المشروع يخلق توترات هائلة بين أطراف مختلفة من رأس المال الأمريكى، ومع الحلفاء العالميين، وداخل المجتمع الأمريكى نفسه، لكنه، فى جوهره، يعكس هشاشة النظام الرأسمالى العالمى الراهن، أكثر مما يعكس خصوصية شخصية ترامب بحد ذاتها.
■ نعيش اليوم فى خضم أزمات متنامية؛ اقتصادية وبيئية وسياسية واجتماعية. برأيك، هل تشير هذه الأزمات إلى مرحلة نهائية فى مسار تطوّر النظام الرأسمالى، أم أنها علامات على إعادة هيكلته على نحو أكثر عنفًا؟ وما هى أشكال المقاومة السياسية أو التصورات البديلة التى تراها واعدة، خصوصًا فى الجنوب العالمى؟
- نعيش لحظة خطرة وغير مستقرة إلى حدّ بعيد فى تاريخ العالم، تتسم بتعدد الأزمات وتشابكها فيما بينها. على المستوى الاقتصادى، نشهد تركزًا هائلًا فى الثروة بالتوازى مع تصاعد معدلات الفقر، وارتفاع الديون العامة والخاصة، وتفاقم هشاشة الأوضاع الاجتماعية. أما بيئيًا، فأزمة المناخ أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، مع درجات حرارة قياسية وموجات حر وجفاف وفيضانات باتت جزءًا من المشهد الطبيعى. سياسيًا، تكتسب الأنظمة السلطوية أرضًا جديدة فى بلدان عديدة، غالبًا عبر تعبئة النزعات العنصرية والقومية والخطابات المعادية للمهاجرين لترسيخ سلطتها. لم تعودا الحرب والتهجير القسرى استثناءً، بل أصبحا سِمَتَين بنيويتَين فى هذا النظام العالمى.
كل هذه الأزمات تتغذى من بعضها البعض، وتترك آثارها الأكبر على الفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا فى العالم. ومن وجهة نظرى، فهذه ليست علامات على الانهيار النهائى للرأسمالية، بل على إعادة تشكيلها بصورة عنيفة وغير متكافئة. فالأزمات جزء عضوى من بنية النظام الرأسمالى، وهى لا تحدث بشكل متساوٍ، ونادرًا ما تؤدى إلى سقوطه. على العكس، كثيرًا ما تُستخدم كفرص لإعادة التنظيم، ولبسط سيطرة النخب ودفع تغييرات لم تكن لتحدث لولا لحظة الانهيار.
لهذا، نحتاج إلى بديل مناهض للرأسمالية، يقوم على إعادة توجيه الأولويات لتلبية احتياجات الناس والكوكب، لا مصالح الأقوياء. لا بد من إنهاء الهوس بالنمو والتراكم اللامتناهى الملازمين للرأسمالية، واستبداله بمنظومة تضع العدالة الاجتماعية والبيئية فى قلبها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عدالة اجتماعية واقتصادية على المستوى العالمى.
■ كيف تنظر إلى التغيّرات التى تشهدها البُنى الطبقية فى العالم العربى اليوم؟
- شهدت العقود الأخيرة، وخصوصًا العشرين سنة الماضية، إعادة هيكلة عميقة للبُنى الطبقية فى مختلف أنحاء المنطقة العربية. ويرتبط جزء كبير من هذه التحولات بتبنى سياسات نيوليبرالية دفعت بها مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. فقد أدّت برامج الخصخصة، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك أنظمة الرعاية الاجتماعية، وتحرير التجارة، إلى تعميق الاستقطاب فى توزيع الثروة الذى أشرت إليه سابقًا. وحسب بعض المؤشرات، تُعدّ المنطقة العربية اليوم الأكثر لا مساواة فى العالم، إذ تتجاور أوضاع تشبه المجاعات والنزوح الجماعى والفقر المدقع، مع ثروات خرافية متركّزة بيد شريحة اجتماعية ضئيلة. كشفت إحدى الدراسات الحديثة عن أن ٣١ مليارديرًا فقط فى المنطقة يملكون ثروة تعادل ما تملكه النصف الأفقر من السكان البالغين، وذلك حتى قبل اندلاع الحروب المدمرة خلال العامين الماضيين.
فى مواجهة هذا المشهد، لا بد أن نسأل أنفسنا: من المستفيد من هذه التحولات؟ من الواضح أن بعض النخب الوطنية كانت من أبرز الرابحين من عمليات نقل الثروة الضخمة التى شهدتها المنطقة. لكن ما يجرى لا يقتصر على ذلك فحسب، بل نشهد أيضًا تحولات إقليمية أوسع فى أنماط ملكية الثروة والتحكم بها. وفى هذا السياق، تُشكّل دول الخليج طرفًا محوريًا. فقد كانت الشركات الخليجية، سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، من أكبر المستفيدين من بيع الأصول العامة والانفتاح الاقتصادى فى العقود الماضية. ونتيجة لذلك، أصبح رأس المال الخليجى مدموجًا بعمق داخل البُنى الطبقية ومؤسسات الدولة فى عدد من دول المنطقة.
■ لماذا لا يزال كثير من الإنتاج المعرفى الغربى حول «الشرق الأوسط» أسيرًا لرؤى استشراقية برأيك؟ وكيف نفسّر تبنّى عدد من الباحثين العرب لهذه المنظومات المعرفية التى تنطلق من تاريخ استعمارى وهيمنة فكرية؟
- إنتاج المعرفة ليس عملية محايدة أبدًا، بل هو دومًا متشابك مع بُنى السلطة الاقتصادية والسياسية. وإذا نظرنا تاريخيًا إلى نشأة ما يُعرف بـ«دراسات المناطق» (Area Studies) فى جامعات بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، سنجد أنها نشأت لتلبية احتياجات المشروع الاستعمارى الأوروبى، عبر تطوير أدوات معرفية تمكّن القوى الإمبريالية من إدارة الشعوب الواقعة تحت سيطرتها. ومع صعود الولايات المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، تبنّت الجامعات الأمريكية نفس النهج، وصار «الشرق الأوسط» فى قلب هذا الاهتمام، نظرًا لأهميته الاستراتيجية فى معادلة القوة الأمريكية.
المؤسف أن كثيرًا من الجامعات العربية تُعيد إنتاج هذه المقاربات المعرفية دون مساءلة، لا سيما فى حقول مثل العلوم السياسية والاقتصاد، إذ لا تختلف المناهج المُدرّسة كثيرًا عن النماذج الغربية السائدة.
لكن من المهم أن ندرك أن بُنى إنتاج المعرفة ليست متجانسة بالكامل. فهناك دومًا تيارات فكرية مغايرة وبديلة تظهر من داخل وخارج الجامعة، وتُقدّم نقدًا جذريًا للأطر المهيمنة. وغالبًا ما تنبع هذه التيارات من صلة عضوية بحركات اجتماعية وسياسية خارج أسوار الجامعة، وهى التى تدفع نحو تحوّل أعمق فى أسئلة البحث واتجاهاته. فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، على سبيل المثال، لعب مفكرو حركات التحرر فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربى دورًا محوريًا فى إعادة تشكيل أنماط التفكير عالميًا. ويكفى أن نُشير إلى «نظرية التبعية» (Dependency Theory) التى خرجت من رحم النضالات المناهضة للاستعمار، وقدّمت تفكيكًا حادًا للرؤية السائدة فى اقتصاديات التنمية آنذاك.
وأنا أعتقد أننا نعيش اليوم لحظة مشابهة، إذ تدفعنا الأزمات المتعددة التى تحدثنا عنها إلى إعادة التفكير فى المنظومات المعرفية السائدة، وإلى إنتاج أشكال جديدة من الفهم والنقد للنظام العالمى. وهناك حاجة ملحّة لتوسيع وتعميق هذا المسار، سواء فى المنطقة العربية أو على مستوى العالم.
■ كيف يمكننا فهم دور التكنولوجيا داخل بنية الرأسمالية العالمية اليوم؟
- لطالما كانت التكنولوجيا جزءًا جوهريًا من عمل النظام الرأسمالى؛ وسيلة لإزاحة العمل البشرى، وتسريع عمليات الإنتاج والاستهلاك. غالبًا ما تحصد الشركات التى تتقدم فى مضمار الابتكار التكنولوجى نصيبًا أكبر من الأرباح مقارنةً بمن يتأخر عنها، وبذلك تصبح التكنولوجيا أداة لإعادة توزيع الثروة داخل المجتمعات، وعلى نطاق عالمى أيضًا، بين الشمال والجنوب.
لا تشذ الثورة التكنولوجية الراهنة عن هذا النمط، بل ربما تتسارع بوتيرة غير مسبوقة مقارنة بأى لحظة تاريخية سابقة. ولا يقتصر الأمر على الذكاء الاصطناعى، بل يشمل أيضًا الروبوتات، وأتمتة الصناعة، والتطورات فى مجالات الطب والاتصالات والقطاع المالى. ما يثير القلق أن السيطرة على هذه التكنولوجيا متركّزة بشكل ساحق فى يد الشمال العالمى، وبشكل متزايد فى يد الصين. ولهذا، نعم، هناك خطر حقيقى بأن تعمّق هذه التحولات الفجوة الاجتماعية والاقتصادية عالميًا، وتُكرّس التفاوتات القائمة بين المراكز والأطراف داخل النظام العالمى.