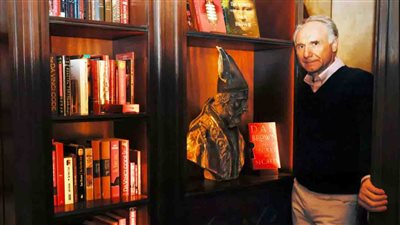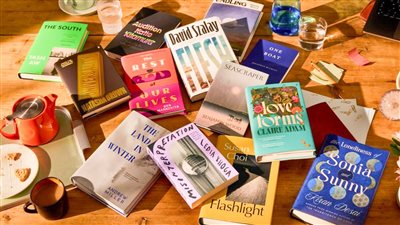حاتم الجوهرى: نحتاج إلى ظهور «نخبة جديدة» تتجاوز شبكات المصالح

- أسعى لبناء سردية جديدة للذات العربية
- الصعود الثقافى يبدأ من تجاوز الانسداد واستعادة المشترك العربى
- غياب الرؤية أفقد القوى الناعمة قدرتها على التجدد والتأثير
- «السياسة الثقافية الثالثة» لحظة وعى جديد بعد استنفاد سرديات الماضى
تتنوع كتابات الباحث والشاعر المصرى حاتم الجوهرى بين البحث الأكاديمى والترجمة والكتابة الأدبية والنقدية، وتتحرك فى فضاءات الدراسات الثقافية والحضارية، والتراث الثقافى غير المادى، والعلاقات الجيوثقافية، والاستشراق الجديد، وغيرها من الحقول التى تسعى إلى قراءة الذات العربية فى علاقتها بالعالم.
نال الجوهرى جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية عام 2016، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى التى تعكس تنوع اهتماماته واتساع مشروعه. وقد صدرت له ثلاثة كتب تشكل معًا مشروعًا لفهم الذات العربية وعلاقتها بالآخر، وهى: «الدبلوماسية الثقافية البديلة»، و«مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة»، و«السياسة الثقافية الثالثة»، وهو كتابه الأحدث.
فى هذا الحوار، يشرح الجوهرى ملامح هذا المشروع، ويقدّم تصوّره لما يسميه بـ«المثقف الجامع» و«الصعود الثقافى» بوصفه طريقًا جديدًا للذات العربية فى عالم يعيد تشكيل خرائطه الفكرية والحضارية.

■ قلت إن كتاب «السياسة الثقافية الثالثة» يقع ضمن ثلاثية بدأت بـ«الدبلوماسية الثقافية البديلة» و«مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة».. فما ملامح هذا المشروع مكتملًا؟
- بداية؛ «الدبلوماسية الثقافية» كانت نطاقًا طوره الغرب واستحدثه لترويج وتلميع صورته السيئة فى مرحلة ما بعد الاستعمار وفظائعها، وارتبط معظم الحضور العربى فيه بتصورات إجرائية ونمطية. وفى كتاب «الدبلوماسية الثقافية البديلة» هدفت إلى تقديم إطار نظرى وتطبيقى لهذا المجال يقوم على كسر الحضور العربى النمطى به، وتحويله إلى مشروع مبادر يرتبط بذات عربية تمنح قيمها الثقافية الخاصة المكانة نفسها للقيم الغربية فى عملية التبادل الثقافى البينى والعالمى، بعيدًا عن تصورات المركزية الأوروبية ومتلازماتها الثقافية القديمة، أو الجديدة فى القرن الحادى والعشرين.
أما مجال «الدراسات الثقافية» وتطبيقه عربيًا فكان يرتبط بفلسفته الغربية حيث نشأ فى بريطانيا، التى كانت تقوم على الانتصار للهوامش والترويج للتصورات الفرعية ليأس الأكاديميين الغربيين من إصلاح المتون أو السرديات الكبرى المهيمنة على الغرب، فطرحت فى كتاب «مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة» فلسفة جديدة لمجال «الدراسات الثقافية» ترتبط بالذات العربية وظرفها الخاص، باستخدام منهج الدرس الثقافى لصالح استعادة متن عربى يقوم على «المشترك الثقافى» العربى، بما يمكن أن يستعيد المتون فى مواجهة فلسفة التفكيك وتفحير التناقضات.
بينما كتاب «السياسة الثقافية الثالثة» جاء واضحًا فى فرضيته أن مصر فى العهد الجمهورى شهدت سياستين ثقافيتين، حملت كل منهما تصورًا للجدل مع الآخر، الأولى مع ثروت عكاشة فى العهد الناصرى وارتبطت بحالة «التحرر من الآخر» فى مرحلة ما بعد الاستعمار، والثانية تبلورت مع فاروق حسنى فى عهد الرئيس مبارك وارتبطت بحالة «السلام مع الآخر» والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا بعد توقيع اتفاقية السلام فى كامب ديفيد، ليقدم الكتاب طرحه الأساسى بضرورة ظهور سياسة ثقافية ثالثة جديدة تواكب اللحظة الراهنة بعد استنفاد السياستين السابقتين لدورهما التاريخى، وعجز المقاربات أو السرديات الثقافية القائمة وإرثها عن التصدى للمتغيرات الكثيرة فى المشهدين الإقليمى والدولى.
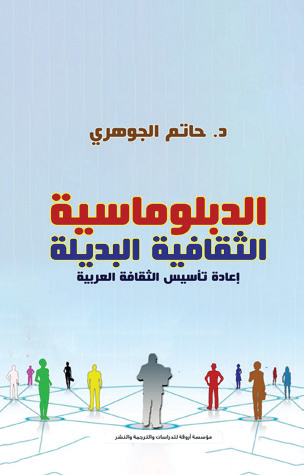
■ كيف تتكامل هذه الكتب الثلاثة فى رسم خريطة فكرية جديدة للدور الثقافى العربى فى العالم؟
- العلاقة بين الكتب الثلاثة تنتظم خلف سياسة ثقافية ترتبط بمشروع لسردية كبرى جديدة لمصر والعرب، تسعى للتاكيد على وجودها فى مواجهة المتغيرات الإقليمية المتنافسة معها «المركزية الإفريقية السوداء من إثيوبيا، العثمانية الجديدة من تركيا، التمدد الشيعى من إيران، الهيمنة الصهيونية مع الاتفاقيات الإبراهيمية»، وفى مواجهة ظهور سرديات عالمية جديدة هى: «سردية الصدام الحضارى من أمريكا والغرب، وسردية الأوراسية الجديدة من روسيا، وسردية الحزام والطريق من الصين».
يمكن القول إن «السياسة الثقافية الثالثة» هى مسار للتطبيق على المستوى المؤسسى الرسمى للدول وضمن حزمة سياساتها العامة. و«الدبلوماسية الثقافية البديلة» هى مسار للتطبيق على المستوى المؤسسى الرسمى ويصلح للمستوى الأهلى كذلك. و«مدرسة الدراسات الثقافية العربية المقارنة» هى منهج علمى ومجال أكاديمى وبحثى جديد يصلح للتطبيق فى الجامعات ومراكز الأبحاث العربية، والترويج لفلسفة جديدة إزاء الموروث الثقافى العربى المشترك وإعادة توظيفه ليكون لبنة فى طريق اللُحمة العربية وليس تفجير التناقضات.
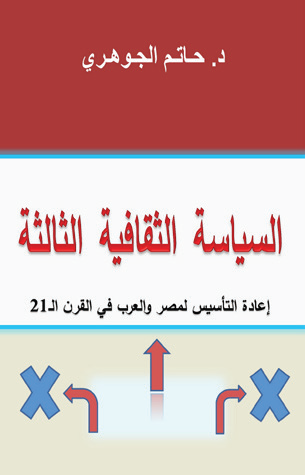
■ عندما تكتب عن «تجديد القوى الناعمة العربية»، هل تتحدث عن مشروع فكرى بالأساس، أم عن خطة ثقافية قابلة للتطبيق المؤسسى؟ وما هى الآليات التى تراها لضمان تحققها؟
- أتحدث عن مشروع فكرى له تصورات تنفيذية وتطبيقية، وليس مجرد إجراءات تنفيذية لخطة ثقافية ما، المشروع الفكرى وسرديته التى ينطلق منها هو تصور جديد للعلاقة بين الذات والآخر، تتجاوز الانسداد والاستقطابات التى وصلت لها سرديات الذات العربية يمينًا ويسارًا فى القرن العشرين الذى كان قرن الأيديولوجيا والجيوسياسى بالأساس، بينما أقدم تصورًا يقوم على الجغرافيا الثقافية والجيوثقافى فى مواجهة مشاريع الآخر الإقليمى والدولى.
الثقافة هى المكون الأكثر فاعلية عندما تنسد التمثلات السياسية، وأزمة الذات العربية تتلخص فى عجز مشاريعها وسردياتها التاريخية عن الحضور فى الجغرافيا الخاصة بها وانسحابها منها لصالح الآخر. ولاستعادة الذات العربية وحضورها يجب علينا أن نعيد تأسيس الجغرافيا الثقافية، أو أن نؤكد على أهمية بسط سردية ثقافية فاعلة على الجغرافيا العربية التى ضربتها التناقضات. دون وجود لقوى ناعمة وسرديات ثقافية متماسكة لن تقدر القوى الصلبة مهما تضخمت على القيام بأدوار مؤثرة، لا بد من لُحمة ما، وتوازن وتكامل بين القوى الناعمة وسردياتها والقوى الصلبة وحضورها.
وهذا المشروع لتجديد القوى الناعمة العربية له شقان؛ شق يقوم على تطوير جهد فكرى ونظرى للسير فى هذا الطريق الجديد، وتجهيز مستلزماته من قِبل الباحثين والمفكرين الذين أجتهد لأكون منهم، وشق تطبيقى سيقع عاتقه على المؤسسات الخاصة بالدول حينما تلتفت للبحث عن مشروع ثقافى جديد، وتسعى لتجاوز التناقضات القائمة وحالة الجمود.
■ برأيك، ما الذى فقدته القوى الناعمة المصرية والعربية فى العقود الأخيرة؟ هل المشكلة فى ضعف الإنتاج الثقافى نفسه، أم فى غياب الرؤية التى تجمع وتوجّه هذا الإنتاج؟
- غياب الرؤية؛ فالذى فقدته القوى الناعمة فى العقود الأخيرة هو القدرة على التجدد والتخارج من إرث الانسداد وسردياته الأيديولوجية والفكرية والمؤسساتية والثقافية، مع الترويج المفرط والفائق فى السياسة الثقافية الثانية، التى ظهرت فى التسعينيات ولا تزال تسود المشهد لحد كبير، لأفكار ما بعد الحداثة ونهاية السرديات الكبرى والخضوع لكثير من مسارات الدبلوماسية الثقافية الغربية المنتشرة فى المنطقة، والتى تروج لتفجير التناقضات وفلسفة الهوامش وتفكيك الذات العربية بوصفها هوية مختارة طوعًا، إلى هويات فرعية متناحرة ومتصارعة يسهل السيطرة عليها وإعادة هندستها لتخدم سرديات الآخر الثقافية ومشروعه للهيمنة.. وهو ما سعيت لتجاوزه فى طرحى لمشروع السياسة الثقافية الثالثة.
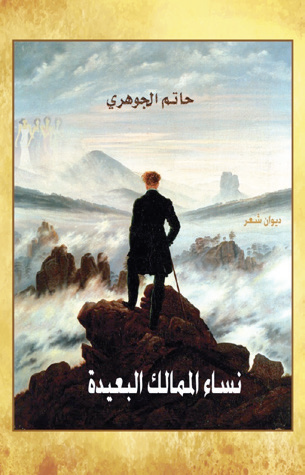
■ تحدثت عن أن السياسة الثقافية الثالثة تُعرف بسياسة التمايز والصعود الثقافى تجاه الذات والآخر، بالاستناد إلى طبيعة الهوية المصرية والتصالح مع الآخر. كيف يمكن أن يتحقق هذا «التمايز» فى الزمن الراهن؟ وما الأدوات التى تراها ضرورية لتحقيق هذا التوازن؟
- دعينى أبسط لكِ الإشكالية العالمية التى تشغل البشرية مع صعود الحضارة الأوروبية منذ قرنين تقريبًا؛ أوروبا والغرب- يسارًا ويمينًا- قدمت تصورًا لفكرة «الحضارة المطلقة» الشمولية التى تَجُبُّ جميع الحضارات، وعلى الجميع أن ينتظم فى طورها ومساراتها، بدأت الفكرة مع هيجل المثالى المسيحى الأب التاريخى للرأسمالية المسيحية المثالية، ثم تمرد عليه تلميذه ماركس واستحضر النزاع القديم بين المادية والمثالية اليونانية؛ وطور فكرة الشيوعية العلمانية المادية، وكل منهما تدعى فى تطبيقاتها أنها ذرورة الحضارة ونهاية التاريخ وشكله النهائى.
فى مواجهة هذا الطرح الغربى المتطرف حضاريًا القائم على الصراع مع الآخر وفرض الهيمنة عليه. أقترح فى السياسة الثقافية الثالثة «للتمايز والصعود الثقافى» الاستناد لنمط حضارى آخر تجاهلته المركزية الأوروبية؛ وهو حضارات الموجة الأولى التى تنتمى إليها مصر، والذى يقوم على أن بلدانًا معينة توافرت لها التضاريس الحامية من الجبال والبحار، وتوافرت لها الموارد الطبيعية والمياه، بما جعلها متصالحة مع نفسها مكتفية بمواردها دون عدوان على الآخر أو طمع فى الهيمنة عليه، هذه باختصار فكرتى عن التمايز المصرى والإلهام العربى الممكن للعالم، من خلال التصالح مع الذات والآخر، الذى يخالف المسألة الأوروبية وحضاراتها التى قامت على التنميط ومحاولة فرض قالب حضارى/ اقتصادى/ ثقافى واحد تهيمن به على البشرية، سواء باسم الأيديولوجيا الماركسية أو باسم التعالى العنصرى المسيحى الخاص بالرجل الأبيض قديمًا، أو حديثًا مع مشروع الصدام الحضارى الذى تؤمن به أمريكا حاليًا، ومشروع روسيا فى إعادة إنتاج المركزية الأوروبية فى شكل ثقافى الذى تسميه «الأوراسية الجديدة»، أو مع الشيوعية الصينية الكامنة عميقًا خلف مبادرة «الحزام والطريق».

■ كيف يمكن أن يتحقق «الصعود الثقافى» فى واقع عربى يعانى من تراجع الثقة بالذات ومن انقسام فى المرجعيات الفكرية والسياسية؟
- عن طريق ظهور بدائل تتجاوز الانسداد وتَحَصُّنْ كل جماعة سياسية أو فكرية تاريخية فى جزيرة منعزلة، الصعود الثقافى يأتى ضمن سردية محتملة لتوظيف الثقافة باعتبارها المكون الأكثر عمقًا عند الذات البشرية، من ثمّ هدفها تجاوز فشل السرديات السياسية إرث القرن العشرين، وطرح مشروع جديد ينتج فيما بعد تصورات سياسية وفكرية، وهذه هى المشكلة التى طرحتها فى منهجى العلمى بالكتاب للوصول لمشروع السياسة الثقافية الثالثة، أى انسداد السرديات والمقاربات الثقافية الراهنة، والفرضية القائمة على أن محور السياسة الثقافية الأولى والثانية «وقبلهما مع الطهطاوى ومع طه حسين» هو فكرة للجدل بين الذات والآخر، من ثم أوصلنى المنطق العقلى للنمط الثقافى البديل وهو «التمايز والصعود» الثقافى، تمايز الذات من خلال استعادتها لخصوصيتها الحضارية القائمة على التصالح مع الذات ومع الآخر، وتجاوز وهم التبعية ومركزية الأنماط الفكرية والحضارية الغربية، والصعود من خلال طرح مشروع جيوثقافى مشترك للذات العربية يمكن للآخر الإقليمى والدولى أن يعمل له حسابًا، ويتراجع عن مشاريعه للهيمنة والتمدد على حسابها.

■ تحدثت عن «المثقف الجديد» الذى سيحمل مشروع السياسة الثقافية الثالثة إلى أرض الواقع، وتطلق عليه اسم «مثقف الكتلة الجامعة». من هو هذا المثقف فى تصورك؟ وما وجه اختلافه عن المثقف فى أزمنة سابقة؟
- أنتجت المسألة الأوروبية ومتلازماتها الثقافية عدة تصورات للمثقف وتبعتها الذات العربية فى أزمنة سابقة، دون مبادرة أو نظر لسياقها الخاص، فى مرحلة الحداثة والعقل الأوروبى ومركزيته قدم الغرب مفاهيم مثل «المثقف العضوى» أو الطبقى عند جرامشى، و«المثقف الملتزم» الوجودى عند سارتر، وفى مرحلة ما بعد الحداثة قدم مفاهيم مثل مثقف «السرديات الصغيرة» و«المثقف الرمزى» و«المثقف المحدود»، كلها تصورات نظرية لمفهوم المثقف تتفق مع السياق الغربى والصراع حول فكرة الحضارة المطلقة أو التمرد المطلق عليها.
بينما أقدم تصورًا بديلًا فى كتابى تحت اسم «مثقف الكتلة الجامعة»، معتبرًا أن هناك لكل جماعة إنسانية «مستودع هوية» مشتركًا وجامعًا، وأن هناك مجموعة من الأفراد يدافعون بفطرتهم عن ثوابت «مستودع الهوية» هذا، متجاوزين تصنيفات ومتلازمات المسألة الأوروبية يمينًا ويسارًا المثالية والمادية، من ثمّ هذه المجموعة التى تقوم على الدفاع عن «المشترك الثقافى» للذات العربية أرى أنهم يصلحون لتكوين نخبة جديدة و«كتلة جامعة» حرجة وفاعلة تقود المجتمع العربى للمستقبل، وتحرر الإنسانية من وهم الحضارة المطلقة والمسألة الأوروبية.
■ هل ترى أن الظروف الراهنة فى مصر والعالم العربى تسمح بظهور هذا المثقف الجامع؟ أم أن السياق الحالى ما زال ينتج أنماطًا فردية أكثر من إنتاجه لمشروعات فكرية جماعية؟
- السياق الحالى يصلح شرط الوعى بذلك واعتماد سياسة عامة أو حزمة سياسات عامة جديدة فى الدولة ومؤسساتها؛ تعيد الثقافة لمكانتها وتغير قواعد الفرز والاستقطاب وتنتقى الأفراد التى تعبر عن «المشترك الثقافى» الجامع فى مستودع الهوية، الأنماط الفردية والعزلة أو الإحباط أو التمترس حول الماضى أو الصراعات الصفرية كلها بسبب غياب البديل الممكن، وهذا البديل الجامع هو ما سعيت لطرحه فى كتابى عن السياسة الثقافية الثالثة.
■ كيف تقرأ المشهد الثقافى فى مصر اليوم فى ضوء مشروعك؟ وما الذى يحتاجه برأيك ليستعيد فاعليته؟
- يحتاج لتجاوز تناقضات الماضى وتجاوز الاستقطابات الصفرية وتمترس كل فصيل حول تاريخه الخاص وشبكة المصالح المرتبطة به، وظهور نخبة جديدة تصنع «مشتركًا ثقافيًا» عامًا ممكنًا جديدًا للبلاد يصلح للإلهام المجتمعى، وهذا هو لب مفهوم القوى الناعمة الطوعية، أن يكون لديك نمط إنسانى أو حضارى له جاذبية طوعية عند الآخرين بشكل ناعم وبمحض إرادتهم، ودون استخدام للإكراه أو للقوة الخشنة.
■ فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم، من صراعات الهويات إلى الثورة الرقمية، هل ترى «السياسة الثقافية الثالثة» مشروعًا عربيًا محليًا بالأساس، أم محاولة لصياغة رؤية إنسانية أوسع يمكن أن تسهم فى إعادة التوازن إلى الثقافة العالمية؟
- ينقسم العالم الآن إلى معسكرين يعيدان إنتاج المسألة الأوروبية القديمة ومركزيتها على أسس ثقافية، ما بين روسيا «الأوراسية الجديدة» والصين مع مبادرة «الحزام والطريق»، وبين أمريكا ونظرية الصدام الحضارى. يمكن للسياسة الثقافية الثالثة فى مستوى من مستويات عملها أن تقدم كتلة جيوثقافية ثالثة، تحرر العالم من وهم الحضارة المطلقة وتمثُّلاتها القديمة فى القرن العشرين أو الجديدة فى القرن الحادى والعشرين.
يمكن للوعى بطريق جديد أن يغير العالم ويحرره من خرافة النماذج المطلقة والحضارة النهائية التى تصلح لكل زمان ومكان، ويمكن أن نستعيد التعدد والتنوع الثقافى الحقيقى، بعيدًا عن الحضارة الغربية المتطرفة ووهمها عن المركزية والهيمنة المطلقة الأبدية.
■ كيف يمكن للثقافة أن تستعيد قدرتها على أن تكون أداة نهوض حقيقية؟
- من خلال رد الثقافة لأصلها باعتبارها واحدة من السياسات العامة مثلها مثل السياسة الخارجية أو السياسة الاقتصادية أو السياسة التعليمية، وتجاوز مرحلة الاستقطاب بين السياسة الثقافية الأولى عن التحرر من الآخر والسياسة الثانية عن التصالح معه، والاعتراف بأننا فى مرحلة تاريخية جديدة فى القرن الحادى والعشرين تتطلب تصورًا جديدًا تجاه الذات والآخر، وتحديدًا تجاوز التمثُّلات السياسية والأيديولوجية التى انسدت، والوعى بأن الحاضنة الثقافية ومكوناتها قادرة على الصعود لتقدم دافعًا جديدًا ينتج تمثُّلات سياسية جديدة، وتتجاوز خرافة القرن العشرين بأن لدينا تصورات سياسية وأيديولوجية مطلقة صالحة لكل مكان وزمان. هنا يمكن للثقافة بوصفها سياسة عامة تتبناها الدولة أن تخلق حالة مشتركة يجتمع عليها الناس، وتصبح أساسًا لظهور سردية جديدة لمصر والذات العربية.