سلمان رشدى: العالم الآن متصدع.. والمجتمعات تعانى انقسامات عميقة

- الأفلام التى شكّلت وعيى صُنعت بميزانيات منخفضة ولو استطعت أن أصنع فيلمًا مثل «منقطع النفس» لجودار سأموت سعيدًا
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نجاته من محاولة اغتيال أفقدته البصر فى عينه اليمنى، عاد الروائى الهندى البريطانى سلمان رشدى إلى كتابة الأدب، وهو ما لم يكن سهلًا بالنسبة إليه. فبعد أن تعرّض للطعن خمس عشرة مرة خلال فعالية أدبية فى مؤسسة تشوتاكوا بجنوب غرب نيويورك فى أغسطس 2022، لم يكن مستعدًا نفسيًا لكتابة الرواية. ورغم أن الضرر الذى أصاب كبده قد تعافى فى النهاية، فإن إصابات الأربطة الشديدة فى يده اليسرى لم تشفَ بعد.
كان مهاجمه، هادى مطر، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، وعرّف نفسه فى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى بأنه متطرف إسلامى، قد اندفع نحو المنصة وهاجمه بعنف. وجاء هذا الاعتداء الوحشى بعد 33 عامًا من إصدار الحكومة الإيرانية فتوى دعت إلى قتل سلمان رشدى عقب صدور روايته «آيات شيطانية» عام 1988 التى اعتُبرت مهينة لنبى الإسلام؛ محمد. وقد حُكم على مطر، الذى يبلغ الآن 27 عامًا، فى مايو الماضى بالسجن 25 عامًا.
وخلال فترة تعافيه الطويلة، كتب رشدى سردًا لتفاصيل الحادث وما تلاه، فى كتابه «سكين.. تأملات بعد محاولة قتل»، الذى نُشر فى أبريل 2024. بعد فترة قصيرة، بدأ العمل على مجموعته القصصية الجديدة «الساعة الحادية عشرة: خماسية قصصية»، وهى أول عمل أدبى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
قال رشدى: «حين أنهيت كتابة المذكرات، كان من المستحيل أن أفكر فى الرواية. كأن باب الخيال قد أُغلق»، ثم حدث أمر غريب تقريبًا فور انتهائى من «سكين»، كأن هذا الباب فى رأسى فُتح من جديد، وكأننى أُذن لى بالعودة إلى عالم الأدب، وكان ذلك شعورًا مبهجًا.
أنجز رشدى قصتين من مجموعته الصادرة منذ أيام قبل حادثة الاعتداء، وهما «فى الجنوب»، و«الشيخ فى الساحة». لكنّ القصص الخمس جميعها تشترك فى انشغالها بقضايا العمر، والفناء، والذاكرة، وهو أمر يُمكن تفهمه بالنسبة لكاتب سيبلغ التاسعة والسبعين من عمره العام المقبل، ونجا من هجومٍ بالكاد ظلّ فيه على قيد الحياة، حتى إن الأطباء الذين سارعوا لمساعدته لم يتمكّنوا فى البداية من العثور على نبضٍ له.
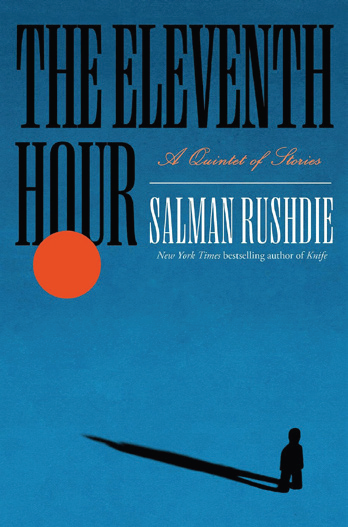
تستمد قصة «الساعة الحادية عشرة» عناصرها من ماضى رشدى، مثل سنوات دراسته فى جامعة كامبريدج، ومن مصادر مفاجئة وغامضة. أما الشخصية الرئيسة فى قصة «الشيخ فى الساحة»، ذلك الرجل المسن الذى يُعامَل بوصفه حكيمًا، فقد استلهمها رشدى من مشهد فى الفيلم الأصلى «النمر الوردى»، يظهر فيه عابر طريق عجوز ينظر بهدوء، بينما تدور حوله مطاردةٌ بالسيارات فى جنون. أما الرواية القصيرة «أوكلاهوما»، فقد استوحاها من معرضٍ ضم أوراق فرانز كافكا، وكان من بينها مخطوط روايته غير المكتملة «أمريكا»، التى تتناول رحلة مهاجرٍ أوروبى فى الولايات المتحدة، وهى البلاد التى لم يزرها كافكا قط.
فى قصة «متأخر» كان رشدى يتوقع أن يكتب سردًا بسيطًا عن العلاقة بين طالب وأستاذه فى كامبريدج، شخصية مهيبة مستوحاة من الكاتب إدوارد فورستر، ومن مفكك الشفرات فى الحرب العالمية الثانية آلان تورينج. غير أن جملةً غامضة، لا يتذكّر رشدى أنه كتبها أصلًا، دفعت القصة نحو عالمٍ خارق للطبيعة.
يقول رشدى: «كنت أتصور فى البداية أننى سأكتب عن صداقةٍ، صداقة غير محتملة، بين الطالب الشاب والرجل الكبير الجليل. ثم جلست لأكتب، فوجدت على حاسوبى هذه الجملة: «حين استيقظ ذلك الصباح، كان ميتًا»، فقلت لنفسى: ما هذا؟ لم أكن أعرف من أين جاءت، وتركتها على اللابتوب لمدة 24 ساعة. ثم عدت إليها وقلت: كما يبدو، لم يسبق لى أن كتبت قصة أشباح، فلِمَ لا؟
فى هذا الحوار، المنشور على موقع San Francisco Chronicle، يتحدث سلمان رشدى عن أجواء مجموعته القصصية الجديدة التى تتأمل فى الشيخوخة والذاكرة والموت، وعن الكيفية التى تحولت بها الكتابة بعد نجاته من محاولة اغتيال كادت تودى بحياته إلى فعلٍ تأملىٍّ.
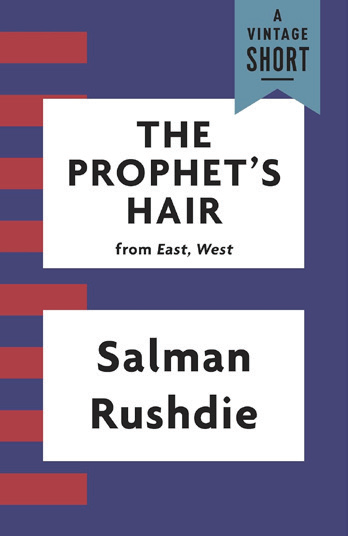
■ بعد أن فُتح الباب لك كما قلت، وتمكّنت من العودة إلى كتابة الرواية، ما أول قصة كتبتها؟
- القصة التى تتحدث عن الأشباح، بعنوان «متأخر». كان لدى منذ زمن اهتمام بكتابة عملٍ ينطلق من سنواتى فى جامعة كامبريدج، التى كانت بالنسبة إلىّ سنوات سعيدة. قضيت هناك وقتًا رائعًا، بين عامى ١٩٦٥ و١٩٦٨، وهى الفترة التى يمكن اعتبارها المركز التاريخى لثقافة الجنس والمخدرات والروك أند رول.
ومن حسن حظى خلال تلك المرحلة أننى التقيت إى. إم. فورستر، مؤلف رواية «رحلة إلى الهند»، تلك الرواية العظيمة. كنت فى التاسعة عشرة تقريبًا، بينما كان هو يقترب من التسعين، لكنه كان لطيفًا جدًا.
كان يجلس فى حانة الطلاب يشرب كأسًا صغيرًا من مشروب ما، وكان منفتحًا على استقبال الطلبة الذين يأتون للحديث معه. وفى أحد الأيام استجمعت شجاعتى واقتربت منه. وعندما علم أننى من أصل هندى، أصبح أكثر وُدًّا، لأن الهند كانت ذات أهمية كبيرة فى حياته. وهكذا تعرّفت عليه.
كما تذكّرت شخصية عظيمة أخرى من كلية كينجز، جاءت بعد زمنه وقبل زمنى، هو آلان تورينج، محلّل الشفرات الذى شارك فى الحرب العالمية الثانية فى فكّ شفرات النازيين. وقد تعرّض فورستر وتورينج كلاهما لمعاملة قاسية بسبب ميولهما الجنسية، التى كانت تُعد جريمة فى إنجلترا آنذاك، وتحمّلا معاناة شديدة بسبب ذلك.
ففكّرت أن أدمج هاتين الشخصيتين فى شخصية واحدة، وأكتب عن رجلٍ تضرّر نفسيًا لأنه لم يستطع أن يكون صريحًا بشأن حقيقته الداخلية. لم أكن أعرف أن القصة ستكون عن الأشباح. كنت أظنها قصة عن طالبة شابة ورجلٍ مسنّ تجمع بينهما صداقة غير متوقعة. لكن عندما جلست لكتابتها، كانت أول جملة ظهرت على شاشة اللاب توب تقول: حين استيقظ ذلك الصباح، كان ميتًا. فقلت لنفسى: من أين جاءت هذه الجملة؟، ثم فكّرت: حسنًا، إذًا هى قصة أشباح. بعدها تذكّرت الشخصية الثالثة العظيمة من كينغز، من زمن أسبق، وهو إم. آر. جيمس، سيّد قصص الأشباح الكلاسيكية. وهكذا تجمّعت كل هذه الخيوط معًا لتتكوّن القصة التى كتبتها.

■ كان يمكن تسمية هذا الكتاب «تأملات غريبة الأطوار حول الموت». تتناول كل قصة من القصص الخمس الموت بطريقة ما، ومع ذلك وجدت نفسى أضحك طوال الوقت. يكاد الرجلان العجوزان المتشاجران فى القصة الأولى «فى الجنوب «يشبهان أسلوب نيل سيمون، وكأنهما مأخوذان مباشرة من مسرحيتى «الثنائى الغريب، أو «أولاد الشمس».
- أردتُ أن يكون الكتاب مليئًا بروح الفكاهة، أن يحمل روح اللعب والبهجة فى الطريقة التى يتعامل بها مع هذه الموضوعات الضخمة. أما قصة «فى الجنوب»، فقد وُلدت بعد رحلة لى إلى جنوب الهند، إلى المدينة التى ما زلت أسمّيها مدراس، رغم أن اسمها الرسمى الآن تشيناى. هناك التقيت رجلًا مسنًا كان قريبًا من أحد أصدقائى، رجلًا محبّبًا رغم طباعه المتذمّرة الحادة. كان غاضبًا على الدوام، لكن بطريقة تجعل صحبته ممتعة للغاية.
أحببت وجودى معه، رغم أن كل ما كان يقوله يدور حول بؤسه لكونه لا يزال حيًا ويأسه من كل شيء.
لذا، ما فعلته ببساطة هو أننى قسمته إلى نصفين؛ حوّلته إلى شخصين لا يستطيعان الاتفاق على أى شىء. تخيّل لو أنه التقى نفسه، لما وجد ما يفعله سوى الجدال والخلاف. لكن، تحت سطح الجدل والخلاف، كانت هناك محبة.

■ كل معجبيك يعرفون أنك عاشق للسينما. ولو أن أحد القرّاء دوَّن عناوين الأفلام التى تذكرها فى هذا الكتاب، مثل «أغنية الطريق» لـ ساتياجيت راى، و«حكايات القمر الغامض» لـ كينجى ميزوغوتشى، و«ألفافيل» لـ جان-لوك جودار فسيحصل على قائمة أفلام مختارة بعناية فائقة. نعلم أن الكاتب نورمان ميلر أخرج فيلمًا ذات مرة، فهل فكّرت أنت فى الإخراج يومًا؟
- لا. فى مرحلة من شبابى كنت أرغب بشدة فى أن أصبح ممثلًا. قضيت معظم وقتى فى جامعة كامبريدج منخرطًا فى مجموعات التمثيل المسرحى. ولحسن الحظ، كانت لدى درجة من الوعى الذاتى جعلتنى أقول لنفسى: أنت لست جيدًا بما يكفى لفعل هذا، وربما عليك أن تختار الخيار الآخر، وهو الكتابة.
لقد كتبت فيلمًا واحدًا فقط، عندما تحولت روايتى «أطفال منتصف الليل» إلى فيلم، أخرجته المخرجة الهندية الكندية ديبا ميهتا. والحقيقة القاسية عن صناعة السينما هى أنها كلها تدور حول المال. كانت الطريقة الوحيدة التى تمكنا بها من الحصول على التمويل لصنع الفيلم أن أوافق على كتابة السيناريو بنفسى. وهكذا فعلت، وكانت تجربة جيدة فى الواقع، لأن ديبا وأنا كنا صديقين مقربين، وتمكّنا من إنجاز الفيلم دون أن نتشاجر.
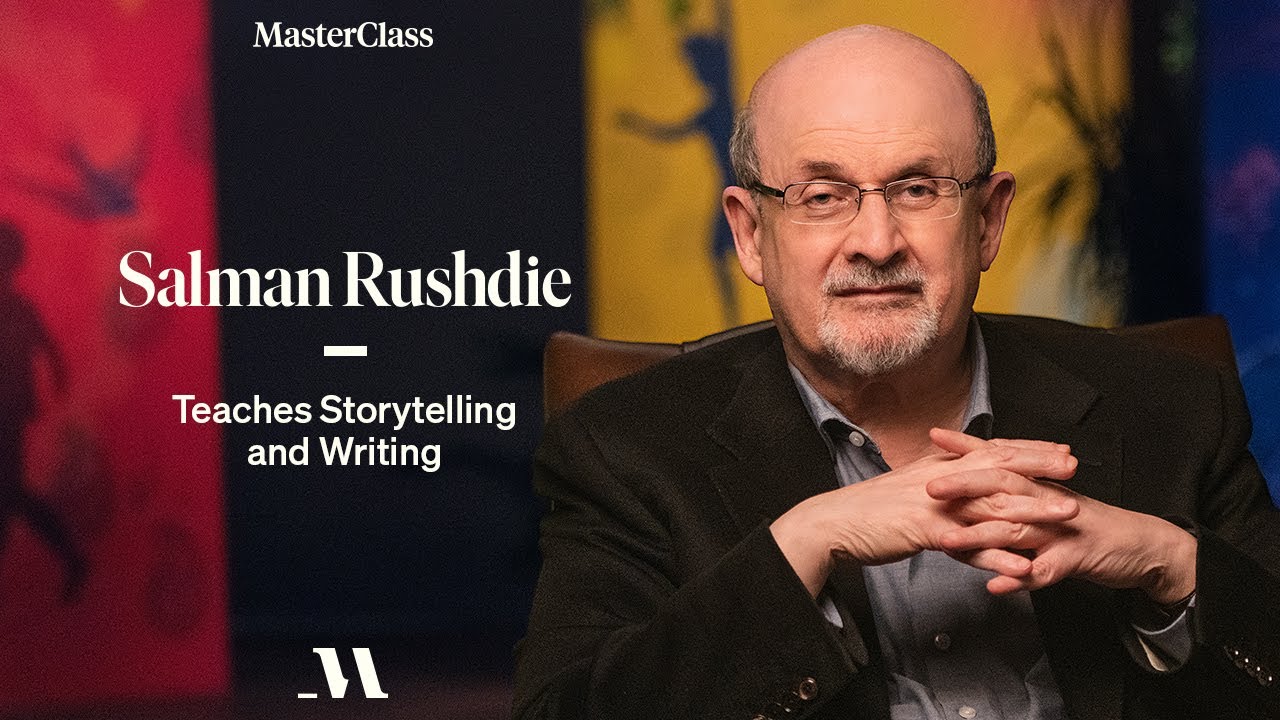
■ وماذا لو لم يكن الأمر متعلقًا بالمال؟ ماذا لو أن هوليوود منحتك ٥٠ مليون دولار وقالت لك: اصنع الفيلم الذى تريده؟
- كنت سأُعيد ٤٠ مليونًا منها. الأفلام التى شكّلت وعيى هى موجة السينما الفرنسية الجديدة والموجة الإيطالية الجديدة، وهى أفلام صُنعت بميزانيات منخفضة. لو استطعت أن أصنع فيلم «منقطع النفس» لجان لوك جودار، سأموت سعيدًا. أما الفيلم الآخر الذى كنت أتمنى أن أكون أنا من صنعه، فهو «الفهد» للمخرج لوتشينو فيسكونتى.
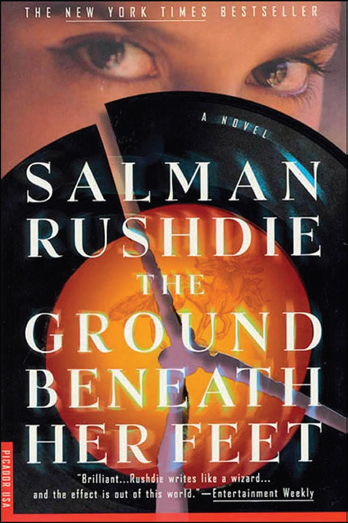
■ فى قصة «أوكلاهوما»، وهى القصة الرابعة فى مجموعة «الساعة الحادية عشرة»، كتبت: أمريكا تاهت داخل قصتها الخاصة. ماذا كنت تعنى بذلك؟
- بطريقة ما، فقدت أمريكا إحساسها بماهيتها الجماعية. كان هناك وقت يتفق فيه الأمريكيون بوجهٍ عام على معنى أن تكون أمريكيًا، تمامًا كما حين تذهب إلى فرنسا، تجد أن الفرنسيين يملكون وعيًا قويًا بما يعنيه أن تكون فرنسيًا. قد يختلفون سياسيًا إلى أقصى حد، لكنهم يعرفون تمامًا ما تعنيه الفرنسية بالنسبة لهم، ويعرفون من هم.
عندما جئت لأعيش هنا قبل ٢٦ عامًا، كنت أعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على أمريكا.
بغضّ النظر عن السياسة؛ يمين أو يسار، لم يكن ذلك مهمًا، كان لدى الناس شعور واضح بهويتهم. أما الآن، فأعتقد أننا لم نعد نعرف ما الذى يعنيه ذلك. وهذا أمر محزن وخطير فى الوقت نفسه، لأن المجتمع حين ينقسم انقسامًا عميقًا، يصبح الأمر خطرًا.
وهذا الانقسام ليس حكرًا على الولايات المتحدة. أفكّر فى البلدان التى قضيت حياتى أكتب عنها وأتأملها، وجميعها تظهر بصور مختلفة داخل هذا الكتاب، وأرى أن هذا النوع من التصدّع يحدث فيها أيضًا. يحدث فى إنجلترا، وفى الهند كذلك.
لقد أصبح هذا هو العالم الآن؛ عالمًا متشظيًا. والسؤال الذى طرحتُه على نفسى هو: كيف يمكن للفنان أن يستجيب لذلك؟








